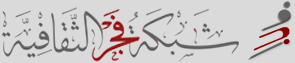علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (6)

ز- اللطف الإلهي كمصدر للفهم الصدرائي
تنطوي العملية التأويلية عند الفيلسوف الإلهي صدر الدين الشيرازي على أهمية معرفية خاصة لجمعها المنهجي بين البرهان والقرآن والعرفان، حيث يأخذ التأويل تبعاً لهذا الجمع معنى الكشف عن مراتب المعنى وبواطنه[1].
ولكي لا يشتبه الحال على المأخوذ بتعبير الباطن، يرفض صدرا بشدة مصطلح التأويل المشبه بالباطنية، ويؤكد على التفسير بما له من المعنى الشامل للتأويل، ووفق طريقة الراسخين في العلم الذين خصهم الله تعالى بالتأويل. وهذه طريقة تحفظ الظاهر بقدر ما تعتني بالباطن. فتأويل الشريعة يعني أسرار العبادات، وتأويل الطريقة يعني أسرار النفس، وتأويل الحقيقة يعني أسرار الوجود. لا يبتعد صدر الدين الشيرازي في مسلكه التأويلي عن مذاق أهل المكاشفة؛ بل يتابعهم في مقولة الظاهر والباطن، ليرى أن للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطوناً سبعة هي مراتب المعنى القرآني الذي يتصاعد من المعنى الظاهر إلى المعنى المتخيل بالحواس الباطنية ثم إلى المعنى العقلي المجرد ثم إلى المعنى الأمري الذي هو عالم الروح. وهذان المعنيان الأخيران هما من عالم الآخرة، حيث يرى الشيرازي أن لكل منهما درجات ومراتب ومنازل ومقامات تتجاوز حدود العقل فضلاً عن الحس، وهي معانٍ لا يدركها إلا الأوحدي من الأنبياء والأولياء، أما لو تصاعدنا في المعنى فسنجد مرتبة فوق كل هذه المراتب لا يدركها أحد حتى الأنبياء إلا إذا فنوا عن العوالم وتجردوا عن النشآت وبلغوا مقام الوحدة.
على أن ما يرمي إليه الشيرازي من مقولة البطون، التي تتجاوز السبعة في الواقع إلى ما شاء الله تعالى، هو الإشارة إلى تكثر المعنى القرآني كثرة لا تقف عند حد لأنها كلمات الحق تعالى التي لا تنفذ: (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً)[2].
فهم الكلام الإلهي وفق التأويلية الصدرائية ليس مجرد مرتبة مدرجة ضمن الهندسة المعرفية لمراتب الحكمة المتعالية. إنه، بحسبها، كل المراتب بوصف كونه حاضراً فيها، محيطاً بها عميق الإحاطة. وهو في الآن نفسه مفيضاً عليها الوجود والعلم والتسديد. وإلى هذا فإنه لا يغادر أي منها إلا لكي ينشيء لها ظلاً وجودياً في القرآن. فالقرآن يتسع للمراتب الوجودية كلها. وضمن هذه الدّالة فهو جامع الوجود. كما في الآية (مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا)[3].
سيكون لنا مع المنجز الهرمنيوطيقي لصاحب الحكمة المتعالية منعطفاً بيِّناً في قراءة الوحي. هي تلك عرَّفها بـ «قراءة الراسخين في العلم». إذ أن فهم الكلام الإلهي عند هؤلاء الذين وصفهم الرسول بأنهم ليسوا بأنبياء ويغبطهم النبيون – ليس شرطه الظهور بكسوة الألفاظ والحروف ولا بتمثّل المتكلم بصورة شخصية، وإنما إلقاء معنوي إلى قلب مستمع من الله مباشرة أو من وراء حجاب[4].
وكلامه تعالى – حسب ملا صدرا – ليس كما قالت الأشاعرة من أنه معانٍ نفسية قائمة بذاته تعالى، ولا كما ذهبت إليه المعتزلة من أنه خلق أصوات وحروف، دالَّة على المعاني في جسم من الأجسام، وإلا لكان كل كلام، كلام الله؛ بل إن حقيقة التكلم إنشاء كلمات تامَّات وإنزال آيات محكمات وأخر متشابهات في كسوة الألفاظ والعبارات. والكلام قرآن وهو العقل البسيط والعلم الإجمالي، وفرقان وهو المعقولات التفصيلية وهماً جميعاً غير الكتاب، لأنهما من عالم الأمر وعالم القضاء وحاملها اللوح المحفوظ. وأما القلم والكتاب فهما من عالم الخلق والتقدير ومظهره عالم القدر الذهني والقدر العيني والأولان غير قابلين للنسخ والتبديل، لأنهما فوق الزمان بخلاف الثالث؛ لأنه موجود زماني ومحله لوح قدري نفساني هو لوح المحو والإثبات، والكتاب يدركه كل أحد وأما القرآن فـ (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)[5].
معالم التأويل في الفلسفة الصدرائية
تنحو تأويلية الحكيم الآلهي صدر الدين الشيرازي لآيات القرآن الكريم، نحواً لا سَبْقَ لعالم التفسير به من قبل. وبعد القرن العاشر الهجري، وهو الزمن الذي عاش فيه بما يقرب من خمسة وسبعين سنة، لم يأتِ بعده، على ما يظهر، إلا أولئك الذين اشتغلوا على نصّه شارحين أو مفسرين أو مؤوِّلين، وإما ناقدين لبعض أطروحاته الوجودية. ومع ذلك فهؤلاء لم يتجاوزا البناءات المعرفية التي شيدها في فضاء القرون الوسطى ولما تزل على جريانها الإحيائي في الفكر الفلسفي الإنساني والإسلامي المعاصر.
نضع هذا المؤشر في نطاق الكلام على فرادة الحكمة الصدرائية، لجهة اتخاذها صفتها الحداثية في زمنها، وفي الأزمان التي تلت. حتى أن ثمة من ذهب إلى توصيف تلك الرؤية، بأنها تمثيل نموذجي لـ «ما بعد حداثة الحضارة الإسلامية». فانطلاقاً من مبدأ أن لكل حضارة لحظة حداثتها، وما بعد حداثتها، فسيكون للحكيم الآلهي في ما أنجزه إحاطة العارف باللحظتين الحضاريتين معاً.
ولئن كانت مزيَّتا النقد والتجاوز هما اللتان ربطتا على قلب «النص الصدرائي» لتمنحاه خصوصيته، لاسيما في منجزه المعرفي الضخم «الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة»، فسيُنظر إلى «تأويليته القرآنية» بوصفها ذروة ما وصل إليه فضاء التفكير لديه.
ومع أن كثيرين من قُرَّاء الأسفار أعربوا عن حَيرتهم حيال طابعه المفارق، لجهة كونه نسيج إحالات لا متناهية من منقولات الشريعة ومقامات الحكمة، فقد وجدوا فيه فتحاً معرفياً استثنائياً في عالم الفلسفة الإلهية. من هذا الوجه سيبدو النص الصدرائي عبارة عن تناصٍ يتماهى مع نصوص متعددة ويفارقها في الآن عينه. كأن صاحبه يوحي لك بأنه لا يريد أن ينسب لنفسه أي شيء جديد. خصوصاً حين يتعلق الأمر بلحظة التعامل مع الكلام الإلهي. صحيح أن صاحب الحكمة المتعالية لا يخفي اعتزازه بجودة أفكاره وإبداعاته التي يعتقد أنه لم يسبقه إليها غيره، وهذا ما يجعله يبتعد عن حساسية ما بعد الحداثة، التي تنفر من كبرياء المبدعين القائلين بالخلق والأصالة. غير أنه بمجرد أن يعلن أنه مبدع هذه الفكرة أو تلك، يسرع إلى نسبتها إلى الحكمة العرشية وبوصف كونها من عطاءات الله. وهو إذ يرتضي لنفسه دور الوسيط لتظهير أسفار العقل الأربعة، صعوداً ونزولاً بين الحق والخلق. وهكذا يكون الشيرازي نجح في الجمع بين التاريخ وما بعد الطبيعة فهو ينص على السابقين عليه، يورد أقوالهم ثم يفسرها وينتقدها. وهو ما تزخر به أعماله حين نَقَدَ كبار الحكماء كالشيخ الرئيس ابن سينا، السهروردي، وقبلهما حكماء المشائية. لكنه عند لحظة الإبداع يروح يحيل ما أنجزه من إشراقات في مجال أصالة الوجود، والحركة في الجوهر، وسوى ذلك إلى الذات العليا التي تلهمه. وأنه بدلاً من أن يحبس خياله في عالم من المرايا التي تعكس بعضها بعضاً، عمل على أن ينفتح على آفاق ما بعد الطبيعة.
ما تقدم هو ضربٌ من قراءة تأخذ مساراتها التجريبية في فضاء التأويل المعاصر حيال تعامل صاحب الحكمة المتعالية مع النص القرآني. لكن هذا الضرب من القراءة الحداثوية لا يملك أن يحيط بطبقات الحكمة المتعالية ما لم يُحِط بمقاربته للكلام الآلهي. فالقرآن وفق التأويلية الصدرائية ليس مجرد مرتبة مدرجة ضمن الهندسة المعرفية لمراتب الحكمة المتعالية. إنه، بحسبها، كل المراتب بوصف كونه حاضراً فيها، محيطاً بها عميق الإحاطة. وهو في الآن نفسه مفيضاً عليها الوجود والعلم والتسديد. وإلى هذا فإنه لا يغادر أيًّا منها إلا لكي ينشيء لها ظلاً وجودياً في القرآن. فالقرآن يتسع للمراتب الوجودية كلها. وضمن هذه الدّالة فهو جامع الوجود (مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا)[6].
إن صفة “الجامعية والوحدة” هي ما ينبغي إضفاؤها على التأويلية الصدرائية. وذلك ما يُضادُّ الصفة التي خُلعت على تيارات ومدارس ما بعد الحداثة، لجهة تعلُّقها بمزايا الفرقة والتشظي. إن هذه الجامعية المستمدة من النص القرآني، لم تغادر المنازل الوجودية للحكمة المتعالية على اختلاف مراتبها.
إن تشييد عمارة الفعل التأويلي على أرض العلاقة المتعالية، شرطها مفارقة الأنا المبتليةُ بالشرك. ذلك أن بقاءها أسيرة نفسها، ولزومها منزل الأنانية، سوف يرتّب كلامها الخاص. وما دامت على كلامها الخاص فلن تفلح بإجراء الاتصال الداخلي الحميم بكلام الحق الذي لا شريك له. فإن في مبدأ «الشركة» هنا فراقًا يوازي فراق الوجود والعدم...
لم يكن صدر المتألهين ليملك اجتياز المصالحة بين الفلسفة والشريعة بغير القرآن. كان عليه لكي يستيسر عبور ضفتي التضاد هذه، أن يغيِّر خط الانطلاق. كأن يبتدئ أسفاره العقلية بــ «سَيْريَّة تفكير» تفارق سابقيه ومعاصريه من المشّاء والصوفية واتباع شيخ الإشراق. فإنه بدل أن يبدأ من «الأنا الفلسفي» المحض الذي سيوصله إلى التهلكة، يبدأ بـ «الهو» المتعالي أي الله أحد. فأن كل قول شاء له أن يشرق في سماء الحكمة المتعالية، ينبغي له أن يعتصم بالقول الإلهي ويتسدد به ثم ليعود إليه عند كل ظلمة تصيبه في وعثاء السفر. فلو جئنا إلى سورة التوحيد (الإخلاص) (قل هو) لوجدنا الأمرية الإلهية بالتوحيد الخالص. ذلك أن شرط التوحيد، حاصل بإقامة الحد على أنانية الأنا، وإلا وقع الشرك. مبتدأ العبور من الثنوية إلى الأحدية، ومن التكثير إلى التوحيد بهاتين المفردتين الأمريتين. فإنهما تقتضيان صيغة الأمر. أي: لا تقل أنا «قل هو»؛ نفي وإثبات. بذلك يكون فعل الأمر جعلاً إلهياً مقضيَّاً بالتوحيد. والآيات الواردة في توحيده كثيرة منها قوله: «لا تدع مع الله إلهاً آخر لا اله الاّ هو» – القصص- الآية 88-. وقوله «قل إنما يوحى اليَّ «أنَّما إلهكم إله واحد»- الأنبياء- الآية 108- وقوله «لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد» – النحل- الآية51.
وإذاً، محوُ «الأنا» تشكل مبتدأ النظر في الكلام الإلهي عند صاحب الحكمة المتعالية. ربما أدرك من خلال مكابداته الاستدلالية والكشفية أن حضور «الأنا» في المكابدات لا يفضي إلا إلى توليد الحُجُب. وإذاك تؤبَّد الجاهلية، وينأى الفؤاد من رؤية المقصود من القرآن.
لكن السير بالآيات لدى صدر المتألهين سوف يمضي به إلى حدوده القصوى لكي ينجز علياء المحو. ولعل رحلته العقلية المديدة في الأسفار الأربعة، هي التي ستفتح له على فضاءات التأويل المتعالي. وفي «المظاهر الإلهية» و«مفاتيح الغيب» و«الشواهد الربوبية» وهي المنجزات المعرفية المشهودة، سوف نجد ظهورات مسعاه على نحو جلي.
لقد سعى صاحب الحكمة المتعالية، وهو يفكك مذاهب المفسرين، إلى بيان حقيقة أن بقاء الأنا المفسِّرة علىعرشها الأرضي، سيؤدي إلى انغراسها وسكونها، ثم إلى يباسها في تربة الاحتجاب والجهل…
في كتاب مفاتيح الغيب يعرض صدر المتألهين أربعة مسالك تفسيرية للقرآن هي: مسلك أهل اللغة، ومسلك أهل التأويل الذين يصرفون الألفاظ عن مفهومها الأول.. ومسلك أهل الجمع بين التفسير الحرفي والتأويل، ثم ينتهي إلى الأخذ بما يسميه مسلك الراسخين في العلم.
خاصية أهل هذا المسلك الذي يتبناه ملا صدرا، أنهم – كما يقول – ينظرون بعيون صحيحة منوّرة بنور الله في آياته من غير عَوَرٍ ولا حَوَل ويشاهدونه في جميع الأكوان من غير قصور ولا خلل. إذ قد شرح الله صدورهم للإسلام، ونوَّر قلوبهم بنور الإيمان، فلانشراح صدورهم، وانفتاح روزنة قلوبهم يرون ما لا يراه غيرهم. ويسمعون ما لا يسمعون. ليس لهم حرارة التنزيه ولا برودة التشبيه، ولا الخلط بينهما، كالفاتر من الماء. بل كالخارج عن عالم الأضداد كجوهر السماء. فالخارج عن الضدّين ليس كالجامع للطرفين[7]..
تأويلية صدر المتألهين تنتمي إلى الصفات التي وضعها لمسلك الراسخين في العلم هي تأويلية أبدعت مفاتيح جديدة في عالم التفسير تقوم على استنباط طبقات النص عبر استئناف مستمر ودائم لعمليات الفهم. أما التأويل عنده فيرتكز إلى آليات مثلثة الأضلاع هي النص والعقل والكشف. وهو ما لم ينصرف إليه على الجملة جمع المفسرين في عصره.
ولئن كان ثمة ما يستشير الإشكال حول مصطلح التأويل، فلهذا المصطلح عند ملا صدرا معنى خاص، وهو أن التأويل يعني التفسير نفسه ولكن مع استئناف لا ينقطع من أجل استكشاف المزيد من فهم حقائق الآيات. لكن هذا النوع من التأويل (أي التفسير المستأنف) عند ملا صدرا له قواعده ومعانيه وضوابطه. نذكر منها على وجه الحصر ما يلي:
دحض طرق التفسير التي تفصل بين اللفظ ودلالته.
وصل ظاهر اللفظ بظاهر المعنى، وظاهر المعنى بباطنه وهكذا دواليك وصولاً إلى ما يسميه بالكشف.
دحض ثنائية المجاز والحقيقة في معرض تفسير المحكم والمتشابه من الآيات. إذ ثمة اتصال ووحدة بين المجاز والحقيقة. ذلك أن كل القرآن حقيقة لا مجاز في مقام الكشف.
عند (ملا صدرا) رؤية خاصة في تفسير النص انطلاقاً من تعريفه للتفسير على أنه مسعى لفهم نفس الكلام الإلهي. ونستطيع أن ندرج قراءتنا لفهمه الكلام الإلهي ضمن ما نسميه بالتأويل الجَمْعي. و«التأويل الجمعي»، هو ذلك النوع من العمل التفسيري، الذي يلمُّ بأشتات المناهج والآليات والطرق التفسيرية المتعددة، ثم ليأخذ منها على الجملة، من دون أن يغويه أيٌ منها فيتحيَّز فيه. ذلك ما لم يشأ ملا صدرا أن يفعله وبتعقّل مسبق. فإنما مراده من وراء جمعها أن ينشيء معها صلات اتصال، وتداول، ومخاطبة، ومحاكاة ثم ليفارقها جميعاً، من دون تمام القطيعة معها. إلا أنه سيستأنف رحلته نحو نسميه بـ «الجمع المتعالي». فلا يكون ثمة، بعدئذٍ، مع ما تم جمعه، فصلٌ تام ولا وصلٌ تامٌ. بل جدلية من الفصل والوصل تتسامى فوق التحيُّز، والتحديد، والمجادلة، ثم لتقيم بنيانها على مساحة الكلمات التامّات. ذلك على التعيين ما سنذهب إليه، إذ نرى إلى مبدأ الفهم والتفسير عند صدر المتألهين، على أنه فهم نفس الكلام الإلهي. وضوابط العلم الكلي. وربما لهذا السبب صحَّ أن يقال فيه إن: كتبه الدينية، والتفسيرية هي امتداد لفلسفته في صورة أخرى(. . . )
على حين ان كتاب «مفاتيح الغيب[8] »على سبيل المثال هو نتاج عناصر موحَّدة كثيرة اندمجت في صورة تركيبة واحدة، وهي الفلسفات المشائية والإشراقية، والآراء العرفانية، والمعطيات الدينية ناهيك عن التفسيرات والآراء الكلامية لعلماء ومتكلمين مثل الرازي والغزالي، كما أدرج فيه غير قليل من آرائهم وآراء غيرهم من الفلاسفة والعرفاء (. . . ) وفي هذا المعنى يُنظر الى عمل ملا صدرا في «مفاتيح الغيب» بصفة كونه خلاصة ما آلت اليه الحكمة المتعالية في مسعاها إلى تطابق العقل والشريعة وتوافق القرآن والوجود، وتساوق الفلسفة والدين. فكتاب مفاتيح الغيب - كما يقول العلامة محمد خواجوي- كتاب من طراز الفلسفة التطبيقية (المركبة) في حين يحتفظ في الوقت نفسه بأصول الحكمة المتعالية وقواعدها.[9]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]– فلسفة التأويل عند صدر الدين الشيرازي- علي أمين جابر – مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي – بيروت – ط 1 – 2014 – من ص 141 – 150.
[2]– سورة الكهف – الآية 109.
[3]– سورة الكهف – الآية 49.
[4]– صدر الدين محمد الشيرازي – المظاهر الإلهية- تحقيق جلال الدين الآشتياني – مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي- ط 2 – طهران. ص 104.
[5]– المصدر نفسه ص 106.
[6]– سورة الكهف، الآية 49.
[7]– ملا صدرا- مفاتيح الغيب- مصدر سابق- ص 153.
[8]– الشيرازي- مفاتيح الغيب
[9]– أنظر مقدمة «مفاتيح الغيب» – ص 56
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
محمود حيدر
-
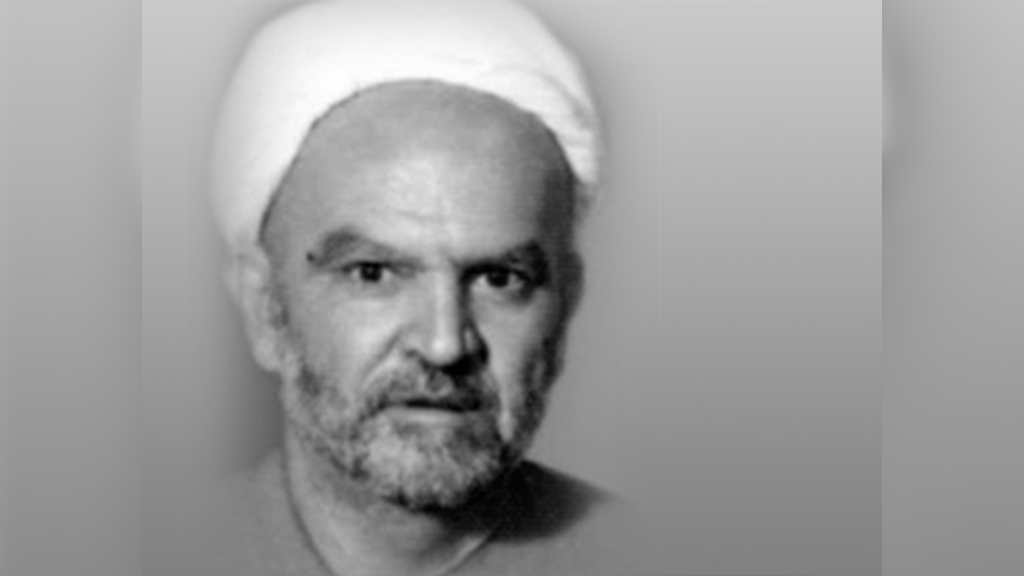 السّبّ المذموم وعواقبه
السّبّ المذموم وعواقبه
الشيخ محمد جواد مغنية
-
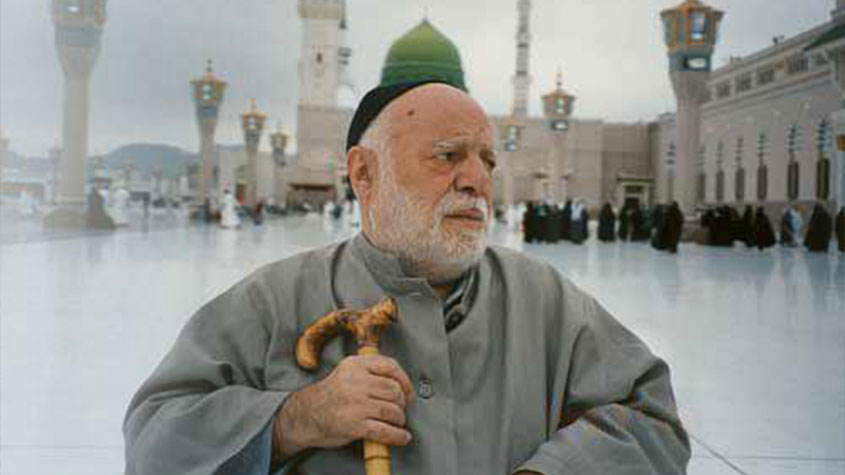 معنى (لات) في القرآن الكريم
معنى (لات) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أنواع الطوارئ
أنواع الطوارئ
الشيخ مرتضى الباشا
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
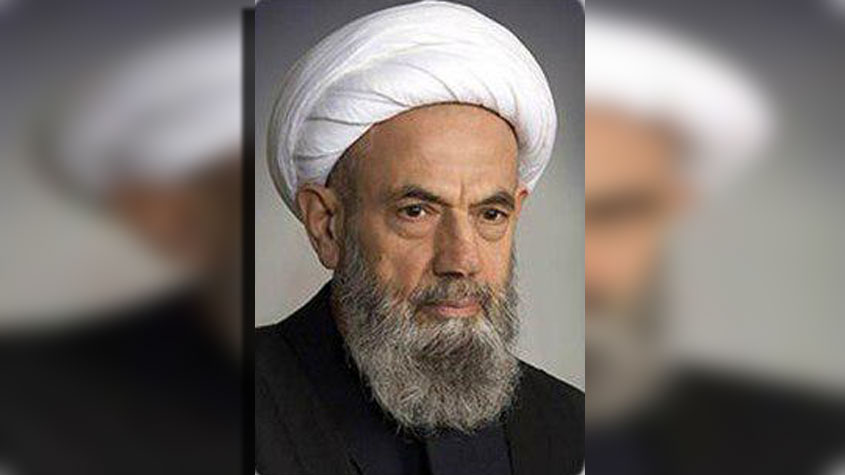 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
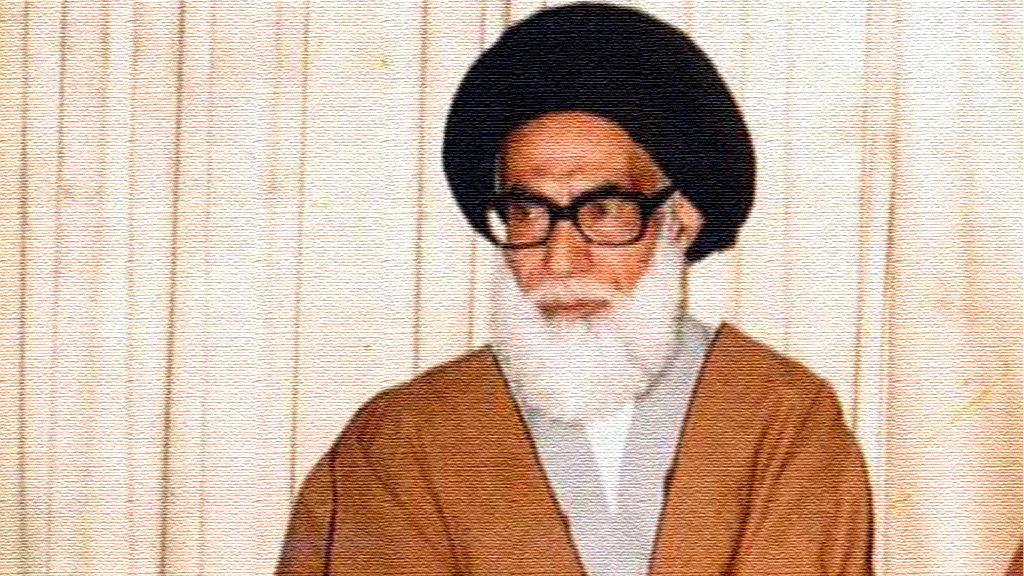 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
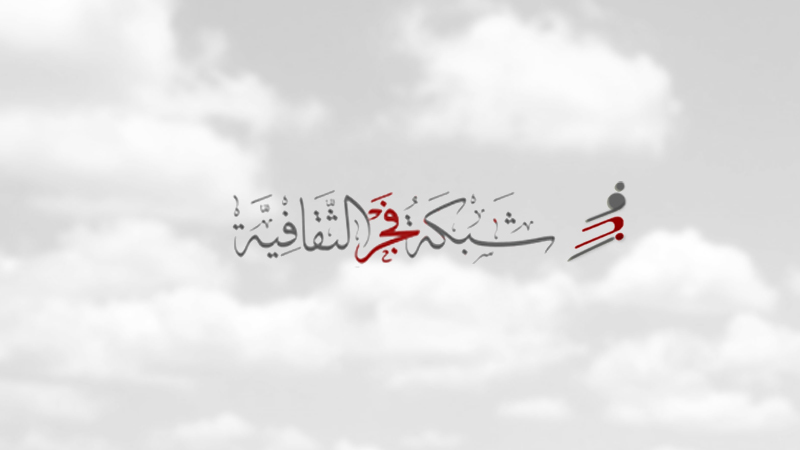 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
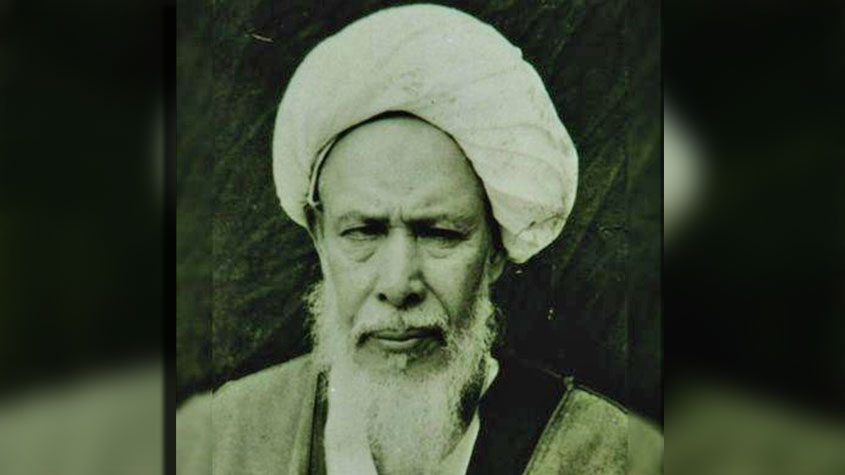 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-
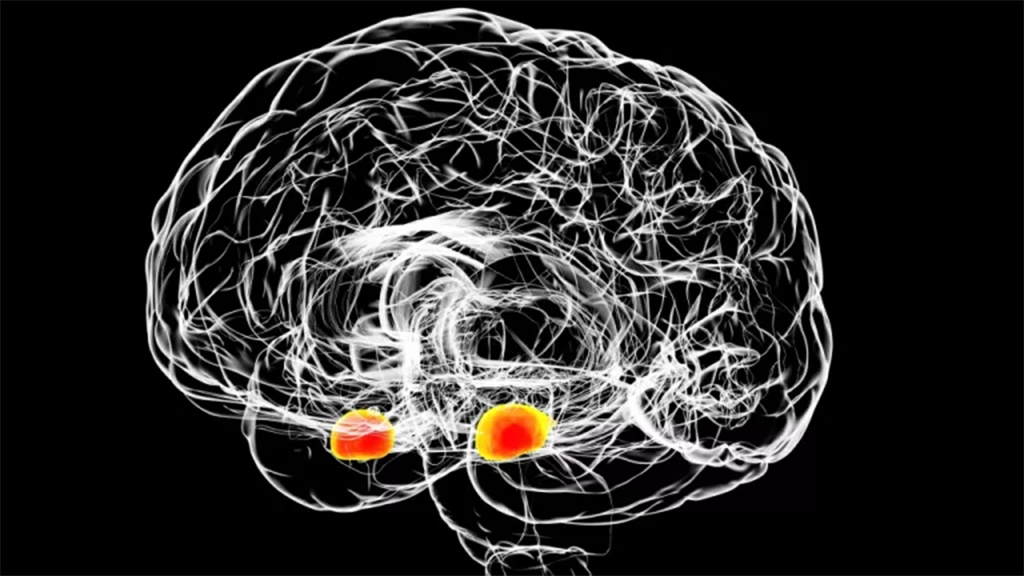
النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
-

خطر الاعتياد على المعصية
-
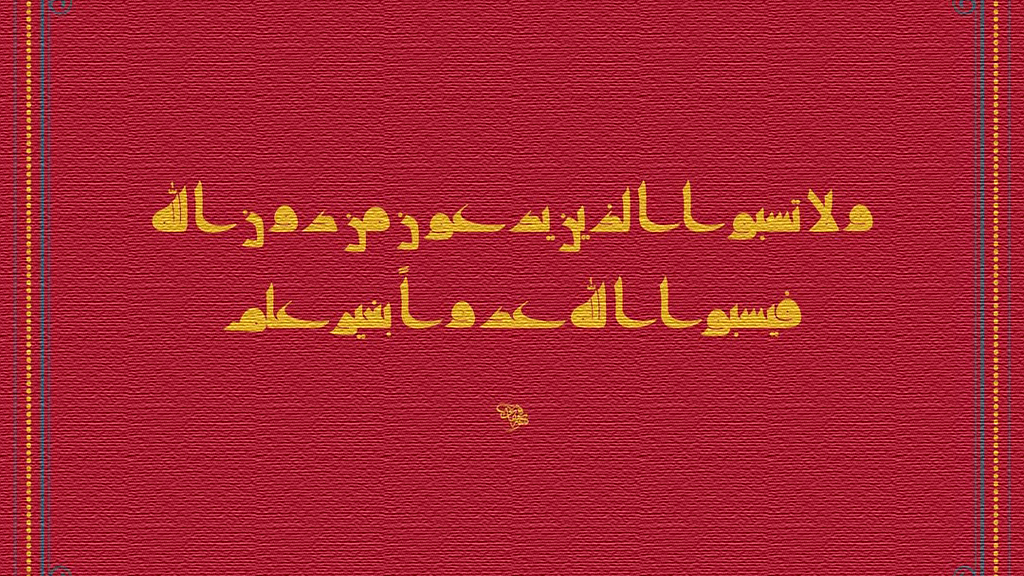
السّبّ المذموم وعواقبه
-
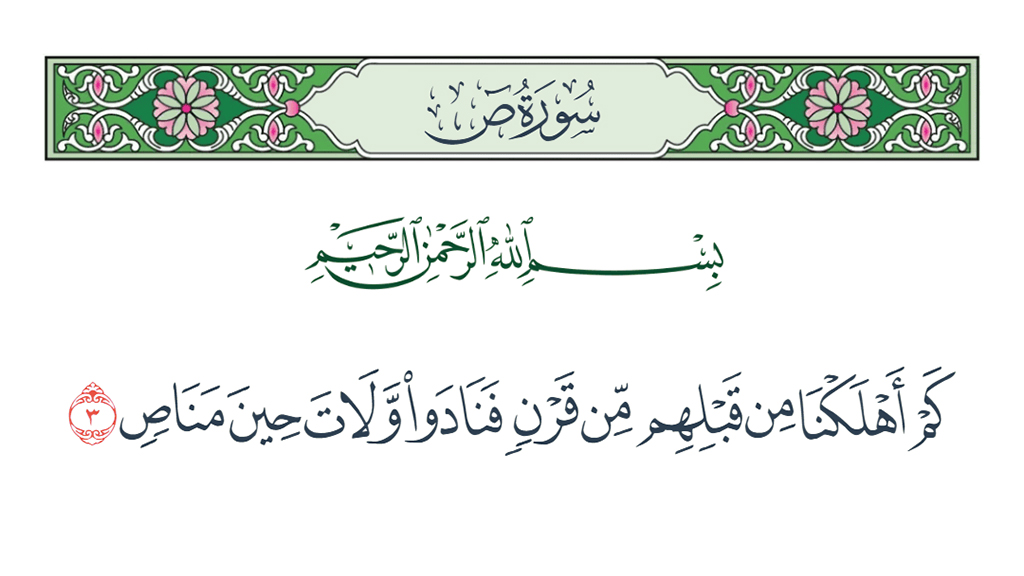
معنى (لات) في القرآن الكريم
-
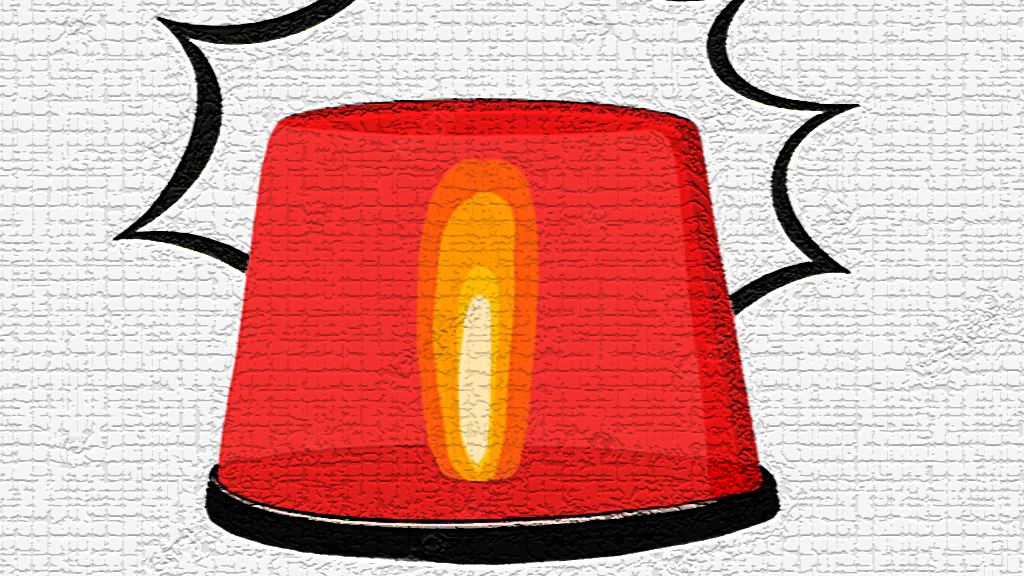
أنواع الطوارئ
-
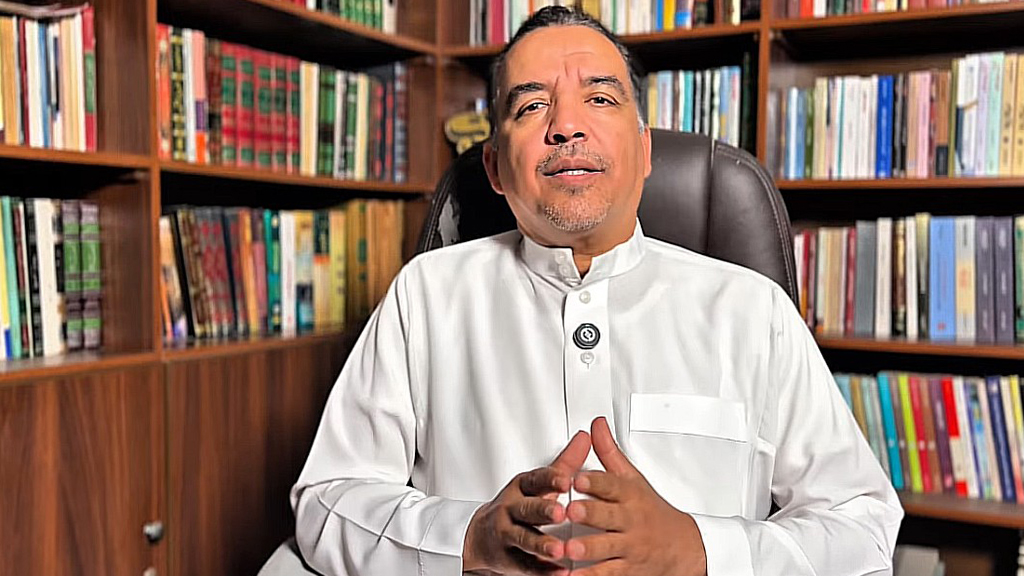
زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)