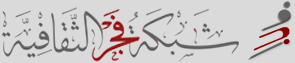علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (1)

تحمل كلمة “ما بعد” في كلِّ حالٍ من أحوالها، على التساؤل عمَّا إذا كان “الماقبل” قد انطوى وفات أوانُه. لكنَّ دلالة الكلمة لا تتوقّف على معنى أحاديٍّ أو على وجهٍ واحد؛ فإنَّما هي حمَّالةٌ لغير معنىً ووجه. إنَّ من “المابعد” ما يشير إلى استئناف أمرٍ بُغية استكماله.. ومنه ما يدلُّ على اضمحلالِ قديمٍ وولادة جديد.. ومنه كذلك، ما يعني وصولَ علمٍ ما إلى خاتمة مبانيه ومناهجه ومنظوراته، حتى فَقَدَ القدرة على الإتيان بخبر جليل.
ما نحن بصدده، في هذه المطارحة، تنظيرُ “المابعد” في فلسفة الدين قصْدَ متاخمتها على إنشاءٍ آخر. وهذا يوجب دربًا مفارقًا في المكابدة المعرفيَّة غايتُه أمران:
لمُّ الشمل بين عالَمَين [الفلسفة والدين] طال بينهما أمدُ الاختصام.
نقد أو تقويض ما اقترفته فلسفة الدين في مناهجها ونظريَّاتها ومسلَّماتها من أعطالٍ ومعاثر.
إذا عَنَت فلسفة الدين – كما صنَّعتها مقالة الحداثة – النظر إلى الدين كظهور سوسيو- تاريخيٍّ يُقرأ من خارجِهِ، أو أنها المعرفة المحايدة وتعليق الحكم كما تقرِّر الَّلاأدريَّة، أو حتى تقويضًا لمبانيه الوحيانيَّة كما فعلت العلمانية الملحدة… فسيكون من غير الجائز منطقيًّا أن يستوي نظرُها على صواب الرؤية. إذ كيف لفلسفة تنتسب إلى عالمٍ ليس من عالمها، ولا هي من طبيعته، ويصير اسمها حذو اسمه، أن تصدر أحكامها الصارمة عليه؟ ثم كيف لها من بعد ذلك، أن تجعل الدين حقلًا لاختباراتها، في ما هي تنكر عليه ماهيَّته التوحيديَّة ومسلَّماته الوحيانيَّة؟
ذاك كان من أعقد مُعضلات الفلسفة لمَّا أقبلت على الدين إقبالَ المُقبِلِ على غريب، ثمَّ مضت ترتِّبُ أحكامها عليه، وترسم له معالمه وسِماته، حتى من قبل أن تتعرَّف إلى هوّيَّته الحقيقيَّة، ومنزلته عميقة الغور في النفس البشريَّة.
لقد سبق لهذه المعضلة بالذات، أن تشيعَ بقوَّة في سياق الجدل المفتوح بين التيَّارين الفلسفيِّ والَّلاهوتي في أوروبا القرن الثالث عشر. وقتذاك توجَّه القدِّيس توما الأكوينيُّ إلى أساتذة الَّلاهوت وطلب إليهم أن يجتنبوا الاستدلال على أصلٍ إيمانيٍ بالبرهان المنطقيّ، لأنَّ الإيمان لا يرتكز على المنطق، بل على كلمة الله. وعلى التوازي راح ينبِّه أساتذة الفلسفة ألَّا يستدلَّوا على حقيقة فلسفيَّة باللجوء إلى كلمة الله، لأنَّ الفلسفة لا ترتكز على الوحي، بل على العقل ومقولاته. ومع أنَّ الأكوينيَّ كان أرسطيًّا متشدِّدًا، فقد حرِصَ على التمييز بين الفلسفة والوحي؛ وهَدَفُه حفظ قدرة كلٍّ منهما على إنتاج المعرفة الصحيحة، وبما يتناسب وطبيعة كلٍّ منهما. فإذا كان الَّلاهوت هو العلم بالأشياء عن طريق تلقِّيها من الوحي الإلهيِّ، فالفلسفةَ هي المعرفة بالأشياء التي تفيض من مبادئ العقل الطبيعيّ. ولأنَّ المصدر المشترك للفلسفة والَّلاهوت هو الله خالق العقل والوحي، فإنَّ هذين العلمين يسيران باتِّجاه نقطة نهاية واحدة…
ذاك يفيد بضرورة تمييز المعرفة الفلسفيَّة المبنيَّة على مبادئ العقل، عن المعرفة الدينيَّة الآخذة بمسلَّمات الوحي. وهذا التمييز لا يرمي في الواقع، إلى الفصل والتفريق الموصل إلى القطيعة، وإنَّما يقصد التأليف بين معرفتين قامتا على تباين واختلاف في المنهج، إلَّا أنَّهما تختزنان مَيْلًا أصليًّا نحو التناغم والانسجام.
تأسيسًا على مبدأ التأليف بين المعرفتين، تنهض فرضيتنا حول “المابعد”، على تصور لأطروحة ذات أفقين متعاونين: الأفق الأول، يفتتح سَيْرًا مرنًا باتجاه مستحدثٍ معرفيٍّ مُفارق، من سماته الأساسيَّة، أنَّ “مابعديَّته” لا تُسقِط ما قبلها ولا تحكم عليه بالبطلان، وإنَّما تقيم له مطرحًا مناسبًا في نظامه المعرفيّ.. أما الأفق الثاني ففيه تُعرب الأطروحة “المابعديَّة” عن رغبة بالمجاوزة، من خلال التنظير لمقترح يجمع العقل إلى الوحي على نصاب الواحديَّة، ويغدوا معًا دربة ومنهاجًا لفهم العالم بوجهيه المرئي والوحياني.
نجدنا هنا تلقاء تفكير جديد، هو أقرب إلى هجرة معرفيَّة تتغيَّا من وجهٍ أول، نقد المبدأ المؤسِّس الذي منه نمت وتطورت فلسفة الدين، ومن وجهٍ ثانٍ، تقويض ما يُفترض تقويضُه مما فَسُدَ أعرافها ونظريَّاتها وأبنيتها المنطقيَّة والإبستمولوجيَّة. ما يحملنا إلى هذه الهجرة المعرفية المركبة هو تبديد طائفة من الأوهام رافقت اهتمام الفلسفة بالدين، في مقدمها إقصاء معرفة الله والدين النظري من حقل المعرفة التي يمكن تحصيلها عن طريق العقل، مع ما يستتبع ذلك من نفيٍ لكل ما لا يقع تحت أمرة العقل القياسي تجربة واستدلالًا. لعلَّ هذا، هو الداعي إلى وجوب مراجعةٍ جوهريَّةٍ تقيم التفكُّر الفلسفيَّ في الشأن الدينيِّ على نصاب يتعدَّى ما انصرفت إليه الحكاية الفلسفيَّة الكلاسيكيَّة حين أوقفت رؤيتها إلى الدين على قياس العقل الطبيعيِّ ومقتضياته.
في صدد ماهيَّة فلسفة الدين وطبائع فلاسفتها
لم تنجُ فلسفة الدين – كما سوَّغتها الحداثة الوضعانية- من معثرة تكوينيَّة في نظامها المعرفيِّ تنتهي إلى جعل الدين مجرَّد موضوعٍ للاختبار والتدارس كأيٍّ من موضوعات العلوم الإنسانية الأخرى. بيد أنَّ لهذه المعثرة التكوينية نتائج فادحة ليست مجرَّد فرضيَّة تُؤسَّسُ عليها المقاربة الأنثروبولوجيَّة للدين، بل هي في واقع الأمر، إعرابٌ صريح عن سيادة الفلسفيِّ على الدينيِّ وأمريَّته عليه. فلو اتَّفقنا على كون فلسفة الدين “فلسفة مضافة”، بمعنى أنها تفريع للفلسفة الأولى وامتداد لها، فمن غير المنطقيِّ أن يُصدِرَ الفرعُ حكمًا على صحَّة أو بطلان ما يقوم عليه الأصل.
فلو فعلت “الفلسفة المضافة” ذلك، لحَكَمَت على نفسها بمثل ما حَكَمَت على أصلها، أي إبطال المبادئ الناظمة لمشروعها المعرفيِّ وتقويض مرتكزاته ومبانيه الأصليَّة. فالعلمُ المضاف – بوصف كونه مضافًا – يبقى مستتبعًا لمصدره الأول، ولا يملك أهليَّة حلِّ المعضلات الميتافيزيقيَّة الكبرى. وإذا كان هذا هو واقع الحال فماذا سيكون عليه الحال التالي حين يتصدَّى علمٌ وضعانيٌّ لأمرٍ وحيانيٍّ غيبيٍّ بعقلٍ حسابيٍّ مقيَّدٍ بمعياريَّة المفاهيم وصرامتها؟.. سوف يتوضَّح محلُّ النزاع لو تنبَّهنا إلى أنّ الموضوع المحوريَّ في التنظير الحداثيِّ لفلسفة الدين كامنٌ في النظر إلى المسائل الاعتقاديَّة كظواهر لا تكتسب حقَّانيتها وواقعيَّتها إلَّا بمدى تطابقها ومبادئ العقل الاحتسابيِّ ومقولاته. بهذا التعيُّن تتحوَّل الرؤية الفلسفيَّة الوضعيَّة للدين إلى علم مقطوع الآصرة عن الماوراء؛ شأنها في ذلك شأن سائر موضوعيَّات العلوم الإنسانيَّة. فإذا كانت الميتافيزيقا نظام معرفة وتعرُّفٍ على المبدأ الأول والأسباب الأولى للأشياء، فما تبديه فلسفة الدين هو الانشغال بالشأن الدينيِّ كمُعطى “محض” فينومنيولوجيّ. وسيرد في تنظيرات فلسفة ما بعد الحداثة ما يسوِّغ النظر إلى الدين كظاهرة سوسيو- تاريخيَّة، وعلى الفلسفة أن تتعاطى حيالها كحقل معرفيٍّ منزوع الصلة عن بُعدِهِ الغيبيّ.
الفرضيَّة المؤسِّسة لفكرة كهذه تقرِّر أنَّ الفينومينولوجيا ليست علمًا تمهيديًّا للفلسفة، بل هي الفلسفة نفسها، ما يعني أنَّ مهمَّة الفلسفة بتعريفها المذكور، باتت خارج موطنها الأصليِّ، أي العلم بمبدأ الأشياء ومعرفة الشيء في ذاته. ومع أنَّ هذه الفكرة سيحملها عدد من كبار مجدِّدي الفينومينولوجيا الحديثة أمثال هوسرل وهايدغر وسواهما، إلَّا أنَّها لم تفارق النطاق العامَّ للتفكير الوضعانيِّ حيال الدين. الشاهد هنا، ما دعا إليه هؤلاء وفي مقدَّمهم هايدغر من أنَّ على فلسفة الدين في أفقها التاريخيِّ أن تفهم الحاضر وتحدِّد مسبقًا التطوُّر المستقبليَّ للدين، ثمَّ عليها أن تقرِّر ما إذا كان سيكون هناك دينٌ عامٌّ للعقل يجري إنشاؤه بطريقة توفيقيّة من الكاثوليكيَّة والبرتستانتيَّة، أو ما إذا كانت إحدى الديانات الوثوقيَّة (Positive) مثل (المسيحيَّة – البوذيَّة – الإسلام) ستسود وحدها في المستقبل. (هايدغر – فينومينولوجيا الحياة الدينيَّة – ص 39).
على منقلبٍ آخر، وفي مقام شغفها الأقصى بالهمِّ الدينيِّ، تتدرَّج فلسفة الدين لتصير أكثر تماهيًا مع مشاغل اللاهوت وعلم الكلام، وخصوصًا لجهة عنايتها بأسئلة الوجود: نظير: “هل الله موجود؟”، و”ما معنى الحياة؟”، و”ما هي السعادة؟”، و”هل ستتحقَّق الحياة الخالدة؟”، وسواها من الأسئلة. لكنَّ الفارق بين فلسفة الدين وما يناظرها كلاميًّا أو لاهوتيًّا، يكمنُ في أنَّ العِلمَيْنِ الأخيرين يستندان إلى الوحي، في حين تستند الفلسفة إلى سنَّة العقل وحسب.. لهذا، قد يبدو للنُّظَّار كما لو أنَّ فلسفة الدين تنشط في منطقة حياديَّة، حين تمارس نقدها للمنظومة الدينيَّة. وإذ نستكشف مسالكها يظهر لنا كيف ستعمل بصورة حثيثة لنقد -أو تقويض- مختلف المعتقدات من دون أن تخشى تهمة الانحياز والحياد غير الإيجابيّ. قد يكون في مثل هذا المسلك شيءٌ من الصواب في أحيانٍ خاصَّة، إلَّا أنَّ إجراءاتها النقديَّة الإقصائية، في عصور الحداثة، تبطل مدَّعى الحياد المعرفيِّ، لا سيَّما في تعاملها مع المسائل الكبرى لعلم الوجود، نظير الوحي والروح والتوحيد الإلهيّ…
وأنَّى ما يُقال من مسميَّات وأفعال وتعاريف حول فلسفة الدين، فستكشف العمليات الاستقرائيَّة عن طائفة من العناصر تفيد الوقوف على ماهيَّتها والأحيان التي تعكس فيها هوّيَّتها الفعليَّة:
الأول: حين يُدرَس الدين وفقًا للمقولات الفلسفيَّة، أنطولوجيًّا ومعرفيًّا وتاريخيًّا.
الثاني: حين يُرى إلى الدين كموضوع يتناوله الفلاسفة كلٌّ على طريقته.
الثالث: حين يُقرأ الدين فلسفيًّا على أرض المقولات الدينيَّة.
الرابع: حين يتكلَّم الفيلسوف، عن الدين كموضوع، ويستند إلى مقدِّمات فلسفيَّة من خارج الدين للبحث في القضايا الدينيَّة.
الخامس: حين يتوجَّه فيلسوف الدين إلى البحث في الدين بوصفه ظاهرة بشريَّة منزوعة الصِّلة من بُعدها الغيبيّ.
السادس: حين يتعامل فيلسوف الدين مع دينٍ معيَّنٍ قصد إجراء بحوث مقارنة مع أديان أخرى.
السابع: حين يؤثرُ فيلسوف الدين العمل وفق المنهج “الخارج دينيِّ” ليدخل دائرة البحث الدينيّ.
إلى العناصر المذكورة، يُحتمل أن تنبسط نوازع فيلسوف الدين وميوله على أنحاء شتَّى: إمَّا مُنكرًا لله، أو مؤمنًا به، أو لا أدريًّا. ثمَّ إنَّه ليس بالضرورة أن يكون ملتزمًا بدينٍ معيَّنٍ حتى يمارس مهمَّته الفلسفيَّة، ذلك أنَّ كلمة الدين في فلسفة الدين، كلمة مطلقة وغير مقيّدة بدينٍ معيَّن من دون سواه، أي أنَّها غير مقيَّدة لا بالإسلام ولا بالمسيحيَّة ولا باليهوديَّة، ولا بسوى ذلك من الديانات غير الوحيانيَّة. لهذا الداعي وسواه، غالبًا ما يكون فيلسوف الدين مأخوذًا، بأسئلة قلقة لا تسفر إلَّا عن إجابات قلقة، لكنَّه يبقى مسكونًا برغبة التوصُّل إلى جوابٍ ما، من أجل أن يمنح نفسه قِسطًا من يقينها المفقود. ولأنَّه كثيرًا ما يخذله السؤال عن تحصيل الجواب الآمن، نجده مستيئسًا من أيِّ بارقة أمل. لذا أكبَّ على اقتفاء أثر عالم الممكنات قصد تحرِّي عِللِهَا وأسبابها والنتائج المترتِّبة عليها. وفي هذا السبيل سيلتجئ إلى عالم السؤال من أجل أن يستفهم عن الوجود بما هو موجود مرئيٍّ ومتعيِّن. غير أنَّ استيطانه كهف الممكنات سيؤدّي به عمومًا إلى التشكيك أو إنكار ما لم يستطع نَيْلَه عبر دابَّة العقل. بذلك يكون فيلسوف الدين المعاصر قد اقتفى أثر الأوَّلين من دون أن يلتفت سوادهم الأعظم إلى المشكلات المعرفيَّة الناجمة عنه. من البيِّن أنَّ الفلسفة في تطلُّعِها إلى الأمر الدينيِّ لم تتخلَّص من تاريخها الإشكاليِّ منذ اليونان إلى أزمنة الحداثة الفائضة. وهذا هو الداعي الذي جعل كلَّ مسألة ذات طبيعة فوق ميتافيزيقيَّة (غيبيَّة) تستعصي على الحلّ.
المعثرة الكبرى في مكابدات الميتافيزيقا القبْليَّة كامنة أساسًا في انزياحها عن مهمَّتها العظمى، وهي فهم العالم كوجود متصل، بين مراتبه الطبيعية وفوق الطبيعيَّة. ولئن كانت هذه هي مهمّتها الأصليَّة- وهذا ما يميّزها عن العلم- فذلك تذكير بما هو بديهيٌّ فيها، أي استكشاف قدرتها – وما تنطوي عليه من مَلَكَات العقل النظريِّ – على الإحاطة بالمستتر في الوجود. وهذا إقرار لها كعلمٍ حيٍّ يُحيي نفسه ويُحيي سواه من العلوم في الآن عينه. ولا مناص من الالتفات إلى أنَّ من أحسن حسنات الفلسفة، أنَّها لا تكفُّ عن إعلان رسالتها الأصليَّة، حتى وهي تستغرق في دنيا الممكنات وعوارضها. فالخاصيَّة الملحوظة لكلِّ التعاليم الميتافيزيقيَّة، هي التقاؤها على ضرورة البحث عن ذلك الأصل في كل موجود. وفي تاريخ الفلسفة – الكلاسيكيَّة والحديثة – كثُر الحديث عن هذا المبدأ الذي يُسمِّي المادَّة الأولى مع ديمقريطس، والخير مع أفلاطون، والفكر الذي يفكِّر بذاته مع أرسطو، والواحد مع أفلوطين، والوجود مع كلِّ الفلاسفة المسيحيين. في أزمنة الحداثة تبدَّلت الأسماء والأوصاف، إلَّا أنَّ المقصد إلى الأصل بقي هو نفسه. فقد اتَّخذ المبدأ الأول صفة القانون الأخلاقيِّ مع كانط، والإرادة مع شوبنهاور، والفكرة المطلقة حسب هيغل، والديمومة الخلّاقة عند برغسون. وفي جميع الأحوال، فإنَّ الميتافيزيقيَّ القاصد إلى الأصل هو ذاك الذي يبحث في ما وراء وبعد التجربة عن مصدر مطلق لكلِّ تجربة حقيقيَّة وممكنة.
وتبعًا لهذه الرؤية ما عاد يصحُّ اعتبار الإنسان حيوانًا ناطقًا كما قرَّر أرسطو، بل هو كائنٌ ميتافيزيقيٌّ بالطبع والغريزة، أي أنَّ ماهيَّته ميتافيزيقيَّة، عكس كلِّ الماهيَّات التي تنطوي في خِلقتها الأولى على عاقل يعقلها ويرعاها ويدبِّر لها أمرها. فالقانون – على سبيل المثال – الذي هو مخصوصٌ بالكائن الإنسانيِّ لا يكتفي بتقرير الحقيقة، بل يشير إلى سببها. وبما أنَّ الإنسان عاقلٌ بماهيَّته، فقد وَجَبَ تفسيره والبحث عن ماهيَّته في بنية العقل نفسها. بكلام آخر؛ ينبغي أن يكون السبب في أنَّ الإنسان حيوان ميتافيزيقيٌّ كامنًا في مكان ما من طبيعته العقلانيَّة. ولقد لَفَتَ الفلاسفة إلى حقيقة تفيد بأنَّ في المعرفة العقليَّة من الصوابيَّة المنطقيَّة ما هو أكثر ممَّا في التجربة الحسّيَّة. وهم سوَّغوا ذلك بأنَّ الخصائص النموذجيَّة للمعرفة العلميَّة، مثل “الكليَّة والضرورة”، لا يمكن إيجادها في الحقيقة الحسيَّة، في حين أنَّ التفاسير الأكثر عموميَّة تؤكِّد أنَّ المعرفة العلميَّة تأتي إلينا من قدرتنا أصلًا على المعرفة.
لذا يقال إن لا شيء يحلُّ في العقل ويتمُّ تعقُّله ما لم يمرّ من قبل في الحواسِّ ما عدا العقل ذاته. ومثلما كان كانط أول من فقد الثقة بالميتافيزيقا وتمسَّك بها باعتبارها أمرًا لا مفرَّ منه، كان هو نفسه أوّل من نبَّه إلى قدرة العقل البشريِّ الملحوظة في تجاوز كلِّ تجربة حسيَّة. وهو ما سمَّاه بـ “الاستعمال المتعالي للعقل”. غير أنَّ المفارقة في تنظير “ناقد العقل الخالص”، إعراضُه عن تحويل فكرة الاستعمال المتعالي للعقل إلى منفتح لمبدأ يؤسِّس الحداثة وفلسفتها على منشأ جديد. ولقد وجدناه يعزف عن مشروعه في تعاليه، لينعطف رجوعًا ويتَّهم الميتافيزيقا بأنَّها المصدر الدائم لأوهامنا الميتافيزيقيَّة. (وحدة التجربة الفلسفيَّة، ص 226).
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
محمود حيدر
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
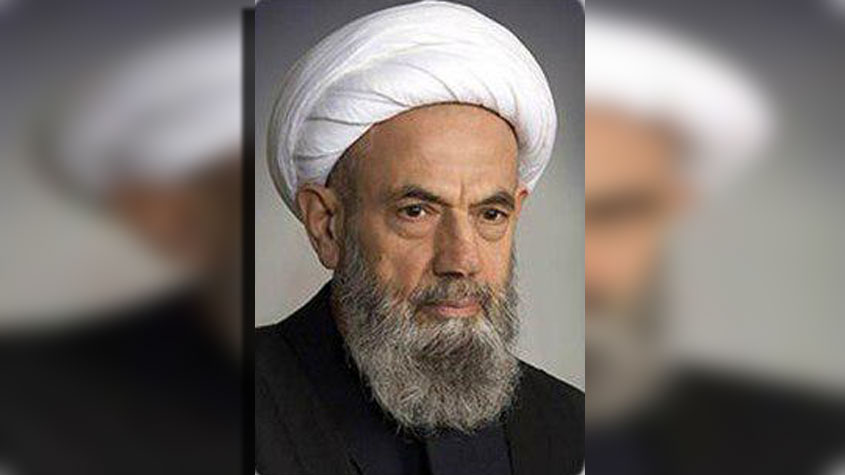 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
الشيخ مرتضى الباشا
-
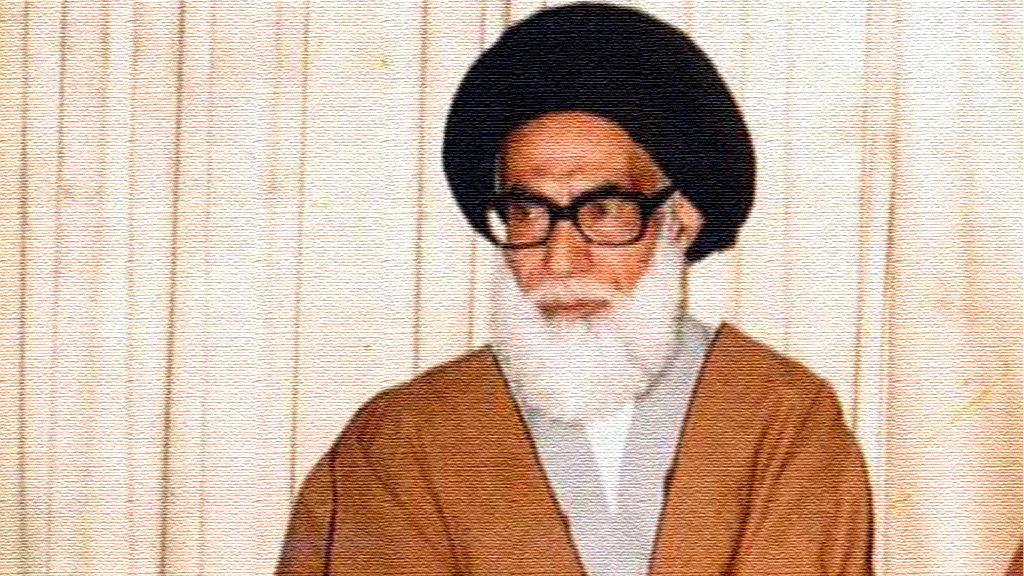 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
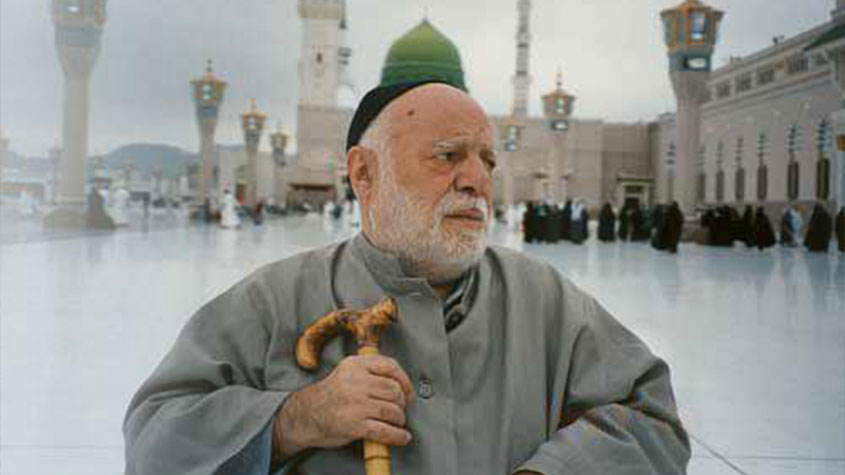 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
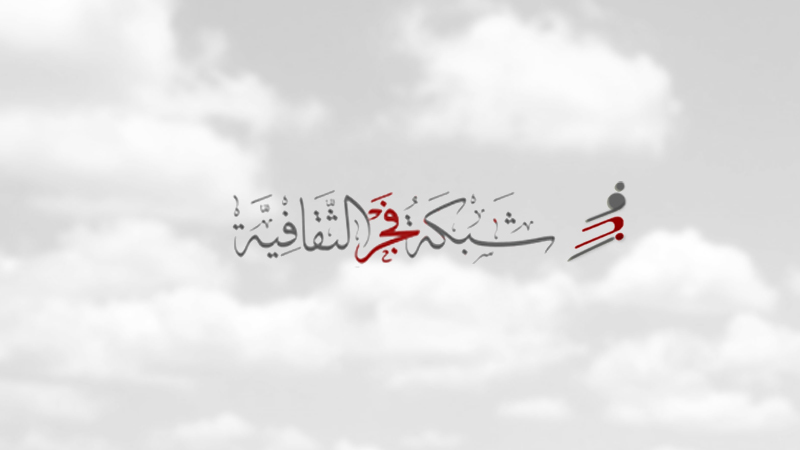 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
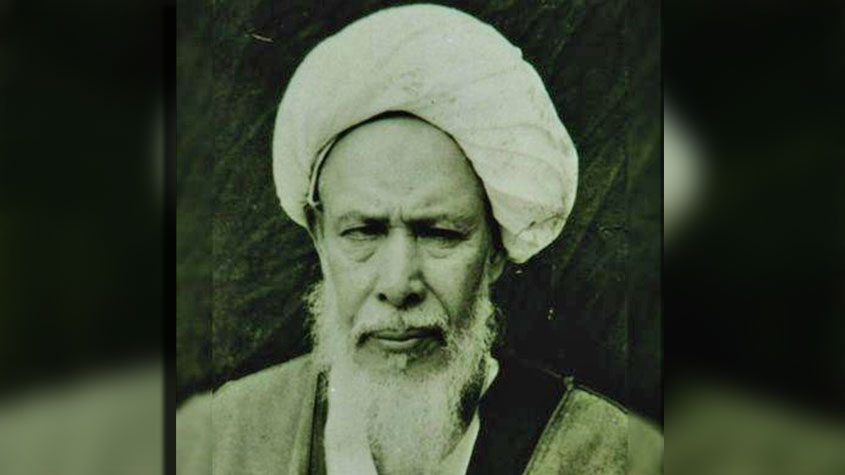 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-
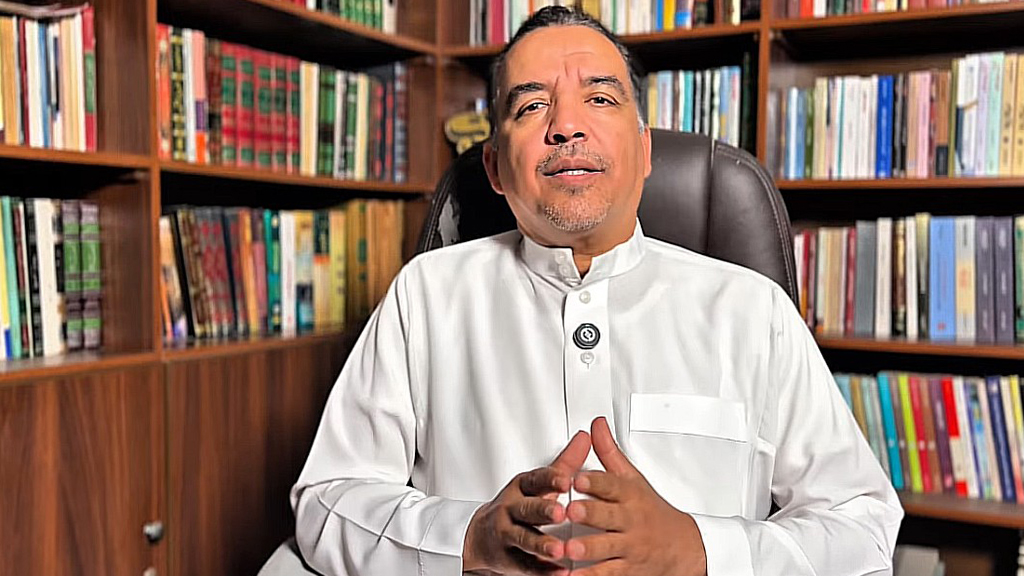
زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)
-
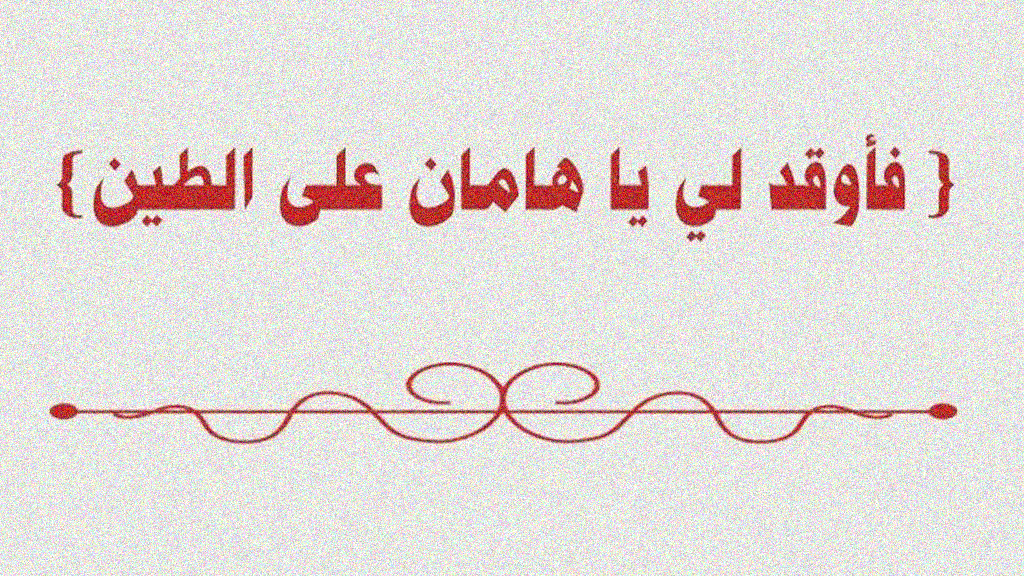
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة
-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟