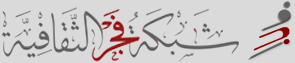علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (5)

منزلة المثنَّى /المبدأ في المعرفة العرفانيَّة
ماهيَّة المبدأ كما تُستقرأ في الإلهيَّات والعرفان النظريِّ، تستوي على نصاب معرفيٍّ يفارق ما ابتدأه الإغريق، فضلًا عن المتأخّرين من بعدهم. لقد اتَّخذ الكلام على الموجود الأول في الميتافيزيقا الوحيانيَّة مسالك شتَّى؛ إلَّا أنَّ جامعًا مشتركًا حول ماهيَّته ظلّ ينتظم دائرة واسعة من تلك المسالك. وفي المجمل كان يُنظر إلى هذا الموجود على أنَّه مطلقٌ من حيث كونه أوَّل موجود في مشيئة الإيجاد الإلهيِّ، ونسبيٌّ من حيث كونه محتاجًا لموجِدِه ومركَّبًا على الزوجيَّة والكثرة. ويمكن لنا أن نتبيَّن في ما يلي، سِمَتين أساسيَّتين لمبدأ الضدِّيَّة:
السِّمة الأولى: أنَّ لمعرفة المبدأ في مفارقاته علاقةً وثيقةً بمفهوم الأضداد: فمشاهدة الحقيقة الإلهيَّة الحاضرة والقريبة والموجودة في كلِّ شيء – فالأضداد كامنة في الأضداد: إذ العلوَّ كامن في الدنوِّ، والعزُّ كامن في الذلِّ، إلى غير ذلك من الأوصاف العلويَّة مع الأوصاف السفليَّة…”. فـ”الأشياء كامنة في أضدادها ولولا الأضداد لما ظهر المضادُّ كما يقول العارفون”.
السِّمة الثانية: أنَّ الوعي بالأضداد في منزلة كونه وعيًا فائقًا، مقتضاه الشعور بالدهشة عند الوقوف على الحقيقة، أو الوقوف عند مرحلة التحقيق: وكلَّما كان الضدَّان متباعدين كان الالتقاء بينهما مصحوبًا بدهشة قويَّة من طرف العارف أو المتأمِّل. وهنا سنلاحظ أنَّ من العرفاء من ذهب بعيدًا في التمثيل بالدهشة الناتجة من التقاء الأضداد في تجربة الانتقال من الكفر إلى الإيمان. فالمشاهدة – كما يبيِّن العارف بالله ابن عجيبة الحسني – تتقوَّى لدى أهل الكفر الذين تابوا من كفرهم ورجعوا إلى مشاهدة الحقيقة الإلهيَّة أكثر من أهل الإيمان[المصدر نفسه، ص 37]. وهكذا، فإنَّ هذه الدهشة هي صيرورة دائمة تتواصل بتواصل المعرفة: فإذا كانت الدهشة هي بداية الفلسفة أو التفكير كما قيل، فإنَّ الدهشة في الفكر مصاحِبة للمعرفة منذ بدايتها وخصوصًا في غايتها.
علم “كان” و”علم البَدء”
في العرفان النظريِّ يتوسَّع أفق التنظير والاستشعار، حتى لنجدُنا تلقاء مساعٍ فريدة ومفارقة بغية الخروج من العثرات التي تحول دون الأجوبة الآمنة. ولأجل الوقوف على أهمِّ هذه المساعي نلقي الضوء بداية على قاعدتين تؤلّفان أبرز التنظيرات التي عَنِيَت بنظام معرفة الموجود البَدْئيّ، وقد ذكرهما ابن عربي في ردِّه على أسئلة الحكيم الترمذيِّ، وهما: علم “كان” و”علم البدء”[ابن عربي- أجوبة ابن عربي على أسئلة الحكم الترمذي- إعداد وتحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبي – مكتبة الثقافة الدينيَّة – ط 1- القاهرة – 2006 – ص 41-42].
القاعدة الأولى: علم “كان”: ولهذه القاعدة صلة نَسَبٍ وطيدة بعلم المبدأ. فالمقصود من علم “كان” هو تنزيه الله تعالى عن كلِّ ما سواه من أشياء الكون. وتأسيسًا على قوله تعالى: (لَيسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ) [الشورى- 11]. يقرّر علم “كان” أنَّه سبحانه لا تصحبُه الشّيئيَّة، ولا تنطلق عليه.. فقد سَلَب الشيئيَّة عنه، وسَلَب مَعيّة الشيئيَّة. إنَّه مع الأشياء، وليست الأشياء معه. لأنَّ المَعيَّة تابعة للعلم: إنَّه يعلمُنا فهو معنا، ونحن لا نعلمُه فلسنا معه.. وأمَّا لفظة (كان) فليس المراد منها التّقييد الزمانيَّ، وإنما المراد الكون الذي هو (الوجود). فتحقيق “كان” أنَّه حرف وجوديٌّ، لا فعل يطلُب الزمان. ولهذا لم يَرد ما يقوله علماء الرُّسوم، من المتكلّمين، وهو قولهم “وهو الآن على ما عليه كان”، فهذه زيادة مُدرجة في الحديث ممَّن لا علم له بعلم (كان)، ولا سيَّما في هذا الموضع كما يبيِّن ابن عربي.. ويضيف: ولئن تصرَّفت “كان” تصرُّف الأفعال، فليس من أشْبَه شيئًا من وجه ما يُشبهه من جميع الوجوه، بخلاف الزيادة، بقولهم “وهو الآن”، فإنَّ “الآن” تدلُّ على الزمان. وأصل وضعه أنها لفظة تدلُّ على الزمان الفاصل بين الزمانين (الماضي والمستقبل).. فلمَّا كان مدلولها “الزمان الوجودي”، لم يُطلقه الشارع في وجود الحقِّ، وأطلق (كان) لأنَّه “حرف وجوديّ”، وتخيَّل فيه الزمان لوجود التصرُّف: من كان ويكون فهو كائن ومُكوَّن.. فلما رأوا في “الكون” هذا التصرُّف، الذي يلحق الأفعال الزمانيَّة. تخيّلوا أنَّ حكمها حكم الزمان، فأدرجوا “الآن” تتمَّة للخبر وليس منه.. وعليه كان تقرير الشيخ ابن عربي حول علم “كان” أنَّ الله موجود، ولا شيء معه. أي ما ثمَّ من وجوده واجب لذاته غير الحقّ. والممكن واجب الوجود به لأنَّه مظهره، وهو ظاهر به. والعَيْن الممكنة مستورة بهذا الظاهر فيها.. فانْدَرج الممكن في واجب الوجود لذاته “عَيْنًا”، واندرج الواجب الوجود لذاته في الممكن “حُكمًا”..[م. ن- ص 50]..
القاعدة الثانية: علم البَدء: لا ينأى هذا العلم عن علم “كان” في منظومة ابن عربي، بل هو الحلقة التالية في علم التوحيد. فإذا كان علم “كان” هو علم الإقرار بالذات الأحديَّة وتنزيهها عن الفقر والإمكان، فإنَّ علم البَدء هو علم الإقرار بحاصل الكلمة الإلهيَّة “كن”. أي بالموجود البَدْئي كأول تجلٍّ إلهيٍّ في دنيا الخلق. على هذا الأساس يعرِّفه ابن عربي بأنَّه علم الفصل بين الوجودين، القديم والمُحدث. وهو علم عزيز وغير مقيَّد. كما يصرِّح ويضيف: إنَّ أقرب ما تكون العبارة عنه، أن يُقال: البَدْء افتتاح وجود الممكنات على التّتالي والتّتابُع، لكون الذات الموجدة له اقتضت ذلك من غير تقييد بزمان. فالزمان من جملة الممكنات الجسمانيَّة، وهو لا يُعقل إلَّا إرتباط ممكن بواجب لذاته. فكان في مقابلة وجود الحقِّ، أعيان ثابتة، موصوفة بالعدم أزلًا، وهو الكون، الذي لا شيء مع الله فيه، إلَّا أن وجوده أفاض على هذه الأعيان، على حسب ما اقتضته استعداداتها، فتكوَّنت لأعيانها، لا لهُ، من غير بينيَّة تُعقَل أو تتوهَّم. فوقعت في تصوُّرها “الحَيْرة” من طريقين: طريق “الكشف”، وطريق “الدليل الفكريّ”.
والنُّطق عمَّا يقتضيه الكشف، بإيضاح معناه، يتعذَّر: فإنَّ الأمر غير مُتخيَّل، فلا يُقال، ولا يدخُل في قوالب الألفاظ. وسبب عزَّة ذلك، كما يبيّن الشيخ الأكبر، يعود إلى الجهل بالسبب الأوَّل وهو “ذات الحقّ”. ولما كانت سببًا، كانت إلهًا لمألوه لها، حيث لا يعلم المألوه أنَّه مألوه. بعضهم قال: “إنَّ البدء كان عن نسبة القهر”، وقال غيرهم. “بل كان عن نسبة القدرة”.. والذي وصل إليه علمُنا من ذلك – وَوَافَقنا الأنبياء عليه – كما يضيف ابن عربي- أنَّ “البدء عن نسبة أمْر، فيه رائحة جَبْر”. إذ الخطاب لا يَقَع إلَّا على عَيْن ثابتة، معدومة، عاقلة سميعة، عالمة بما تسمع: بسَمْع ما هو سمع وجود، لا عقل وجود، ولا علم وجود. فالْتَبست، عند هذا الخطاب بوجوده. فكانت “مَظْهرًا له” من اسمه (الأول-الظاهر). وانسحبت هذه الحقيقة، على هذه الطريقة، على كلِّ عَيْن إلى ما لا يتناهى.. فإنَّ مُعطي الوجود لا يُقيّده ترتيب الممكنات، إذ النسبة منه واحدة. فالبَدْء ما زال، ولا يزال. وكلُّ شيء من الممكنات له عين الأوَّليَّة في البدء. ثُمّ إذا نُسبت الممكنات، بعضها إلى بعض، تعيَّن التقدُّم والتأخُّر، لا بالنسبة إليه سبحانه.. فوقف “علماء النَّظر” مع ترتيب الممكنات، حيث وَقَفنا نحن مع نسبتها إليه تعالى [م.ن- ص 52]..
ثمَّ ينتقل ابن عربي إلى طور متقدِّم في تعريف هذا الموجود فيقول: “إنَّ أوليَّة الحقِّ هي أوليَّة (العالم)، إذ لا أوليّة للحقِّ بغير العالم، ولا يَصحُّ نسبتها ولا نَعْته بها، وهكذا جميع النّسب الأسمائيَّة كلِّها.. فعَيْن الممكن لم تَزل، ولا تزال، على حالها من الإمكان.. والأمور لا تتغيَّر عن حقائقها، باختلاف الحكم عليها، لاختلاف النّسب. ألا ترى إلى قوله تعالى (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا) [سورة مريم، الآية 5]، وقوله تعالى (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [سورة النحل، الآية 40]، فنَفى الشّيئيَّة عنه وأثْبَتها له، والعين هي العين، لا غيرها…[ابن عربي – أجوبة ابن عربي على أسئلة الحكيم الترمذي- المصدر نفسه- ص 44].
سيكون لهاتين القاعدتين حضورٌ بيِّنٌ في مقتربات العرفان النظريِّ للمبدأ كمخلوق أوَّل. وعليه سوف نحاول في ما يلي استظهار طائفة من المقتربات تدور على الإجمال مدار التعريف بطبيعة الموجود الأوَّل، وخصوصيَّته وكيفيَّة صدوره، والمهمَّة الإلهيَّة التي أوكلت اليه. ويمكن القول أنَّ هذه المقاربات، وإن تباينت في سرديَّاتها حول ماهيَّة وهويَّة هذا المخلوق، فإنَّها تتقاطع على الجملة حول منزلته الفريدة ومكانته المفارقة في عالم الوجود.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
محمود حيدر
-
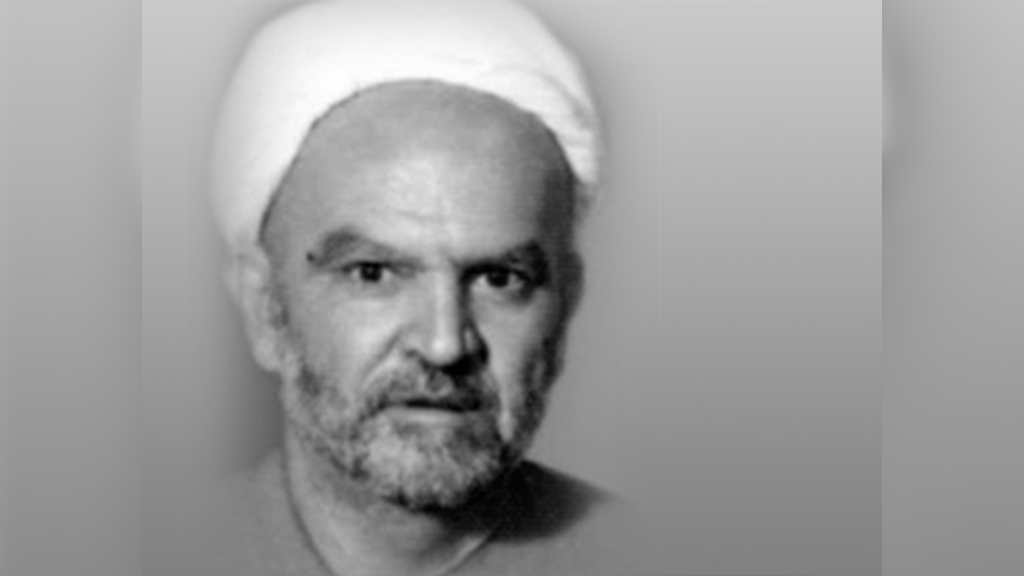 السّبّ المذموم وعواقبه
السّبّ المذموم وعواقبه
الشيخ محمد جواد مغنية
-
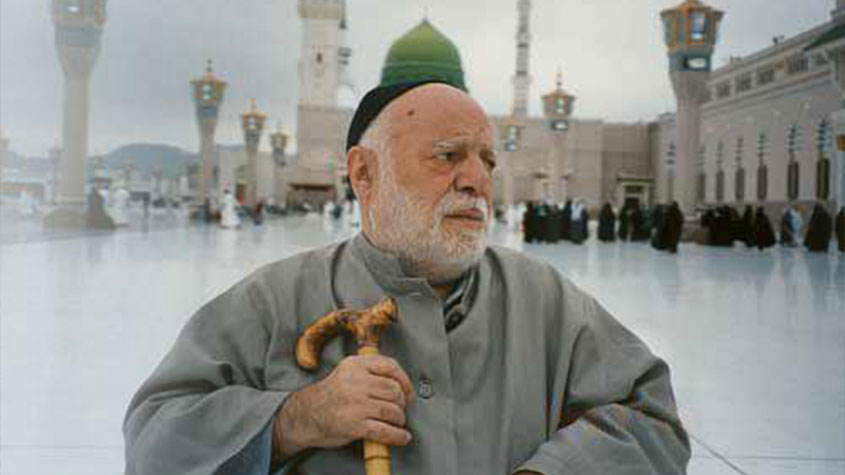 معنى (لات) في القرآن الكريم
معنى (لات) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أنواع الطوارئ
أنواع الطوارئ
الشيخ مرتضى الباشا
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
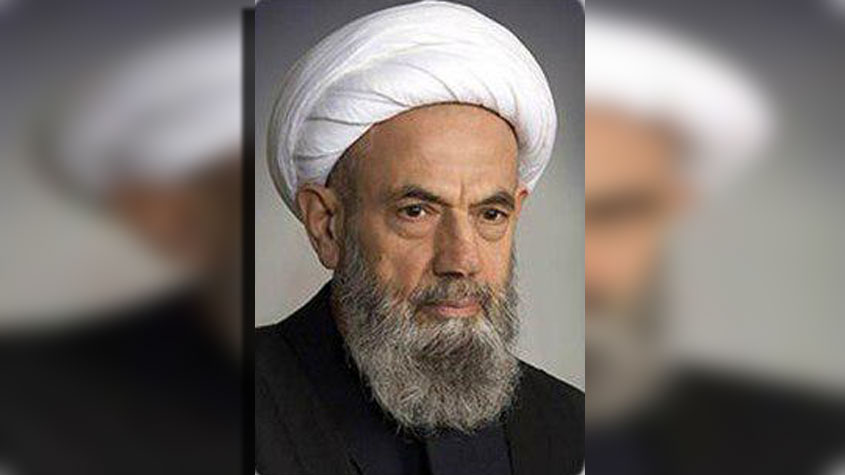 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
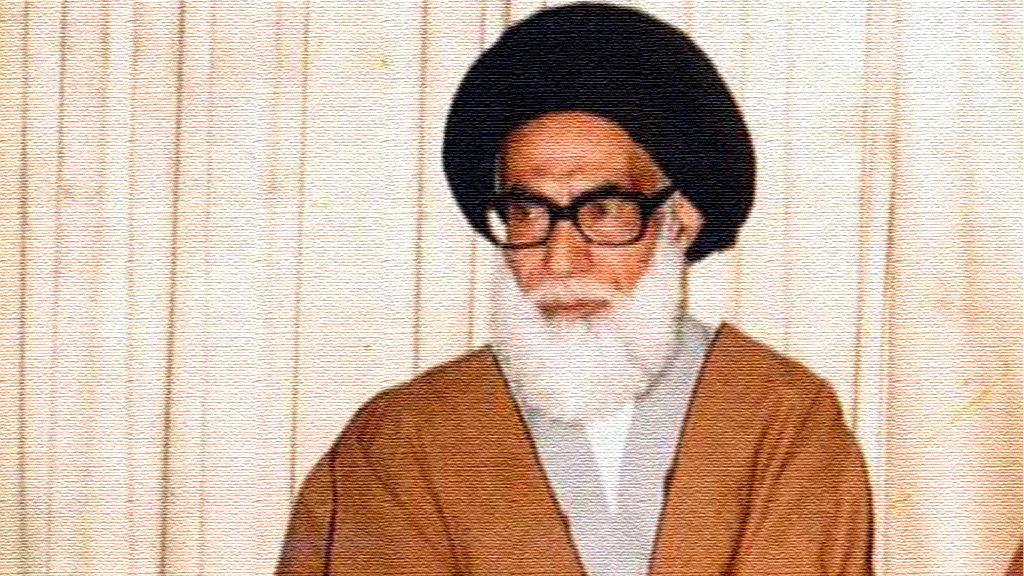 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
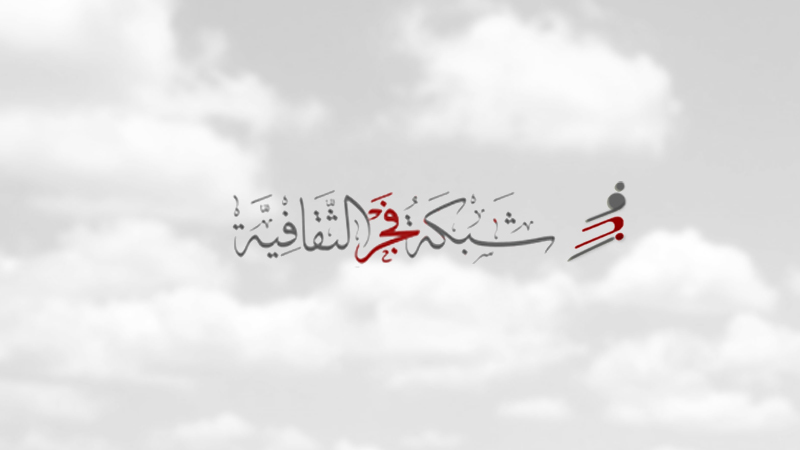 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
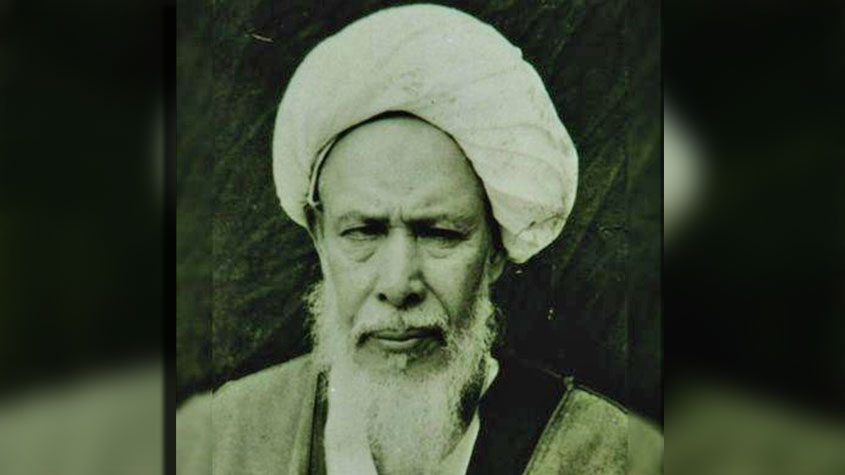 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
-

خطر الاعتياد على المعصية
-
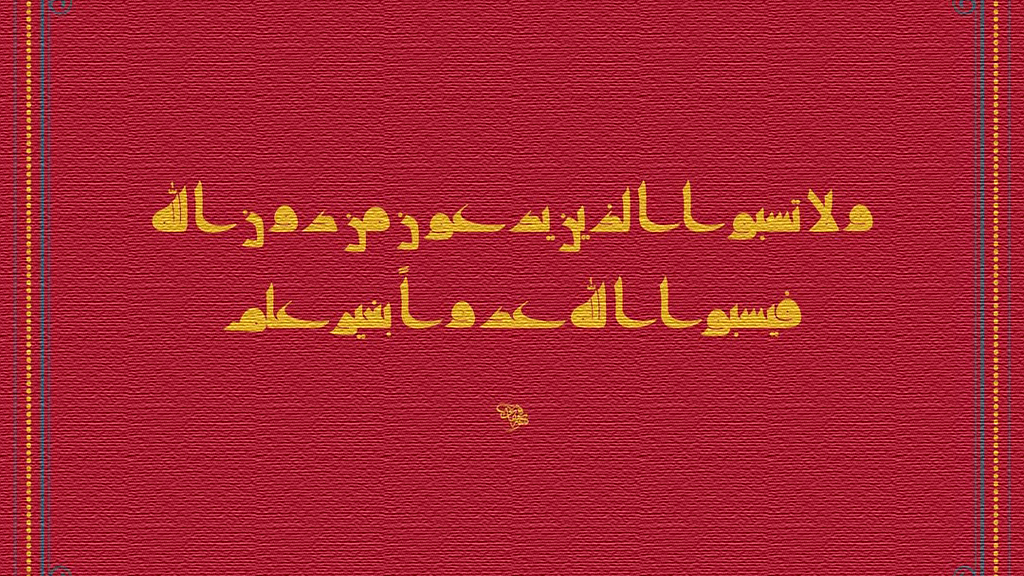
السّبّ المذموم وعواقبه
-
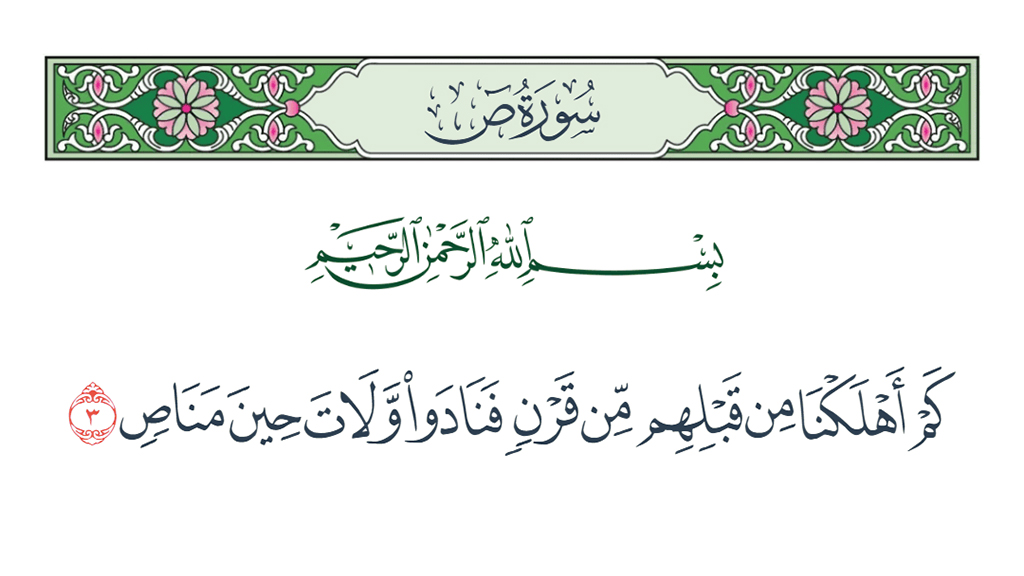
معنى (لات) في القرآن الكريم
-
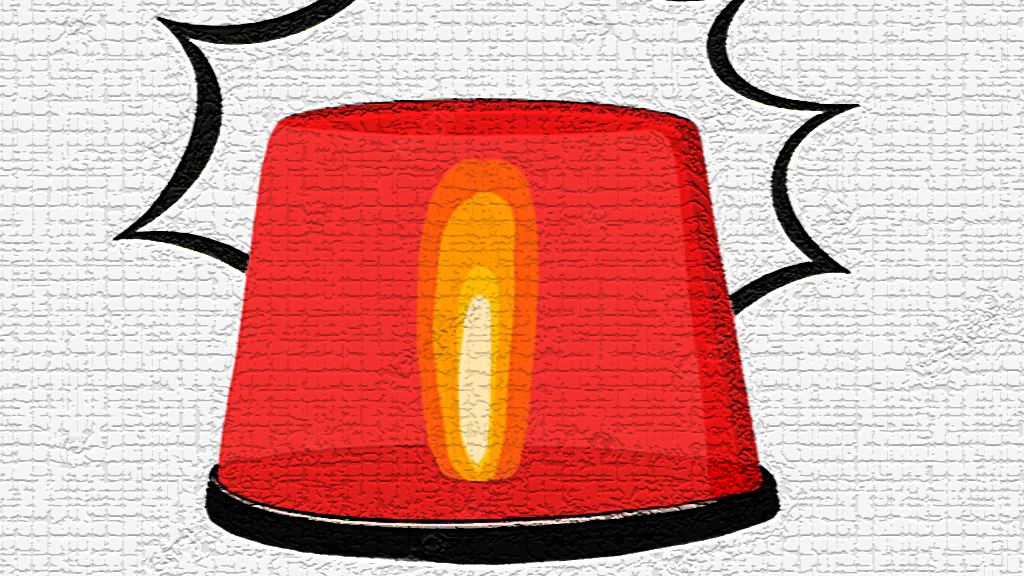
أنواع الطوارئ
-
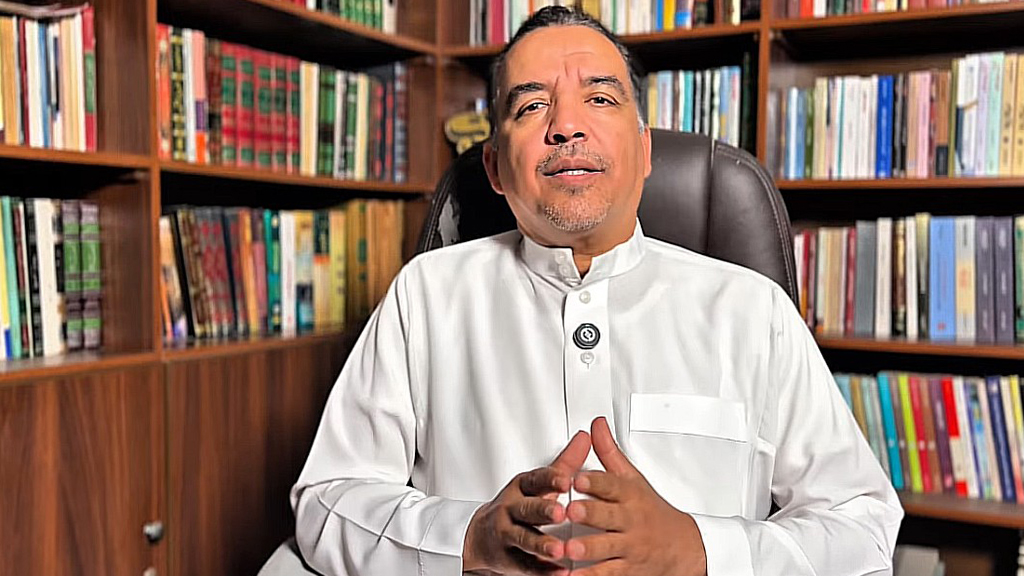
زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)
-
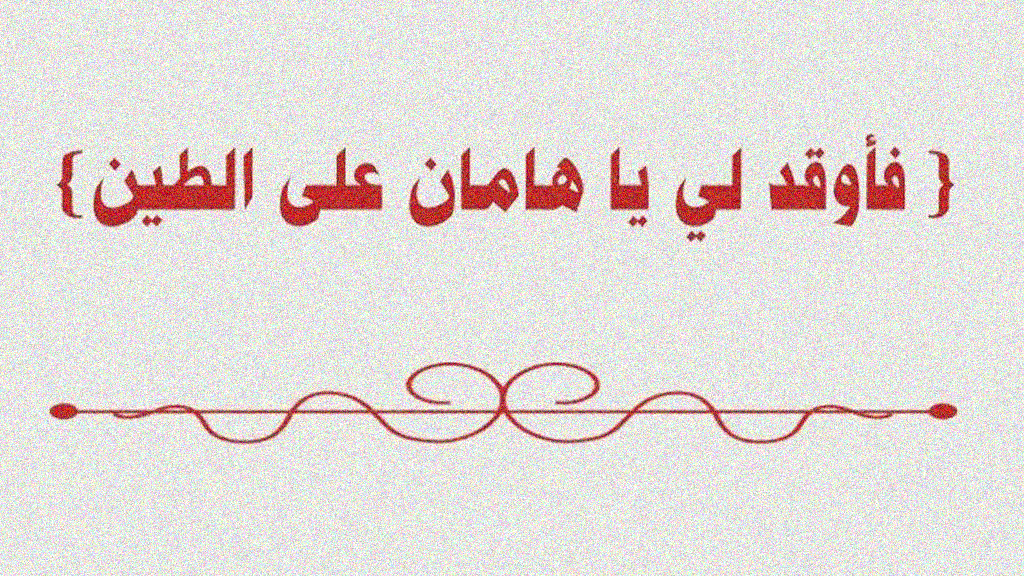
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!