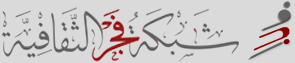علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (1)

مدخل
ليس القول على استئناف الميتافيزيقا وتجديد آفاقها، ضربًا من رغائبَ لا طائل منها. فلو لم يكن من داعٍ يستحثُّ على الاستئناف لبَطُل المدَّعى. ثمة إذاً وجوبٌ وضرورة للاستئناف. والبداهة المنطقيَّة تبيِّن أنَّ كلَّ مستأنفٍ مسبوقٌ بتوقُّف ما أو إيقاف ذي علّة: قد يكون ذلك لوهنٍ قد اعتراه، أو لِميَلٍ عن الصوابِ وَجَبَ تقويمه، أو لاعتلالٍ تكوينيٍّ أوقَفَه عن النموِّ والديمومة.
وما كان لنا أن نصوغ عنوان هذه الأملية بعبارة “التمهيد إلى علم المبدأ..” إلَّا لبسط مسافة ضروريَّة مع ما يُراد استئنافُه. فالعبور من “الماقبل الموقوف” إلى “الما بعد المستأنف” يقتضي تسويغًا معرفيًّا لمفهوم لم تكتمل أركانه بعد، ويؤملُ أن يتَّخذ مكانًا لائقاً في منفسحات التفكير. وعليه، فإنَّ دلالة “التمهيد إلى” تومئ إلى سفرٍ فكريٍّ يُفترض مكابدةُ وعثائهِ لكي نفلح بـ “المابعد”، أو أن نتقرَّب إليه على أدنى تقدير. ولأنَّ الميتافيزيقا المستأنَفة التي نسعى لتسييلها، ترنو إلى مجاوزة “الماقبل” الميتافيزيقيِّ، فهي محمولةٌ على ملء فراغ أنطو- إبستمولوجيٍّ طال أمدُ نسيانه في تاريخ الفلسفة.
أمَّا المسافة التي أنشأناها كتمهيدٍ للمابعد فقد اختزنت معاني الختام والبَدءِ معًا، أي: ختامَ ميتافيزيقا استنفدت أغراضَها، وبَدءَ أخرى تريد القيام بمهمَّة إحيائيَّة لعلم الوجود. ولكي نبيِّن أكثر، اعتمدنا الفرضيَّة التالية: تنطوي الميتافيزيقا على معضلة فهمٍ لاسمِها ونعتِها وهوّيَّتِها. ولمَّا نظر إليها الأوَّلون ولحق بهم الآخرون، قاربوها كعلمٍ يستفسرُ ما يمكثُ وراء الطبيعة لكي يتعرَّفوا على المبدأ والأصل. لكنَّ الذي رَسَخَ في واقع الأمر، أنَّ ملحمة الاستفسار والمساءلة ستدور على غير هدىً مدار الطبيعة. ثمَّ طفقت تفسِّر العالم وفق معياريَّات العقل الفيزيائيِّ ومقولاته، ثمَّ لتأتي الحصيلة المنطقيَّة أنَّ الميتافيزيقا بصيغتها الشائعة أخفقت في الإجابة عن مبتدأ الأمر، ولم تجاوز مسلَّماتها الصلبة. حتى لقد بدا أنَّ كلَّ ما اقترفته الفلسفة الأولى سحابة تاريخها المديد، أنَّها غفلت عن كُنهِ الوجود، ثمَّ سكنت إلى فتنة السؤال عن ظواهره، ولم تنفلت من سحره قطّ.
من أجل ذلك، لم تكن دعوة الميتافيزيقا البَعديَّة إلى إعادة تسييل العلم بالشيء في ذاته “النومين”، إلّا لإنشاء قولٍ فلسفيٍّ مُفارقٍ يؤسِّسُ لنظريَّة معرفة تنظِّر إلى هذا الشيء بوصفه ظهورًا واقعيًّا قابلًا للفهم. الغاية من ذلك، هي التمهيد لأفقٍ معرفيٍّ جديدٍ يستجلي المخبوء في علم الوجود، وينفتح على مسارٍ مُفارق يستظهر ما يختزنه الشيء في ذاته من وعود ميتافيزيقيَّة.
حسب الميتافيزيقا البَعديَّة [1]، ينبِّه علم النومين (النومينولوجيا) إلى وجوب تصويب خللٍ تكوينيٍّ في الاسم الأنطولوجيِّ للميتافيزيقا. فإذا كانت كلمة الما بعد (ميتا) دالَّةً على ما هو تالٍ للطبيعة أو ما فوقها، فذلك معناه أنَّ عالَم ما بعد الطبيعة هو امتدادٌ للطبيعة وموصولٌ بها بعروةٍ وثقى، ما يعني أنَّ كلَّ ما بعد الطبيعة هو واقعٌ حقيقيٌّ بمرتبةٍ وجوديَّةٍ مُفارقة، وإن تعدَّدت ظهوراته كمًّا وكيفًا. مثل هذا الخلل في الاسم الأنطولوجيِّ للميتافيزيقا سوف يؤدّي إلى صدعٍ في فقه المبدأ المؤسِّس والاستفهام عن حقيقته. وهذا ما سيكشف عن أمرٍ بديهيٍّ سها عنه القول الفلسفيُّ الإغريقيُّ ولواحقُه. فإذا كانت مهمَّة الميتافيزيقا البحث في الوجود بما هو موجود، فإنَّ مبتدأها ومنتهاها تمثَّلا بحصر معرفتها بالموجود في ظهوره العيانيِّ، وعدم الاكتراث بما هو عليه في خفائه وكُمُونه.
بصدد مشروعية الميتافيزيقا وحدودها
في البَدء، والميتافيزيقا موضع جدلٍ حول مشروعيَّتها بين كونها عقلًا وعلمًا، أو محضَ وهمٍ يتراءى في الأذهان. لم يجهر أرسطو ببيانٍ يفيد بأنَّها معرفة لا عقلانيَّة، لكنَّ نظامه الفلسفيَّ سيمتلئ بهذا الحكم حين صرَّح بأنَّ أحدًا لايعرف طبيعة ما لا يوجد، وأنَّ وجود أيِّ شيء كواقع هو مسألة برهان؛ ثمَّ ليقدِّم التجربة على الاستدلال، ولا يرتضي من الاستدلال إلَّا ما يوافق الوقائع المرئيَّة. ومع أنَّه كان مؤمنًا بأنَّ أعظم قوى العقل مستمَدَّة من شيء يقع وراء التجربة والاستيعاب العقلانيِّ، وأنَّ هذا الشيء هو فاعلٌ وأبديٌّ وسماويٌّ وخالدٌ.. سيعود القهقرى من بعد قوله هذا إلى دعوى امتناع العقل عن إدراك ما لا دليل عليه.
الَّلاحقون من حَفَدتِهِ، سيحتذون بما ذهب إليه حذو التَّبعِ عن ظهر قلب. صدَّروا من الأحكام ما يقيم الميتافيزيقا مقام معرفة سديميَّة لا تُقال لاستحالة إثباتها أو نفيها. ثمَّ ابتنوا حجَّتهم على معادلة مؤدَّاها: أنَّ الطريق الذي يقودُ المرءَ من قارَّة المعرفة العقلانيَّة إلى جزيرة الحدس معدومٌ ولا عقلانيٌّ، وأنَّ ما يقودُه من بلد المعرفة التجريبيَّة إلى بلد المعرفة الصوريَّة موجودٌ وعقلانيٌّ.. ثمَّ خلصوا إلى الاعتقاد باستحالة تسمية الحدس والإيمان الدينيِّ بـ “المعرفة” العقلانيَّة. المُحدَثون ممَّن ينتسبون إلى سلالة الإغريق جادلوا في إمكان عقلنة الميتافيزيقا أو لا إمكانها عقلًا وعلمًا. لكنَّهم سيرجعون من بعد عناء إلى الأخذ بما أخذ به الأسلاف: إنَّ الميتافيزيقا لا تُقاس لكونها غير متحيَّزة. ولمَّا كان كلُّ متحيِّز يُعرفُ عقلًا بحدود ماهيَّته وهوّيَّته، فإنَّ كلَّ ما لا يتحيَّز لا يُعقل ولا يُعرف ولا يُقال؛ وبالتالي فهو غير عقلانيّ. والنتيجة المنطقيَّة لدى هؤلاء: الميتافيزيقا غير عقلانيَّة.
ابتناءً على ما سلف، بدا أنَّ من أظهر السِّمات التي يجوز استخلاصها من اختبارات الفلسفة، قولُها أنَّ العقل قاصرٌ عن مجاوَزة دنيا المقولات العشر وأحكامها.. وأنَّ المعرفة البشريَّة لا يتيسَّر لها إدراك ما هو مخبوء وراء عالم الحسّ. والنتيجة المترتِّبة على هذا المدَّعى، هي الإعراض عن فقه الماوراء، والعزوف عن فهم كُنه الجوهر في ذاته، فضلًا عن استعصاء معرفة السرِّ الأنطولوجيِّ المنطوي فيه لغزُ إيجادِ الموجِدِ لعالَم الموجودات.
نكمل:
لمَّا أوجبت الضرورة على الفلسفة الأولى بما هي ميتافيزيقا قبْليَّة أن تبحث عن كائن يعي ويعتني بالسؤال عن ماهيَّة الموجود البَدئيِّ، وما يحويه من تكثُّر وتجدُّد وسِعة، لم تجد لهذه المنزلة غير الإنسان. بهذا يصحُّ القول أنَّ من جميل ما للفلسفة على الإنسان، أنَّها أومأت إليه أن يسأل بلا هوادة عمَّا يجهل.. وأنَّ من جميل الإنسان على الفلسفة تنصيبَها مليكة على عرش العقل. ولفرط دهشتها بما هي عليه من الانسحار بالسؤال، غَفلَت الفلسفةُ عمَّا وصفها به القدماء بأنَّها “عشق الحكمة” وحثٌّ على بلوغ كمالاتها، إلَّا لبثت دون المعشوق وغايته العظمى. حتى لقد غَلَبت عليها الظنون فأخلدت إلى أرض السؤال وأقامت فيه طويلًا.
وإذ أذعن الفلاسفة إلى “دابَّة الذهن”، وأسلموا أمرهم إلى سلطانه، أسدلوا في وجه كلِّ سائل حجابًا حالَ دون الوصول إلى اليقين ونعمائه. أمَّا حاصل هذه الوضعيَّة فهي استنزال الكائن الإنسانيِّ إلى دنياه الواطئة، وزحزحته جذريًّا من كونه مركزًا للكون إلى صاغر لقوانينه، ومصادرة قدرته على تحصيل معرفة حقيقيَّة بالوجود ومبدإه الأول. على هذا النحو، صار الاغتراب الأنطولوجيُّ متضافرًا مع الاغتراب الكوزمولوجيِّ والمعرفيّ. والمفارقة هنا أن أصبح الوجود غير معروف، أو لغزًا يتخطَّى تمكُّن العلم منه، فيما أحيلت الميتافيزيقا إلى ضربٍ من مزاعم حول تخمينات لا رخصة فيها.
المبيَّن أنَّ الفلسفة الأولى طفقت تفارق معضلتها التكوينيَّة وهي تتغيَّا الاستفهام عن مبادئ الوجود وحقيقته. لهذا راحت تستغرق في بحر خضمٍّ تتلاطم فيه أسئلة الممكنات وأعراضها. حتى أنَّ الفلسفة الحديثة – وهي في ذروة دهشتها بذاتها – لم تَبرح هذه المعضلة الموروثة. وليس هذا إلَّا لأنَّ مبدأَهَا المنبسطَ على “التغايُر الَّلامتكافئ” بين “النومِين” (الجوهر في ذاته) و”الفينومِين” (الشيء كما يظهر في العلن)، ظلَّ ملازمًا لها كما هو الحال في نشأتها الأولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- انظر دراستنا تحت عنوان “التمهيد إلى ميتافيزيقا بعديَّة”، في محور العدد الرَّابع من فصليَّة”علم المبدأ”، شتاء 2023.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (1)
التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (1)
محمود حيدر
-
 ﴿حِطَّةٌ﴾ و﴿ رَاعِنَا﴾ الأصل اللّغوي والمعنى
﴿حِطَّةٌ﴾ و﴿ رَاعِنَا﴾ الأصل اللّغوي والمعنى
الشيخ محمد صنقور
-
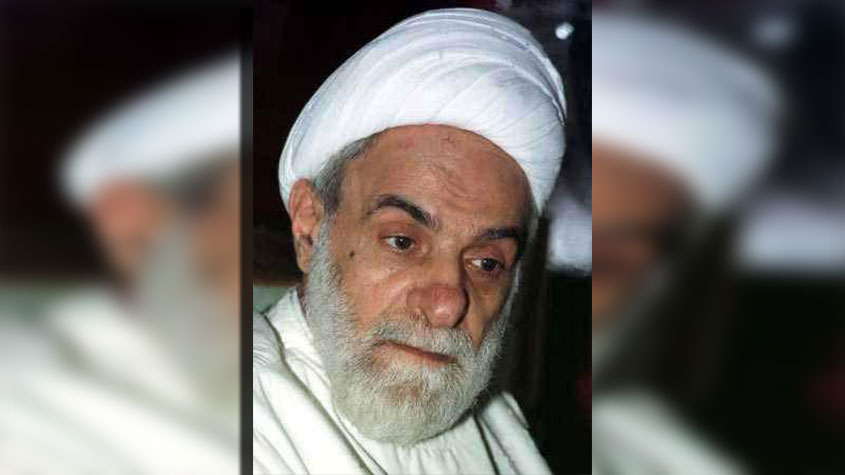 طبيعة الحكم عند الإمام علي (ع) وعلاقة الحاكم بالشّعب
طبيعة الحكم عند الإمام علي (ع) وعلاقة الحاكم بالشّعب
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
 تخفيضات الجمعة البيضاء من منظور علم النفس - كيف نقاوم إغراءاتها؟
تخفيضات الجمعة البيضاء من منظور علم النفس - كيف نقاوم إغراءاتها؟
عدنان الحاجي
-
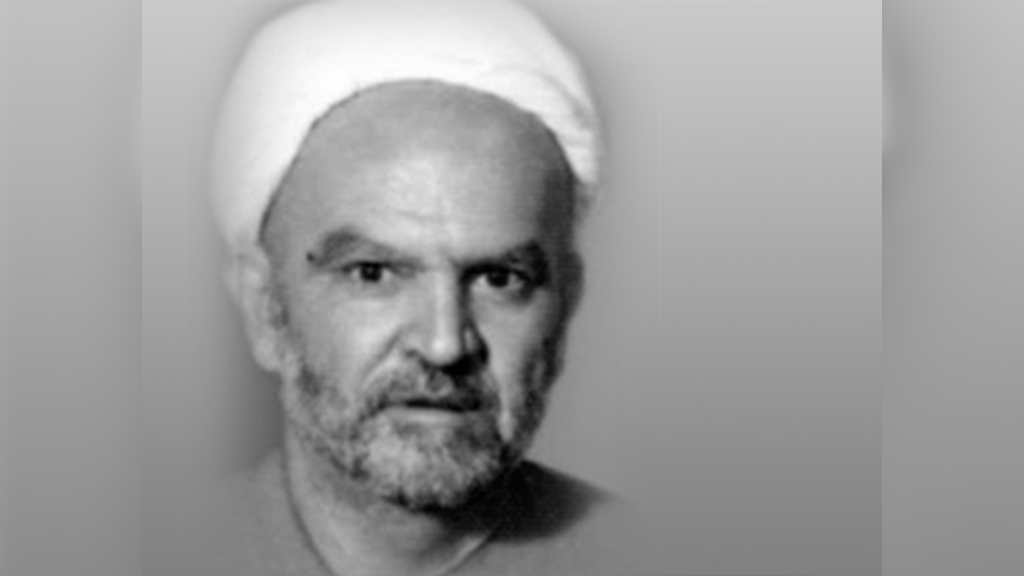 الصمت حكمة وقليل فاعله
الصمت حكمة وقليل فاعله
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 الأصول الثابتة والمتغيرة في القرآن الكريم
الأصول الثابتة والمتغيرة في القرآن الكريم
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الهداية والقدوة
الهداية والقدوة
الشيخ شفيق جرادي
-
 أعظم طريقة لنشر القيم
أعظم طريقة لنشر القيم
السيد عباس نور الدين
-
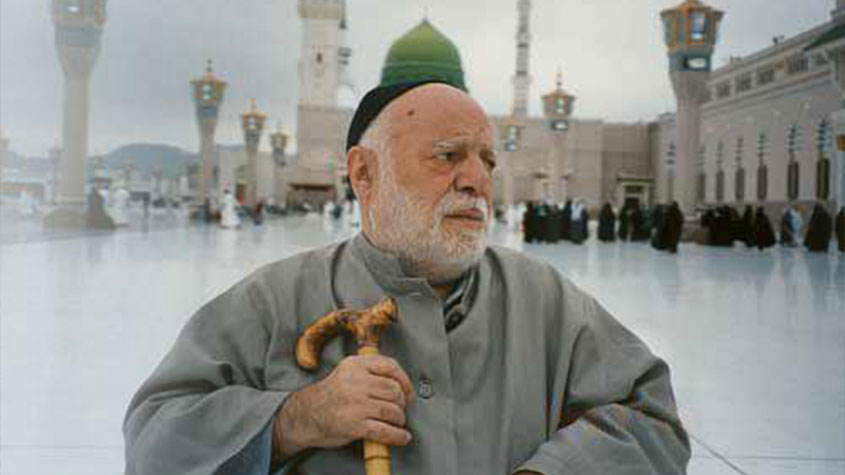 معنى (قمر) في القرآن الكريم
معنى (قمر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 ادرس خطتك قبل الانطلاق
ادرس خطتك قبل الانطلاق
عبدالعزيز آل زايد
الشعراء
-
 السيدة الزهراء: وداع في عتمة الظلمات
السيدة الزهراء: وداع في عتمة الظلمات
حسين حسن آل جامع
-
 واشٍ في صورة حفيد
واشٍ في صورة حفيد
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (1)
-

في الكفاف في الرّزق
-

﴿حِطَّةٌ﴾ و﴿ رَاعِنَا﴾ الأصل اللّغوي والمعنى
-

طبيعة الحكم عند الإمام علي (ع) وعلاقة الحاكم بالشّعب
-

تخفيضات الجمعة البيضاء من منظور علم النفس - كيف نقاوم إغراءاتها؟
-

مصر وأحداثها في عصر الظهور
-

سنّة العدل والحقّ من سنن التطور الاجتماعي في القرآن الكريم
-

منهج الزهراء عليه السلام في التربية
-
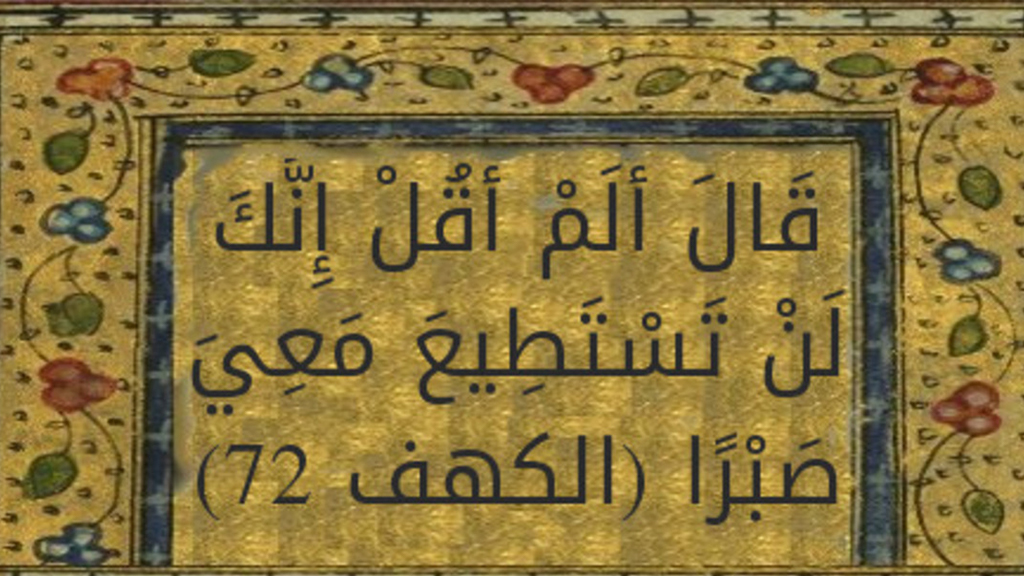
الصمت حكمة وقليل فاعله
-

الأصول الثابتة والمتغيرة في القرآن الكريم