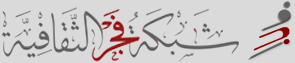علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ميتافيزيقا العلم الذكيّ (4)

ميتافيزيقا الحركة الجوهريَّة
لم تكن الفلسفة الإسلاميَّة بمنأى عن علم الطبيعة كفضاء مكوِّن لنظامها الميتافيزيقيّ. وإذا كان الفلاسفة المسلمون الأوائل كالفارابي وابن سينا قد اتَّخذوا سيريَّتهم نحو فهم الطبيعة على طريقة المشَّاء برجاء الوصول إلى «الماوراء»، فسيتخذ ملَّا صدرا الشيرازيُّ دربة مفارقة ليرسم نظرًا مجاوزًا لمنطق عمل الطبيعة عبر أطروحته في الحركة الجوهريَّة. ففي سياق استجلاء الصِّلة بين الطبيعة وما بعد الطبيعة، دأبت الحكمة المتعالية على تظهير هذا المفهوم انطلاقًا من وجهة نظر جديدة ومفارقة في عالم الميتافيزيقا قوامُها حدوث التغيُّر في مقولة الجوهر.
وبهذا الفتح المعرفيِّ سوف يجاوز صدر الدين الشيرازيُ (ملَّا صدرا) الفهم الأرسطيَّ في تفسير حركة الكون، حيث يتحوَّل الجوهر في نظامه الفلسفيِّ إلى بنية للأحداث والحركة وإلى عمليَّة للتغيُّر. ينظر ملَّا صدرا إلى الطبيعة بوصفها مبدأً للتغيُّر والثبات. وعلى أساس هذه الفرضيَّة منح مقولة الحركة استقلالًا نسبيًّا باعتبار كونها حقيقة قائمة بذاتها. إلَّا أنَّ ما يكمن وراء اعتبارات صاحب الحكمة المتعالية للتغيُّر والطبيعة هو تصوُّره للوجود ومسوِّغاته، لمَّا رأى إلى التغيُّر بوصفه نمطًا للوجود يفكِّك العالم المادّيَّ ويتجاوز الحركة الناقلة والموضعيَّة، ويؤكِّد ديناميَّة صورة العالم تبعًا لهرم الوجود وتراتبيَّته.
يفتتح ملَّا صدرا نقاشه للحركة باتِّباع مشروع الطبيعة الأرسطيَّة، فيفسِّر معنى كلمة القوَّة بطرق عدَّة. والمعنى الأكثر شيوعًا هو أنَّ القوَّة هي القدرة على إجراء أفعال بعينها، وهي في هذا المعنى إمكان يرادف القدرة، التي تجعل حركة أو فعل الأجسام الطبيعيَّة ممكنًا. وهكذا تستعمل كلُّ الموجودات التي تخضع للتغيُّر الكمّيِّ والموضعيِّ قدرة القوَّة؛ لأنَّ الأجسام الهيولانيَّة تحتاج إلى مبدأ فاعل لتحقّق قوَّتها الكامنة، وهذا يبرهن حسب ملَّا صدرا أنَّ الشيء ذاته لا يمكن أن يكون مصدرًا للتغيًّر، بل ثمَّة بالضرورة فاعل من خارجه يحثُّه على التغيُّر.
قد يتَّفق صدرا مع أرسطو وابن سينا على أنَّ هذا يعنى «أنَّ الشيء ليس له مبدأ للتغيُّر في ذاته» و«كلُّ جسم متحرِّك له محرِّك من خارج ذاته». وعليه، تقدِّم العلاقة بيـن المحـرِّك والجسم المتحرِّك تتابعًا عِلّيًّا فـي هــذا المحرِّك الـذي يحــرِّك الأشيــاء الأخرى بحركــة لا سببيَّة فحسب، بــل يتمتـَّـع بحال أنطولوجيّ. وفي هذا المجال، يستشهد صدرا بستة أنواع مختلفة من الفواعل في ما يتعلَّق بحركة الأشياء، وهي القصد والنيَّة والرضا والطبيعة والقصر والتشكُّر. وباصطلاح صدرا، كلُّ ما له قبليَّة وتزداد كثافته في التحقُّق الوجوديِّ يرجَّح أن يكون علَّة لا أثرًا، والله وحده بهذا المعنى هو ما يطلق عليه حقًّا «علة» كلِّ شيء. وعلى الشاكلة ذاتها، فإنَّ المادَّة الأولى أو الهيولى لديها على الأقلِّ قوَّة لوجود علَّة لأنَّها أضعف في التكوين الوجوديِّ بنزوع قوى نحو عدم الوجود. [الأسفار – الجزء الثالث – ص 10-13].
الجسم الطبيعيُّ في الفلسفة الصدرائيَّة مزيج مركَّب محكوم بقانون التحوُّل والتغيير المستمرِّ. كذلك الأمر في الذرَّات الكوانتوميَّة الدائمة التحوُّل والحركة على أساس الفيزياء الكوانتوميَّة. إلَّا أنَّ التغيير في الفلسفة يعني خروج الشيء من القوَّة إلى الفعل، حيث يحصل إمَّا على نحو دفعيٍّ (الكون والفساد)، وإمَّا على نحو تدريجيٍّ (الحركة). وقد عرض صدر المتألّهين نظريَّة الحركة الجوهريَّة ورفض نظريَّة الكون والفساد الأرسطيَّة؛ ليبيّن أنَّ التحوُّل في الجسم الطبيعيِّ يجري في قالب الحركة الذاتيَّة والتغيير التدريجيِّ الدائم. وهكذا يمكن توضيح تحوُّل وتغيير الذرَّات الكوانتوميَّة في فيزياء الكوانتوم، وكذلك خلق وفناء الذرَّات في نظريَّة المدارات الكوانتوميَّة على أساس «أصل عدم القاطعيَّة»، وكذلك حركة الأشياء الذاتيَّة في الحكمة المتعالية الصدرائيَّة على أساس الحركة الجوهريَّة والتغيير الدائم، لكنَّ المسألة الجديرة بالذكر هنا أنَّ هذا التغيير يترافق في الحالتين مع توارد الصور؛ وليس مع تحقُّق الوجود الفلسفيِّ وفقده، فالذرَّة في المدار الكوانتوميِّ تخضع للخلق ثمَّ الفناء.
وهذا ما شرحته الحكمة المشَّائيَّة وفق مبدأ الخلع والّلبس، انطلاقًا من فكرة الكون والفساد، بينما شرحته الحكمة المتعالية على قاعدة الّلبس بعد الّلبس، وانطلاقًا من فكرة الحركة الجوهريَّة. ممَّا لا شكَّ فيه، أنَّ الذرَّة وبعد فنائها، يجب أن ترد عليها صورة أخرى (الذرَّة الجديدة المخلوقة في المدار)؛ وإلَّا لزم أن تتحقِّق فعليَّة المادَّة من دون صورة، وهذا محال. والمسلَّم به، أنَّ توارد الصور هذا على الذرَّات، سواء كان على شاكلة الخلع والّلبس أم الّلبس بعد الّلبس، لا يحمل معنى تحقُّق الوجود وفقده بالمعنى الفلسفيّ. كما يمكن القول أنَّ أصل عدم القاطعيَّة عند هايزنبرك، هو شكل من أشكال التحوُّل والمرونة الدائمة، وبالذات لعالم الذرَّات الكوانتوميَّة.
كان ملَّا صدرا يعتقد أنَّ «الزمان» هو مقدار الحركة في الجوهر؛ أي أنَّ عالم الطبيعة في حالة تحرُّك وتجدُّد مستمرَّين، وأنَّ الزمان هو مقدار هذا التجدُّد والتغيُّر في الطبيعة، إلَّا أنَّ من جملة الإشكالات والتحدّيات المطروحة في الحكمتين المشّائيَّة والمتعالية في خصوص الحركة في الجوهر، والتي قدَّم صدر المتألّهين إجابات متعدِّدة لها، هو بحث ثبات الموضوع، والذي على أساسه رفض المشَّاؤون الحركة في الجوهر، حيث اعتبروا أنَّ ثبات الموضوع واحد من ضرورات الحركة وهو يتنافى مع الحركة الجوهريَّة.
أمَّا في الفيزياء الجديدة، فعندما تفنى الذرَّة في ميدان خاصٍّ (مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ في أحدث النظريَّات الكوانتوميَّة؛ أي نظريَّة المدارات الكوانتوميَّة، تكون الأصالة للمدار والذرَّات هي مظاهر أو تجلّيات الحالات الصادرة عن المدار، والتي هي في حالة تحوُّل وتغيير دائم من دون أن تتعرَّض للزوال)، وعندما تخلق الذرَّة [نوع الذرَّة عينها]، فهذا يشير إلى ثبات الموضوع، وهذا الذي ادَّعته الفلسفة الصدرائيَّة وأيّدته انطلاقًا من اعتبار الحركة نوع من الوجود، ومن العينيَّة بين الحركة والتحرُّك. وفي هذا الأمر، يمكن ملاحظات التطابق بين الأمرين. [إبراهيم قالين – بين الفيزياء والميتافيزياء – فصليَّة «علم المبدأ» – العدد الثاني – صيف 2022].
ثمَّة مسألة أخرى تجب الإشارة إليها، وهي أنَّ الجسم الطبيعيَّ في الفلسفة الصدرائيَّة مركَّب من القوَّة والفعل وتدلُّ القوَّة على المادَّة والفعل على الصورة؛ ولذلك، فالقوّة مرتبطة بالجسم الطبيعيّ. وفي ما يتعلّق بالذرّة الأساسيَّة، فهناك ما يشير إلى وجود ما هو بالقوَّة، كما يقول هايزنبرك: “هناك إمكان للموجوديّة أو ميل نحو الموجوديَّة، وتدلُّ هذه الجملة على أنَّ الذرّات الأساسيَّة هي حالة المادَّة التي هي بالقوَّة وليست المادَّة بالفعل، وتحصل المادَّة بالفعل من خلال اتِّصال هذه الذرَّات بعضها ببعض.
كما تجدر الإشارة إلى أنَّ الحركة في الحكمة المتعالية هي عبارة عن الخروج التدريجيِّ من القوَّة إلى الفعل، ومن النقص إلى الكمال. ذاك يعني أنَّ النقص والكمال هما صفتان للشيء المتحرِّك في طول الحركة؛ أي أنَّ الحركة الجوهريّة في الفلسفة الصدرائيّة تتحقّق على أساس استكمال مادَّة الصورة، أمَّا في نظريَّة خلق وفناء الذرَّات الأساسيَّة، والتي يبدو في الظاهر أنَّها تتطابق مع نظريَّة الكون والفساد المشَّائيَّة، فمن غير الممكن الحديث بوضوح عن هذا البُعد الاستكماليّ، علمًا أنَّ المدار يتعرَّض باستمرار لحال هبوط وصعود وتحوُّل دائم، وبهذا يمكن الحديث عن هذه المقارنة الاستكماليَّة.
ومن البائن أنَّ توارد الصور المتقدِّم الذكر في خصوص الذرَّات الأساسيَّة، هو ضربٌ من التكامل، وهذا ما يجعل من المقارنة بينها وبين الحكمة المتعالية أكثر وضوحًا. ومع التدقيق والتعمُّق، ندرك أنَّ نظريَّة الحركة الذاتيّة والتكامليَّة للجسم الطبيعيِّ، تتّضح من خلال فرض وجود مادَّة أولى هي بالقوَّة المحضة ولا فعليَّة لها سوى كونها بالقوَّة؛ وإذا نظرنا إلى المادَّة الأولى للذرَّات الأساسيَّة من ناحية كونها عين المدارات الكوانتوميَّة، فللمدارات هذه فعليّة، وبالتالي هي ذات صور. وعليه، وَجَب البحث عن الجسم الطبيعيِّ ومادَّته الأولى في أمر آخر في عالم الذرَّات الكوانتوميَّة. يبدو أنَّ المفيد هنا هو التأمُّل الميتافيزيقيُّ لا الاكتفاء بالاختبارات التجريبيَّة، إذ ليس ثمَّة أيُّ مختبر بإمكانه إثبات وجود مادَّة لا أثر لها على الإطلاق.
لنا ـ في الختام ـ أن نتساءل مجدَّدًا حول جدوى ومشروعية ما نحا إليه العقل الفلسفي الحديث مع هيوم وكانط نحو حجب الثّقة عن الشرعيَّة العقليَّة للمعرفة الميتافيزيقيَّة. ثمَّ ليمتدَّ التساؤل عمَّا إذا كان العلم الذكيُّ هو الباب الذي سينفتح معه أفق التأسيس المتجدِّد لتفلسُف ينعطف فيه العقل إلى طوره الامتدادي، ويرى إلى الفيزياء الذكيّة كتمهيد ضروريٍّ لاستبصار ما وراءها من حقائق ميتافيزيقية.
ولأنَّ العلم الفائق الذكاء هو سليلُ السيرورة المنطقيَّة لما سُمِّي «الحقيقة العلميَّة»، فإنَّه – في ماهيَّته وهوّيَّته وظهوره، وتبعًا للامتداد الَّلامتناهي لنشاط العقل الإنسانيِّ – يُعدُّ طفرة طبيعيَّة. بالتالي فهو يترجم بعضًا يسيرًا ممَّا يمكن أن يفلح به العقل حين تتوسَّع آفاقه ويمضي بعيدًا في استكشاف الكون واستكناه حقائقه ومجهولاته.
لا دهشة إذن، في ما يرسلُه به العلم الذكي من علامات مبهرة. ربما يكون الإندهاش الأعظم من ذاك الذي ينطوي عليه العقل البشري من امتدادات هائلة، وفي قدرته على الكشف عن أسرار الكينونة وسبر غور مجهولاتها. هنالك، على وجه الحقيقة، يكمن السرُّ الذي منه سيبلغ العلم الذكيُّ مكانة لا قِبَل له بها، وفقًا لمبدأٍ واعٍ لكلِّ موجود حظٌّ منه أنَّى كان جنسه أو نوعه أو فصيلته.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
محمود حيدر
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
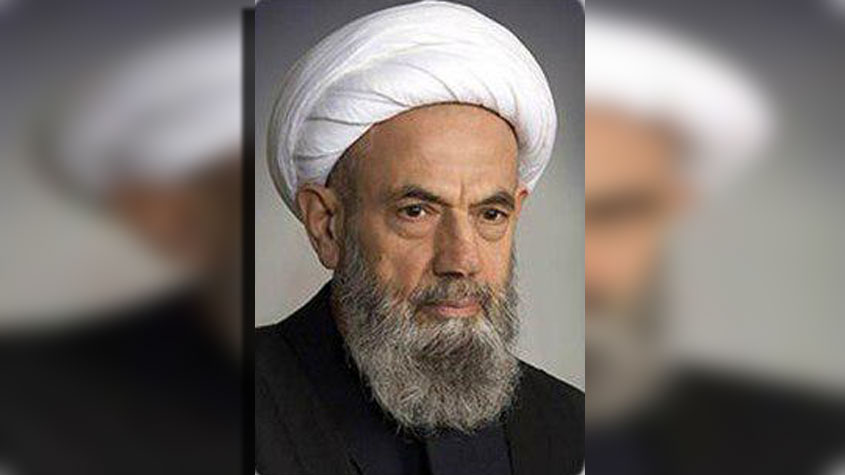 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
الشيخ مرتضى الباشا
-
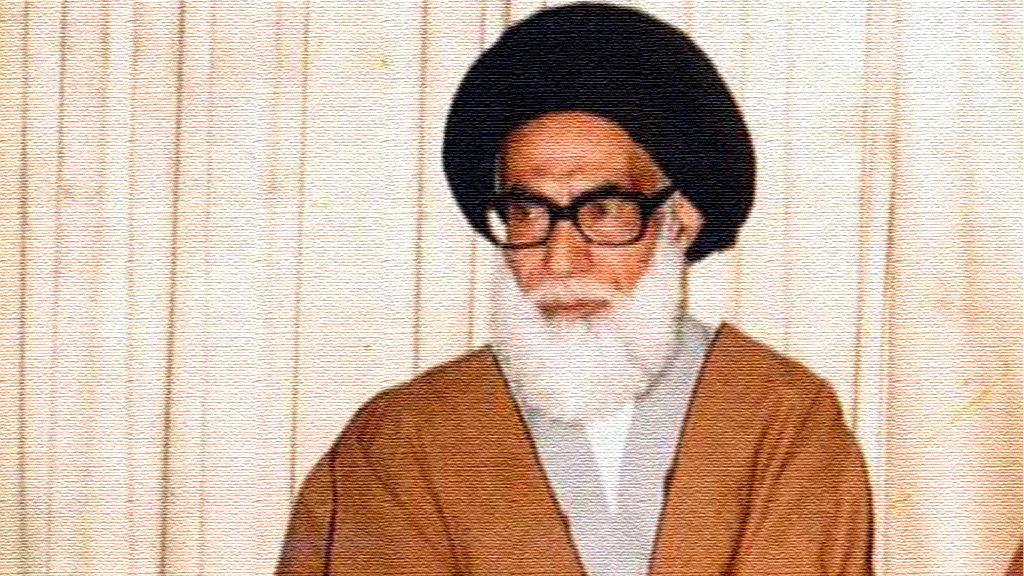 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
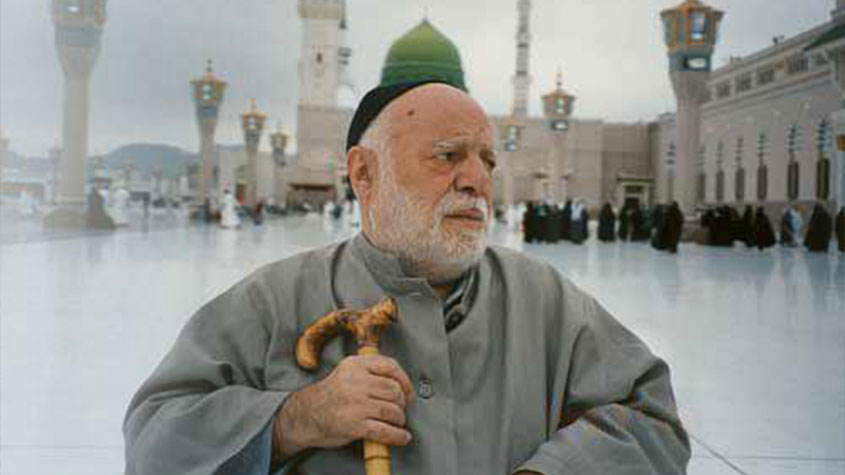 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
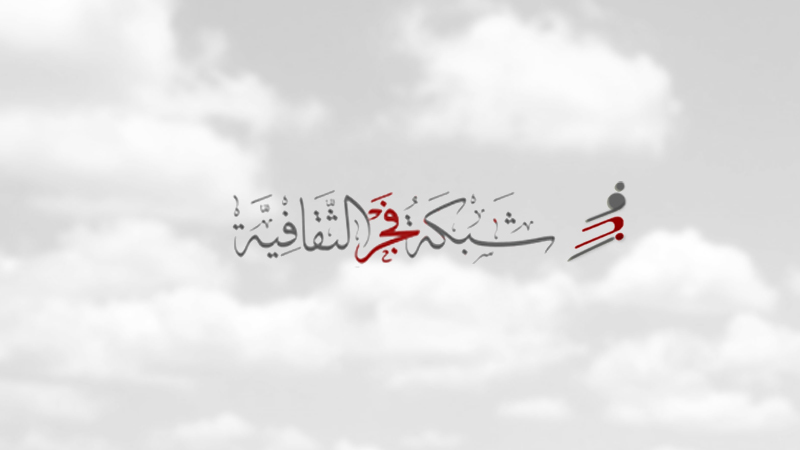 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
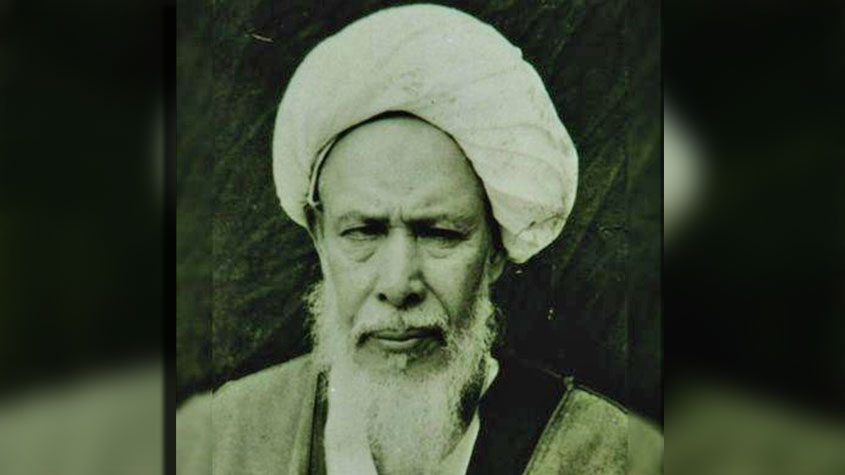 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)
-
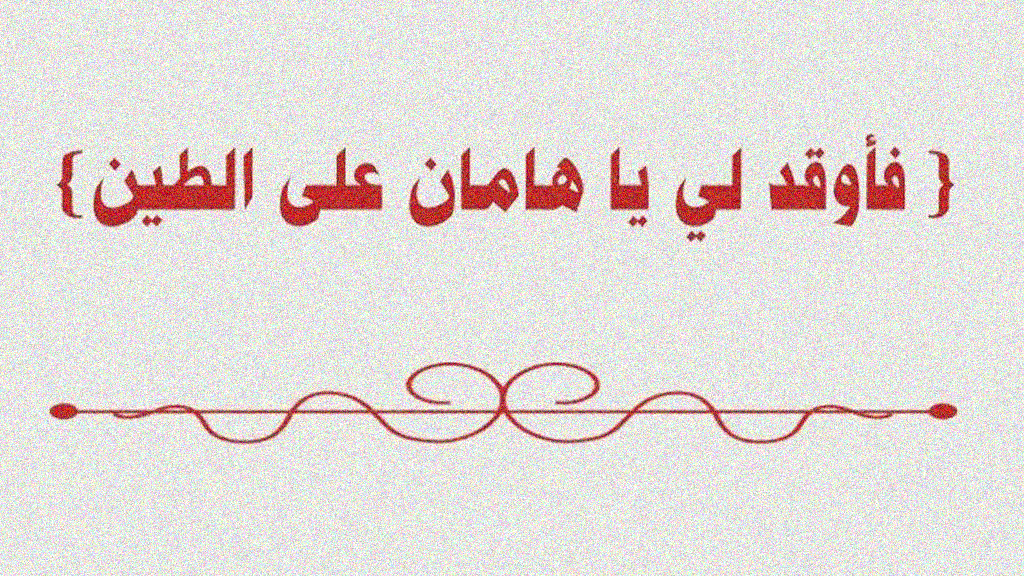
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة
-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
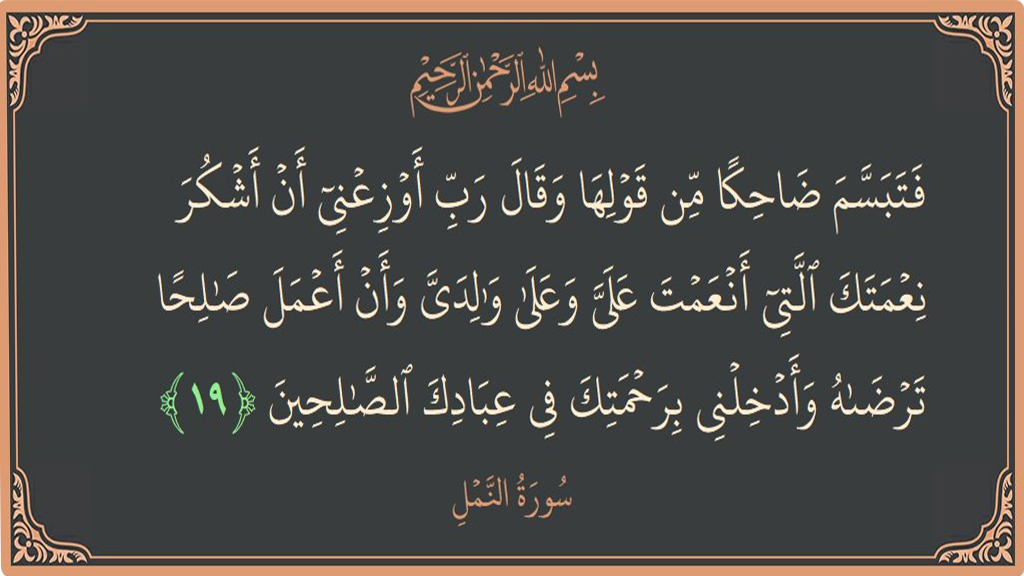
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)