علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (1)

ملخَّص
يقصد هذا البحث تظهير عقيدة الحرب في المنظومة الَّلاهوتية التي قامت عليها الأطروحة الأميركية منذ تأسيسها وإلى يومنا الحالي. ولأجل هذا المقصد سنعمل على بيان العناصر الأساسية للَّاهوت الحرب انطلاقاً مما أظهرته التجربة التاريخية، ووفقاً للفلسفة السياسية التي انتظمت هذه التجربة.
بحسب الفرضية التي تأسس عليها هذا البحث، فإن الَّلاهوت السياسي الأميركي قد انبنى على إدراك مخصوص لمفهوم السيادة على الأرض التي سكنها المهاجرون الإنكليز قبل أكثر من خمسماية عام. ومثل هذا الإدراك يستحيل بلوغ معناه ودوافعه من دون معاينة دقيقة للكيفيات التي خيضت في ضوئها حروب أميركا على العالم. وعليه، سوف يتبيَّن لنا أن مفهوم الأمن القومي في الفلسفة السياسية الأميركيَّة اتخذ سياقًا مغايرًا لما ألِفَتْه أوروبا وهي تمضي إلى تشييد هياكل الدولة القومية المركزية في فضائها الحضاري. فالسيادة التي اختبرتها السيرة التاريخية الأميركيَّة هي من الطراز الذي لا يُعرف له حدود. أي أنها سيادة تجتاز الجغرافيات الوطنية التقليدية لتمضي في الحروب على الغير باعتبارها جزءاً متصلاً بسيادتها وأمنها القومي.
مقدمة
يجزم الباحثون في منطق التجربة الأميركية، بأن ما كان مجرد حلم في أوروبا صار إمكاناً واقعياً سارياً في الزمن بالنسبة إلى أميركا: لقد جُعلت هذه الأخيرة إقليماً فُتح أمام رغبة الإنسانية بالتطور والتحديث على حدِّ زعم «فلاسفتها». بحيث أمكنها، كما يقول هؤلاء، أن تتلافى ما يسمونه بـ «أزمة العلاقة بين القوة والقدر الذي أوقع في فخه الثورة الإنسانوية الديموقراطية في أوروبا وأضلَّها». وفي نطاق هذا الطور الأول نفسه، أخذ مبدأ جديد للسيادة يعلن عن نفسه بالطريقة التالية: إن الحرية صارت سائدة، والسيادة حُدِّدت بوصفها ديموقراطية على نحــو جذري داخل سيرورة توسع مفتوح ومستمر.
غيــر أن عدم الاعتـراف بحدود نهائية، والحرص على إبقاء الحدود مفتوحة، وفهم الحدود بوصفها حالة لا تعدو أن تكون تخوماً أو عتبات علينا كسرها وتخطيها، إنما هي علامات دلَّت على أن أميركا ظاهرة هي أشبه ببرنامج مبدئي لملاقاة الآخرين، ودحرهم إلى ما لا نهاية. وأكثر من ذلك، فإن هذا «البرنامج المبدئي»، حسب القائلين به، كينونة استثنائية تستمد ماهيتها من إرادة حرب، أو من أفعال حربية أصلية في فهمها لنفسها. من هناـ فإن قصة أميركا في هذا التعريف، هي قصة حرية تصنع بنفسها حدودها، وتصر على الاستقلال بوصفه فتحاً مستمراً للحدود. ولذلك فمعنى أميركا لا ينفصل البتة عمَّا يسميه الباحثان الغربيان مايكل هاردت وأنطونيو نيغري بـ «طوباوية الفضاءات المفتوحة»[1].
وعلى السياق التحليلي للمثال الذي يقدِّمه الباحثان المذكوران سوف تتمظهر ثلاث سمات مخصوصة:
السمة الأولى: تطرح فكرة محايثة للسلطة، في مقابل الطابع المفارق للسيادة الأوروبية الحديثة. وفكرة كهذه، تعني أن السلطة مؤسسة على فكرة الإنتاجية. ما يعني أن الجمهور الذي يؤلف المجتمع هو جمهور منتج. ولذلك، فالسيادة بمدلولها الأميركي لا تتمثل في ضبط الجمهور، بل تتبلور بوصفها نتيجة تضافر الطاقات المنتجة للجمهور. وعلى هذا، فإن مبدأ الإنتاج المؤسس، إنما يقود إلى – أو يُفسَّر بواسطة – عملية تفكُّر ذاتي.
السمة الثانية: في خضم تشكيل هذا النوع السيادي على أساس المحايثة للسلطة، تنبثق أيضاً تجربة التناهي الناتج عن الطبيعة النزاعية والمتعددة للجمهور نفسه. وبذلك يبدو أن المبدأ الجديد للسيادة يُنتج حدّه الداخلي الخاص. سوى أنه بعدما أقرّ بحدوده الداخلية، يروح المفهوم الأميركي للسيادة ينفتح بقوة عجيبة نحو الخارج، حتى لكأنه يريد أن يقضي على فكرة المراقبة، وعلى لحظة التفكُّر في دستوره الخاص.
السمة الثالثة: النزوع الأميركي نحو مشروع مفتوح وتوسعي، مشروع يعمل فوق ملعب بلا حدود[2].
إن هذه الرؤية المفارقة للنموذج السيادي الأميركي، سوف تسهم في رسم اللوحة الإجمالية لذلك الطراز الفريد من مفاهيم السيادة الحديثة. بل أكثر من هذا، ستمنح للمكان الذي حلَّت فيه الولايات المتحدة فلسفته الخاصة. وهي فلسفة آيلة وفقاً لسيريّتها التاريخية إلى إنجاز ما سمي بـ «السيادة ذات اللون الأمبراطوري الممتد على مساحة العالم كله». وهذا ما يُلاحظ عندما يشار إلى الأطوار الأربعة التي عَبَرَتْها أميركا منذ تأسيسها وحتى أيامنا. وهي:
الطور الأول: الذي يبدأ من إعلان الاستقلال حتى الحرب الأهلية.
الطور الثاني: الممتد من أمبريالية روزفلت إلى إصلاحية ولسون الأممية.
الطور الثالث: من فترة نيوديل (New Deal) أو الصفقة الجديدة، إلى الحرب الباردة.
الطور الرابع والأخير: وهو الذي دشَّنته الحركات الاجتماعية في الستينيات من القرن العشرين، واستمر حتى تفكك الكتلة الشيوعية.
على أن ما يهمنا هنا في معرض هذا التحقيب هو أن كل الأطوار المذكورة من التاريخ الدستوري للولايات المتحدة، إنما يخصص مرحلة نحو تحقيق السيادة الأمبراطورية (…) لكن الدلالة الأعمق في هذه الرحلة سوف نجدها في النتائج الخطيرة لهذا التصور: حيث تؤدي فكرة أن البوتقة الأميركية هي مصهر تهجين للأعراق المختلفة، إلى «تدمير الفكرة المتعالية للأمة، والعمل على إعادة بناء الفضاء العمومي على أساس الهجرة الحرة للجماهير[3].
لاهوت الشر أو الفوضى الخلَّاقة
من الحلقات الأكثر مدعاة للسجال في هذه الاستراتيجية، وهي تلك التي شاع الكلام عليها بما سُمِّي بـ ”نظرية الفوضى الخلاَّقة”. المعروف عن هذه النظرية أنها وجدت دينامياتها الفعلية بعد زلزال الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001. وهي تقوم على فلسفة سياسية تفترض وجود خطر داهم من عدو مجهول يتهدد الأمن القومي الأميركي في كل لحظة. كما تقوم على افتراض ألاَّ يكون التهديد بالضرورة، حاصلاً بالفعل من دولة أو من منظمة إرهابية لكي تخاض ضده الحرب الوقائية، وإنما يكفي أن يتم تصوُّره من جانب مراكز التخطيط الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون للمبادرة إلى تلك الحرب.
ولكي تأخذ فلسفة الفوضى مسارها التطبيقي، عكف كثيرون من منظِّري ومفكِّري المحافظين الجدد في بداية الألفية الثالثة على وضع منظومة متكاملة لتبرير الحروب. ولعلَّ نظرية “الفوضى الخلاَّقة” التي شكَّلت أحد أهم وأبرز منجزات هؤلاء، إنما تعني في حقيقتها السعي الاستباقي نحو تفكيك كل المواقع والجغرافيات المفترض أنها تشكِّل مصادر تهديد لأمن ومصالح أميركا في العالم.
ولئن كانت نظرية الفوضى الخلاَّقة تتأسس نظرياً على ثنائية التفكيك والتركيب، فذلك يعني أن الفكر الاستراتيجي الأميركي بصيغته المعاصرة لم يعد لديه اليقين إلاَّ بعالم تكون الفوضى فيه سبيلاً لإعادة تشكيله وفق مهمة أميركا في بناء العالم الجديد.
كيف ظهرت هذه النظرية في سياق التحقيق التاريخي لنظريات الهيمنة داخل الفضاء الاجمالي للفلسفة السياسية والأمنية لأميركا؟
الأصلان الَّلاهوتي والفلسفي للأطروحة
يزخر الأدب السياسي الأميركي بمخزون هائل من المدوّنات التي يجري توظيفها لتفعيل لاهوت القوة والسيطرة وتمجيد الذات. نشير في هذا الصدد إلى ما ذكره الروائي الأميركي هرمان ملفيل حول وجوب تقديس الدم الأميركي وتحويله إلى ميتافيزيقا سياسية تلتهم تاريخ العالم بحروبها المفتوحة.
يقول ملفيل: “لا نستطيع إراقة قطرة واحدة من الدم الأميركي، من دون أن يراق دمُ العالم كله. دمُنا نحن أشبه بطوفان الأمازون. إنه مؤلف من مئات التيارات النبيلة المترافدة في مجرى واحد.. نحن لسنا أمة، بمقدار ما نحن عالم. فما لم نكن قادرين على أن نزعم أن العالم كله هو لأبينا وسيدنا، مثل مُلك إبراهيم، يبقى نَسَبُنا ضائعاً في الأبوة الكونية الشاملة”…
طبقاً لهذه الذهنية الاستعلائية تتكئ الأيديولوجيا الأميركية عبر الزمن. وعليها ستخاض حروب التدخلات في العالم.. من ضم فلوريدا العام 1819، مروراً بحرب الباسيفيكي التي انتهت بكارثة القصف الذري على هيروشيما وناكازاكي العام 1945، وصولاً إلى احتلال العراق، وتعميم فوضى لا قرار لها مع بداية القرن الحادي والعشرين.
نسعى هنا إلى تناول نظرية “الفوضى الخلاقة” على قاعدة ما تستمده من اللّاهوت الديني ذي المصادر الإنجيلية ـ التوراتية المشتركة. وكذلك مما تمنحه لها الفلسفة السياسية للحداثة وما بعدها، من تسديد وتبرير.
ترتبط نظرية ”الفوضى البناءة” من وجه أساسي بفرضية تقوم على استحالة السلام في الوضع العالمي الجديد. فلئن كانت ثنائية القطبية قد حكمت النـزاعات الدولية بنوع من السلام السلبي، المحكوم بدوره بما يسمى بـ ”توازن الخوف أو الرعب”، فسيكون من شأن الأحادية جعل هذا ”السلام السلبي” أمراً شبه مستحيل. كان واضحاً أن الولايات المتحدة لم تكن تشعر بالرضى وهي تتولى مهمتها العالمية. فالنصر الذي تحقّق لها باضمحلال العدو الشيوعي السوفياتي، سيلقي بها في مواجهة مع ذات قلقة وعدو مجهول.
يبيّن “ريتشارد رورتي”، الفيلسوف الأميركي المعاصر، في زحام السجال حول المهمة الأميركية، أن “فن تكوين الحقائق أهم من امتلاك الحقائق”… لكن سيأتي من يأخذ بمقالة رورتي أخذ اليقين، ليجعل من الفوضى المبثوثة في عوالم ما بعد الحرب الباردة، فنّاً لتكوين الحقائق، والسياسات، وأنظمة القيم.
هذه الأطروحة الفلسفية ستمضي بيُسر إلى حقول التوظيف السياسي. إذ على الولايات المتحدة حتى تستأنف الحفر في مسار الزمن الجديد أن تتصرف كما لو أنها تبدأ من نقطة الصفر. فلم تعد المهمة بعد خرافة ”نهاية التاريخ” مركوزة في امتلاك الحقائق عن العالم. فالتاريخ العالمي كله، بحسب العقيدة الأميركية، صار طيّ الأرشيف الإجمالي لمؤسسة الأمن القومي. وغدا من واجب المكلّفين الجدد، صناعة تاريخ آخر للعالم، بعدما بلغت أميركا ذروة ادعاء امتلاك الحقيقة والقدرة على تشكيل حقائقها.
وما من شك، أن هذا التشريع الفلسفي ما فتئ حتى أخذ سبيله إلى حقول التطبيق، ثم امتدّ بوتائر غير مسبوقة إلى فضاءات جيو ـ استراتيجية بعيدة المدى، غير أن الولايات المتحدة وهي تمارس عملية السيطرة على بؤر الممانعة في العالم، ستأخذ بما رأت إليه على أنه “الصراط السويّ” لإنجاز أهدافها. الأمر الذي أدى بالمبدأ التقليدي المعروف “الحرب من أجل السلام” إلى “الحرب من أجل الحرب”. بدت هذه النتيجة مخالفة لأبسط قواعد وبديهيات الغاية من الحروب. لقد كان الحال في ما مضى يقوم على حقيقة، أنه لبلوغ السلام، يجب السيطرة على مسارات الحرب. وكان هذا يتطلب جهداً محسوباً، وعلى الأخص لجهة معرفة المحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، التي تدفع لنشوب الحرب. ولم يسبق أن تمَّ الفصل بين الحرب والسلام. ذلك أن جميع الحروب تهدف بالمبدأ إلى بلوغ السلام، حتى لو راح البعض في النهاية يدعوه نصراً والبعض الآخر يخلع عليه صفة الهزيمة.
إن هذا، هو الفهم البدئي الذي دعا القديس أوغسطينوس ليقول: “إن السلام أهم من الحرب، لأننا لا نصنع السلام لنصل إلى الحرب، وإنما نصنع الحرب لنصل إلى السلام”. وهذا يعني أن الحرب محكومة بمفهوم السلام، وهو الذي يضع حداً لها. لقد كانت القاعدة على هذا النحو في الماضي، إلا أنها أوشكت اليوم أن تتغير تحت أبصارنا ـ كما يقول المفكر الفرنسي آلان جوكس ـ بمعنى آخر بات لدينا انطباع بأن الناس يقومون بالحرب من أجل الحرب، وأنهم يوقدون نارها ليس من أجل الوصول إلى السلام، بل من أجل الوصول إلى هيمنة قمعية ثابتة[4].
لم يكن الفكر الاستراتيجي الأميركي بمنأى عن النظر إلى الحرب كغاية بذاتها. فالأصالة بالنسبة إلى هذا الفكر هي للحرب، وأما السلام، فهو أمر عارض، وحضوره في العلاقات الأممية إنما هو بقدر ما يقترب من كونه عاملاً مكمّلاً لمصالح الأمة الأميركية العليا. ولكي ينشئ حجته الفلسفية على وجوبية الحرب كمدخل يدعوه إلى ”العوالم الفضلى“، وحّد الفكر الأميركي بين أميركا والعالم، بحيث صيغت المعادلة على نحو ما وضعه الباحثان البريطانيان ضياء الدين سارادار وميريل وين ديفيس: “أميركا هي العالم، والعالم هو أميركا”. وغالباً ما يستعيد زعماء البيت الأبيض صدى الكلمات المأثورة التي أطلقها القطب الإعلامي الشهير هنري لوس في شباط/ فبراير 1931، أي قبل عشر سنوات من دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية: “إن الأميركيين فشلوا طوال العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين في التنبّه إلى مدى سيطرة بلدهم على مصير العالم، وهذا ما جعل المسار التاريخي للبشرية يأخذ منعطفاً بائساً”…
تجري هذه الكلمات مجرى السياق الأيديولوجي نفسه، الذي تراكم على مدى قرون في الوعي الأميركي. فإذا كانت أيديولوجيا الفتوحات الأوروبية الاستعمارية في القرن التاسع عشر، تحرص على توصيل “رسالة الرجل الأبيض”، فإن العنوان الذي سيرفعه اليمين الأميركي الجديد الآن هو تعميم المثال الأميركي. وذلك تعبيراً عن إيمان راسخ هو بمثابة “القدر البيّن للشعب الأميركي” الذي يعني أن أميركا قبل أن تكون دولة أو قوة عظمى، هي فكرة رسالة عظيمة وحلم جميل حافل بالوعود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]– M. Hard/A. Negri, Empire (paris: Exils Editeur, 2000 PP. 215-216).
[2] – Ibid. P 210-211.
[3] – Ibid. P. 217.
[4] – آلان جوكس، من حوار أجرته معه مجلة “مدارات غربية” العدد الأول التجريبي، بيروت، أيار/مايو 2004.
[5] – روبن دراي، الجذر الديني الفلسفي لليبرالية الجديدة، راجع “مدارات غربية” العدد الثالث/ أيلول/ سبتمبر – تشرين الأول/أوكتوبر 2004 المقال فصل من كتاب صدر في بوينس آيرس العام 1994، تعريب د. جاد مقدسي.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الأساس العلمي لوجود المحلات التجارية المتنافسة قريبة من بعضها
الأساس العلمي لوجود المحلات التجارية المتنافسة قريبة من بعضها
عدنان الحاجي
-
 التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (2)
التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (2)
محمود حيدر
-
 ثوراتٌ تمهيديّة للظهور المبارك
ثوراتٌ تمهيديّة للظهور المبارك
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 وَلَوْ أَنَّهُمْ!!
وَلَوْ أَنَّهُمْ!!
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى}
{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى}
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (كلح) في القرآن الكريم
معنى (كلح) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 الحكم أمانة
الحكم أمانة
الشيخ جعفر السبحاني
-
 حجج منكري إعجاز الرّسول (ص)
حجج منكري إعجاز الرّسول (ص)
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الغضب نار تأكل صاحبه
الغضب نار تأكل صاحبه
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 حروب عليٍّ (ع) كانت بأمر الرسول (ص) (2)
حروب عليٍّ (ع) كانت بأمر الرسول (ص) (2)
الشيخ محمد صنقور
الشعراء
-
 الإمام الصادق: مستودع أسرار العلوم
الإمام الصادق: مستودع أسرار العلوم
حسين حسن آل جامع
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك
تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك
الشيخ علي الجشي
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
آخر المواضيع
-

الأساس العلمي لوجود المحلات التجارية المتنافسة قريبة من بعضها
-

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (2)
-

النسل الصالح: رعاية وصيانة
-

ثوراتٌ تمهيديّة للظهور المبارك
-

(المجاز بين اللّغة والأدب) أمسية أدبيّة للدّكتور أحمد المعتوق
-
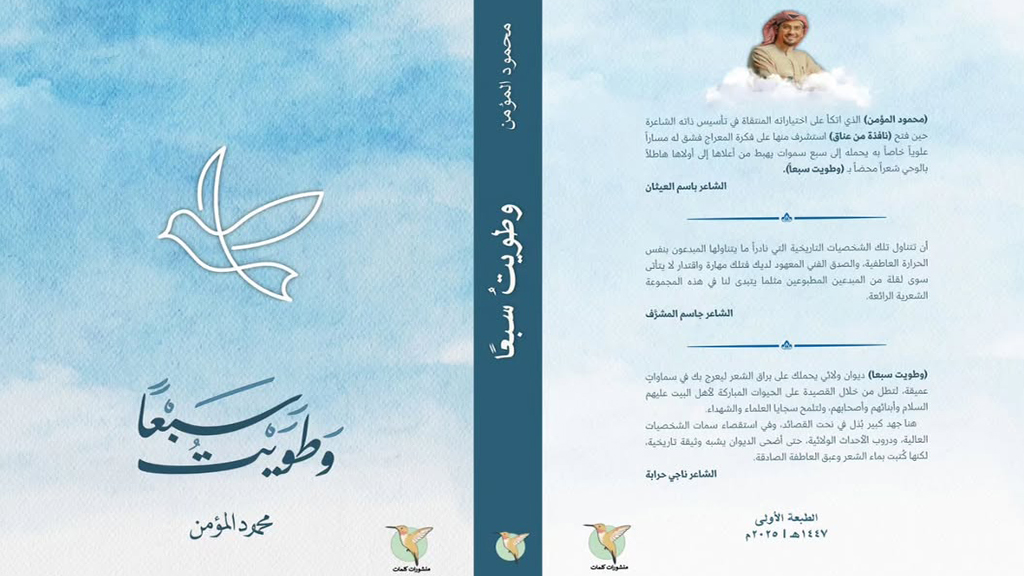
(وطويت سبعًا) جديد الشاعر محمود المؤمن
-

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (1)
-
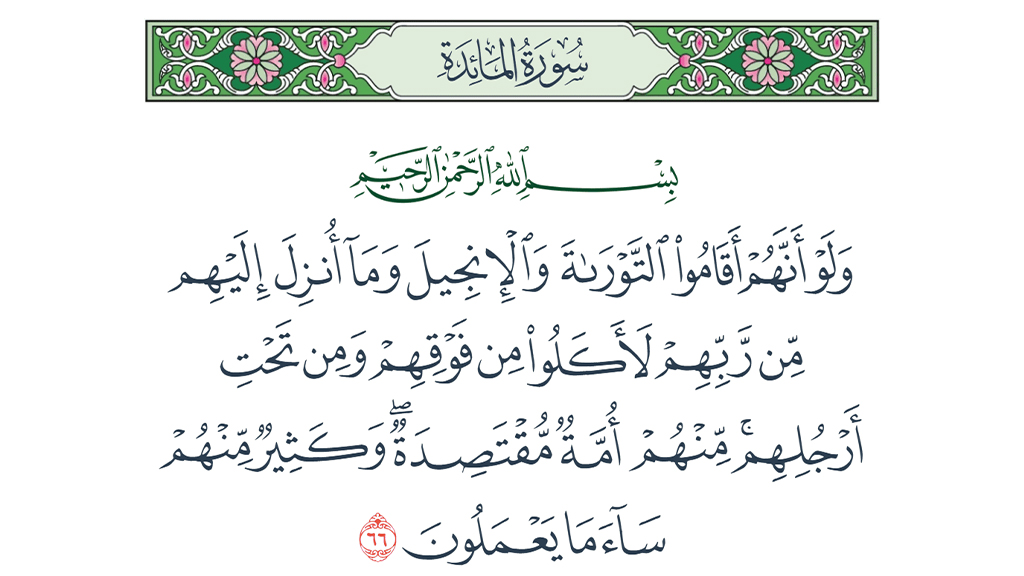
وَلَوْ أَنَّهُمْ!!
-

إسلام سلمان الفارسي في قباء
-
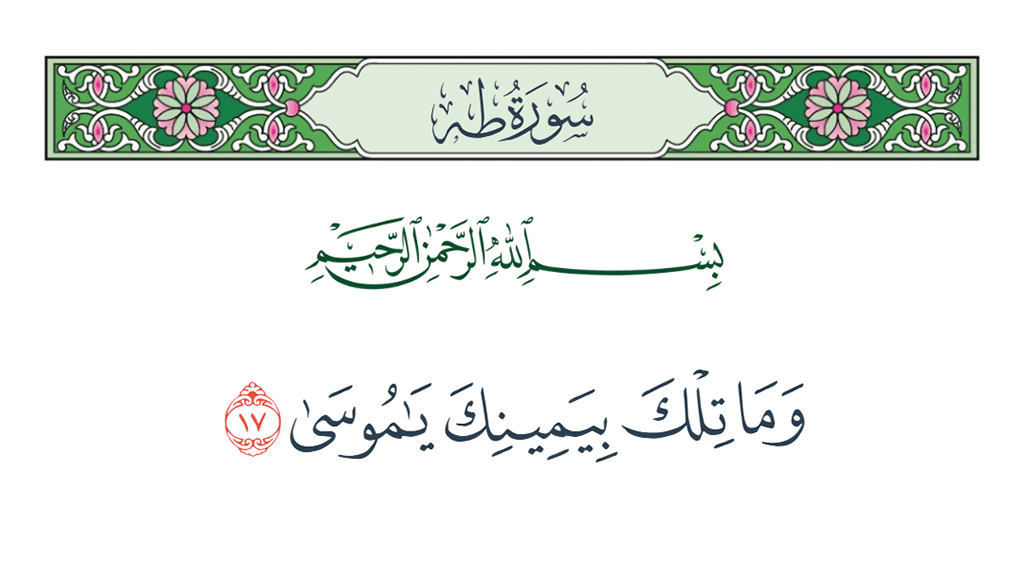
{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى}









