علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (3)

جوهرانية الصلة بين المتناهي واللاَّمتناهي
على شدة ما يبدو في الظاهر من اختصام بين المتناهي واللاّمتناهين وبالتالي ـ وعلى وجه التعيين، بين الأيديولوجيا واليوتوبيا، فإنهما محكومتان بمنطق داخلي واحد. وإذن، لا يمكن النظر إليهما إلاّ كذلك. فالعلاقة الناشئة بينهما ليست علاقة بين طرفين بقدر ما هي تمظهر لجدلية واحدة. فلكي يُحسم الغموض بتلك العلاقة القائمة على شكلانية التناقض وجوهرانية الاتحاد، حرص ريكور على وضع الأيديولوجيا واليوتوبيا داخل إطار مفهومي واحد. وقد انطلق من فرضية أن ضمّ هذين الطرفين أو الوظيفتين المتكاملتين إلى بعضهما يقدم الأنموذج لما يمكن أن يسميه المخيلة الاجتماعية والثقافية. وهكذا، يكشف البحث الذي افتتحه ريكور بصدد الأيديولوجيا واليوتوبيا، عن خاصّتين تشترك فيهما الظاهرتان:
الخاصيَّة الأولى إن كليهما غامض لكل منهما جانب إيجابي وآخر سلبي، دور بنّاء وآخر مدمر، بُعد تأسيسي وآخر مرضي.
الخاصيَّة المشتركة الثانية: إن الجانب السلبي من بين جانبي كل منهما يظهر قبل التأسيسي، متطلباً منا الانطلاق إلى وراء، من السطح إلى الأعماق. تشخص الأيديولوجيا إذن منذ البداية عمليات تشويهية إخفائية يعبر من خلالها الفرد أو الجماعة عن حالته من دون أن يعلم ذلك أو يدركه. تبدو الأيديولوجيا، على سبيل المثال، وكأنها تعبّر عن الحالة الطبقية لفرد دون وعي الفرد بها. لذلك فإن إجراء الإخفاء لا يعبّر عن هذا المنظور الطبقي فقط بل ويقويه. أما بالنسبة لليوتوبيا فإن لها سمعة سيئة أيضاً بحسب رؤية ريكور ـ إنها تبدو وكأنها تقدم نوعاً من الحلم الاجتماعي دون أن تكترث بالخطوات الواقعية الضرورية الأولى للتحرك باتجاه مجتمع جديد.
وغالباً ما تعامل الرؤية اليوتوبية كنوع من الموقف الفصامي تجاه المجتمع، فهي في الوقت ذاته طريقة للهرب من منطق الفعل عبر تشكيلة خارج التاريخ، ونوع من الاحتماء ضد أي إثبات للصحة عبر الفعل الملموس. وضمن سياق هذه الرؤية تذهب فرضية ريكور إلى أن هنالك جانباً يضاف إلى الجانب السلبي في كل من الأيديولوجيا واليوتوبيا، وأن القطبية بين هذين الجانبين في كل مصطلح يمكن أن تتكشف من خلال استقصاء قطبية مماثلة بين المصطلحين. ودواعي هذه القطبية بين الأيديولوجيا واليوتوبيا، وأيضاً داخل كل واحدة منهما، يمكن أن تُعزى إلى خواص تركيبية لما يسميه ريكور “المخيلة الثقافية”. إن هاتين القطبيتين تحويان ما يمثل بالنسبة الى ريكور التوترات الرئيسية في دراسته للأيديولوجيا واليوتوبيا.
أما القطبية بين الأيديولوجيا واليوتوبيا فإنها لا تكاد تخضع للبحث منذ كتاب كارل مانهايم الشهير “الأيديولوجيا واليوتوبيا”. هذا الكتاب الذي يصرِّح ريكور أنه سيعتمد عليه كثيراً، قد نشر مرة عام 1929. وهو يعتقد أن مانهايم هو الشخص الوحيد، على الأقل حتى وقت قريب، الذي حاول أن يضع الأيديولوجيا واليوتوبيا في إطار مشترك، وقد فعل ذلك من خلال اعتباره لهما كليهما موقفين منحرفين عن الواقع. وهما يتباعدان ضمن الجانب المشترك بينهما والمتمثل في اللاتطابق مع الواقع أو التعارض معه.
منذ مانهايم، تركَّز أغلب الاهتمام بهاتين الظاهرتين إما على الأيديولوجيا أو على اليوتوبيا، ولكن ليس عليهما معاً. من جانب آخر، هناك نقد للأيديولوجيا، طرحه أساساً علماء الاجتماع الماركسيون وما بعد الماركسيين. وهنا يتذكِّر ريكور على وجه الخصوص بمدرسة فرانكفورت التي يمثلها هابرماس وكارل أوتوابل، وغيرهما. مقابل هذا النقد الاجتماعي للأيديولوجيا نجد أن لليوتوبيا تاريخاً وعلم اجتماع. واهتمام الحقل الأخير باليوتوبيا لا تربطه إلا علاقة واهية باهتمام حقل النقد الاجتماعي بالأيديولوجيا. ولكن ربما كنا نشهد تغيراً في الميل إلى الفصل بين هذين الحقلين، هنالك على الأقل اهتمام متجدد بالعلاقات بينهما.
وحسب ريكور فإن الصعوبة في ربط الأيديولوجيا باليوتوبيا مفهومة على أية حال، فهما أمران مطروحان بطرق شديدة الاختلاف. الأيديولوجيا مفهوم مثير للسجال دائماً. أما الأيديولوجيا فإنها ليست أبداً موقف الشخص المتكلم، إنها دائماً موقف شخص آخر. إنَّ الأيديولوجيا عندما توصف بطريقة فضفاضة جداً تكون بمثابة خطأ ارتكبه الآخر. لذلك فإن الناس لا يقولون أبدا إنهم أنفسهم دعاة أيديولوجية ما، المصطلح موجه دائماً ضد الآخر. من جانب آخر نجد إن كتاب اليوتوبيات يدافعون عنها، بل هي تشكل جنساً أدبياً محدداً. هنالك كتب تسمى يوتوبيات، وهي تتمتع بمكانة أدبية متميزة لذلك، فإن اللغوي للأيديولوجيا واليوتوبيا لا يتطابق دائماً. اليوتوبيات يدّعيها كتّابها لأنفسهم، بينما الأيديولوجيات ينكرها كتّابها. وهذا هو السبب الذي يجعل وضع الظاهرتين معاً صعباً للوهلة الأولى. لا بد لنا من الحفر تحت التعبيرات الأدبية والدلالية عنهما لكي نكتشف وظيفتهما وعندها نؤسس لرابطة تجمع بينهما على هذا المستوى.[1]
حضوريـة اللاَّشعور السياسي:
ماذا لو أقمنا صلة قربى بين ما يسميه بول ريكور بـ”المخيَّلة الثقافية” التي تتولى مهمة الوصل والتركيب في عالمي الأيديولوجيا واليوتوبيا، وبين ما يسمى بـ”اللاَّشعور السياسي”؟..
ما دمنا على قناعة بأن الأيديولوجيا هي إحدى أكثر المفاهيم سعة لقبول التعددية المنهجية في تفسير ذاتها وموضوعها فلا يعد أمراً مفارقاً للمنطق استعمال مقولة اللاَّشعور السياسي كواحدة من إواليات فهم الممارسة الإيديولوجية. والذين عكفوا من الحداثيين الغربيين على تسييل نظرية اللاَّشعور من كونها مقولة محض علم نفسانية إلى مقولة سارية في الاجتماع السياسي، فقد وجدوا أحد أبرز خطوط عمل الأيديولوجي.
فلقد توصلوا ـ وعلماء الاجتماع الألمان منهم على وجه الخصوص ـ إلى أن المجتمع السياسي هو ميدان الدعوة المعبِّرة عن المصالح وليس ميدان الحق. وهم بهذا فتحوا باب الجدل واسعاً أمام ضرورة دراسة السياسة دراسة علمية وموضوعية. وبالنسبة إليهم لم يعد هناك أصل ثابت يضمن الحقيقة المطلقة. فلا يوجد علم مطلق ولا مغزى للتاريخ ولا طبقة كونية. المجتمع مجزَّأ إلى طبقات وفئات ولا سبيل إلى إرجاع معتقدات الطبقات والفئات إلى أصل واحد. كل طبقة وكل فئة تبدع منظومة فكرية تبرر لها مصالحها الظرفية. وجميع تلك المنظومات تخدم بالضرورة الأهداف المرسومة لها.. لذلك فهي في عين الملاحظ متساوية، لا تتميز الواحدة عن الأخرى فيما يتعلق بالحق، وإنما فقط فيما يرجع إلى الفعالية، إلى القدرة على كسب الأتباع وتقريب الأهداف وبالتالي، يمكن وصف السياسة بدون تقييم.[2] وإذاً، كيف تدخل مقولة اللاَّشعور السياسي، في سيرورة الاجتماع السياسي، وبالتالي ضمن جدلية الاستخدام الأيديولوجي؟
لقد رأينا من المفيد، وقبل شرح مضمون المقولة، أن نمر على مفهوم اللاَّشعور الذي ملأ فضاء الدراسات النفسية والاجتماعية في بداية القرن العشرين. لقد لاحظ علماء النفس أن هناك أنواعاً من السلوك تصدر عن الفرد البشري من دون شعور منه، وهي تختلف عن ردَّات الفعل الآلية في كونها هادفة، تلبي حاجات معينة وتنزع إلى تحقيق رغبات خاصة، ومع ذلك فهي لا تخضع لمراقبة “الأنا”. وبما أن الأفعال الإرادية، الخاضعة للمراقبة الشعورية، يقال عنها أنها تصدر عن “الشعور”، فإن الفعال التي لا تخضع لمثل هذه المراقبة قد نسبت إلى منطقة أخرى في الجهاز النفسي أطلق عليها اسم “اللاَّشعور”.
ومعلوم أن عالم التحليل النفسي الشهير سيغموند فرويد (1856 ـ 1939) قد أولى أهمية خاصة لـ”اللاَّشعور” إذ جعل منه منطقة واسعة من الجهاز النفسي تضم الدوافع الغريزية والرغبات المكبوتة، واعتبره مسؤولاً عن قسم كبير من سلوك الفرد البشري، وهو يكشف عن نفسه من خلال الأحلام وفلتات اللسان وغيرها من الأفعال غير الإرادية. وهكذا صار السلوك البشري يضيف إلى سلوك صادر عن الشعور، عن وعي وقرار وتصميم، وسلوك صادر عن اللاَّشعور لا تتحكم فيه إرادة المرء بل يفلت من الرقابة الشعورية، رقابة “الأنا”، ليلبي حاجات غريزية دفينة أو رغبات مكبوتة منذ الطفولة.[3]
ومع أن “اللاَّشعور” بحسب الأطروحة الفرويدية سوف يوظف في عالم الأيديولوجيا، إلاَّ أنه يأخذ منحنىً مختلفاً عما ستأخذه مقولة اللاَّشعور السياسي في استخداماتها المعاصرة. تعتبر الفرويدية في سياق شرحها لثنائية الوعي واللاَّوعي، أن الوعي كيان مرتبط بكيان آخر أساسي هو اللاَّوعي. ومع أن فرويد يعترف بواقع الارتباط، والتأثر والتأثير المتبادلين بين الوعي واللاَّوعي بيد أنه يرى إلى اللاَّوعي بصفته العامل المحدِّد. وفي حين تشكل “الأنا” العامل الأساسي في الوعي، يشكل “الهو” عاملاً تأسسياً في “اللاَّوعي”. لكن “الأنا” تبقى تمثل الأساس الواقعي الذي على أرضه يتصل الفرد بحقائق الحياة المتحركة. وهي تتأثر بـ”الأنا العليا” الجامعة للقيم والمثل والمتساميات والمقاييس الكلية. كذلك فهي على صلة وثيقة، ديالكتيكية مع هذه الأخيرة (الأنا العليا) و”الهو”. على حين يمثل “الهو” مبدأ اللذة الذي تؤسسه الدوافع والرغبات. وفي خلال سيرورة التفاعل بين مثلث “الأنا” و”الهو” و”الأنا العليا”، يمارس “الهو” ضغطاً دائماً على “الأنا” الفرد، و”الأنا العليا” الكل، ويقوم بوظيفة الدور الحاسم في توجيه تصرفات الفرد الساعي إلى مواجهتها عبر “الأنا”، حيث تتمظهر عادة، وبحسب المخطط الفرويدي، في صيغة رموز، يجري التعبير عنها بوضوح في الأحلام.
على هذا النحو يكتسب “اللاَّوعي” سمة الاستقلال النسبي كونه العامل الفعال في شخصية الفرد. مع هذا تبدو الفروق الثقافية والاجتماعية سطحية إذا تذكرنا وحدة البشر النوعية. ذلك أن ثمة تطابقاً بين النفسانية الفردية والأنظمة الاجتماعية والتاريخ الإنساني في لاعالم. لهذا السبب ينتقل فرويد من دون إنذار من ميدان إلى ميدان. لنأخذ، مع عبد الله العروي، كمثال على التفسيرات الفرويدية، تحليله (فرويد) لانتشار الدعاية السياسية ـ أي للكيفية التي يقتنع بها الفرد بأيديولوجية ما. ويصبح يرى كل شيء حسب منطق مقولاتها.
التفسير الرائج في أواخر القرن التاسع عشر يعتمد كما يبيِّن فرويد على الإيحاء والتلقين، ويرى أن الإقناع هو نتيجة هيبة يشعر بها فرد بإزاء فردٍ آخر. وهذه الهيبة تعمل كالمغناطيس. فالفرد الذي يملكها يوحي إلى الآخرين بآرائه ويفرضها عليهم. لكنه ـ على ما يبيِّن العروي ـ يرفض هذا التفسير لأنه مبنيٌّ على النفس الفردية وحدها. يقول إن الفرد، كيف ما كان، قريب جداً من أصله، أي من المجتمع الحيواني الأول وهو القطيع. وبرأي فرويد، إن الفرد لا ينفرد إلاَّ بقسم ضئيل جداً من نفسانيته. أما القسم الأكبر فهو نفسانية جموعية مشتركة… إننا نستطيع أن نحدد متى انفصلت النفسانية الفردية عن النفسانية الجموعية، متى استقلَّ الفرد نسبياً عن الحشد. لذلك فعندما يكون الفرد في حشدٍ فإن نفسه تكون مسرحاً لعمليتين:
الأولى: التماهي مع الآخرين، لأن الكل قلق بنفس القدر. وينتج عن التماهي، التآخي والشعور بالقوة والتغلُّب على الوحدة والخوف والقلق.
الثانية: تشخيص الأنا ـ العليا في القائد. وينتج عن هذه العملية رضوخ إداري، وتخلٍّ عن قيود العقل، وإطراح أعباء المسؤولية.
إن هذا المثال ـ يبيِّن لنا ـ حسب فرويد ـ مدى سطحية التفسير العقلاني المبني على الفرد. فالعقل أداة، ولأنه كذلك فكيف يمكن لنا أن نفسِّر الأداة بقوانينها؟ لذا يقول العروي ـ استناداً إلى تحليله لمقاصد الفرويدية ـ لا بد من البحث عن الأسباب الحقيقية خارج العقل. ذلك أنه لا يمكن أن نفهم الأفكار والأنظمة الاجتماعية والمذاهب بالنظر إلى القواعد العقلية التي أنشأتها وركَّبتها. لا بد من الغوص في ما يتحكَّم بالعقل ويستخدمه.
إن القوة التي تستخدم العقل لتنفيذ أغراضها بوسائل ملتوية، هي الرغبة المكبوتة وراء الوعي. فكل ظاهرة (فكرة ـ مؤسسة ـ مذهب) هي عبارة عن نزوات الرغبة. وتتغير العبارة ـ أي التعبير اللغوي عن الظاهرة، حسب الظروف والأهداف المرحلية. يجب إذن تأويل الأخلاق والأديان والأساطير والأعمال الفنية والأنظمة الاجتماعية والوقائع، وكذلك سمات الأمراض، باعتبارها رموزاً تشير إلى أهداف غريزية وأقمصة شفافة تتقمَّصها الرغبة. إذا أخذنا هذه الأشياء على ظاهرها، وفهمناها على أساس العقل الذي ركَّبها فإنها تقودنا إلى أوهام، إلى ما يظهر حقيقة في حين أنه يستر الحقيقة. لكن إذا ما أوَّلناها حسب قانون الرغبة فإنها ترشدنا إلى الحقيقة الأساسية التي تجري على الإنسان كما تجري على باقي الكائنات الحية. وهكذا فإن الأفكار ـ كما تقول الفرويدية ـ أوهام تخدعنا بها الرغبة الإنسانية لتصل إلى هدفها، وأما تعرية الأوهام من صبغة الحق التي يلصقها بها العقل المخدوع هي واجب العلم في رأي فرويد.[4]
ماذا الآن عن التأويل المعاصر لما سمي “اللاَّشعور السياسي”؟ من الواضح كما بيَّنت لنا أطروحة الرغبة التي تساوي فعلية الأيديولوجيا عند فرويد، أن نتاجات العقل هي تبريرات خلقها الإنسان المتمدن لمعارضة دفع الرغبة الجارف، ويعلِّل قوله هذا استناداً إلى طبيعة الإنسان الحيوانية. ومن الواضح كذلك أن أقوال ماركس حول الأيديولوجيا بأنها تخفي مصلحة طبقية تحتوي على بنية مشتركة مع الفرويدية لجهة أن الأفكار هي رموز لا تحمل حقيقتها فيها، بل تستر حقيقة باطنية، وفي هذا الستر ذاته تومئ إليها، وبتأويل ذلك الإيماء نكشف عن الحقيقة المستورة. في حين أن البنية المشتركة المشار إليها إنما هي إرث مشترك جاء من مشروع فلسفة الأنوار.[5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – ج. هـ. تيلور ـ المصدر نفسه ـ ص49.
[2] – عبد الله العروي ـ مفهوم الأيديولوجيا ـ المركز الثقافي العربي ـ ط4 ـ 1988 ـ ص45.
[3] – حمد عابد الجابري ـ العقل السياسي العربي ـ محدداته وتجلياته ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ الطبعة الرابعة 2000 ـ ص10.
[4] – العروي ـ مصدر سبقت الإشارة إليه ـ ص41 ـ42 .
[5] – العروي ـ المصدر نفسه ـ ص43.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
محمود حيدر
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)
-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة
-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
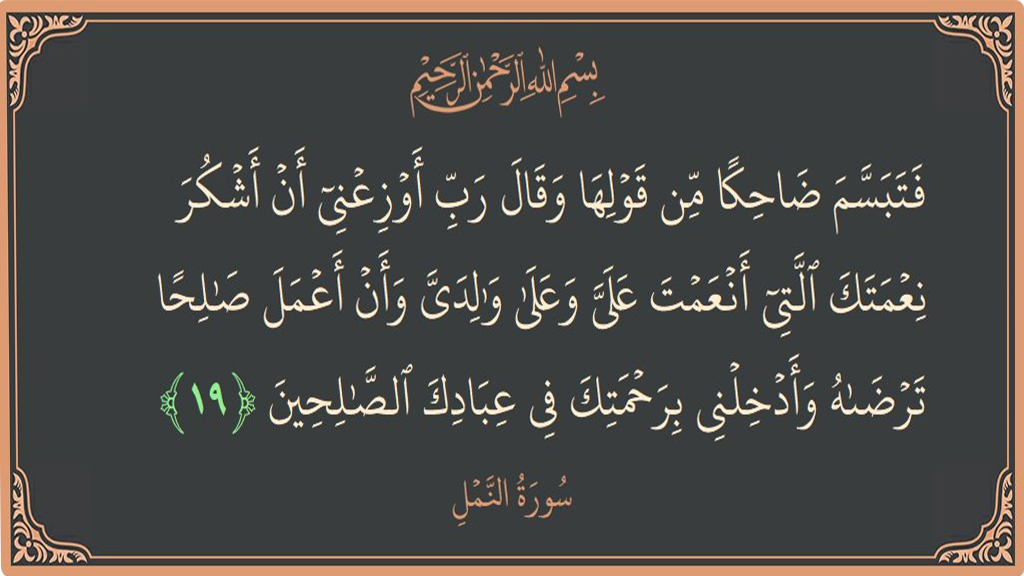
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)









