علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (2)

المتناهي السياسي واللامتناهي الأيديولوجي
ليس لدى الأيديولوجي في رحلته أمر غير متناهٍ في لعبته إلاّ المصلحة. لكن هذه الأخيرة لا تقوم إلا ضمن لعبة لها شرائطها وأصولها. لذا لا يستطيع الأيديولوجي أن يرسل خطابه بينما يبقى اللاّمتناهي من كلمات ذلك الخطاب ساكناً في عليائه. فهو لو بقي في محل سكنه ذاك، لاستحال مجرد سديم. فلا مناص من إرادة تنزل لغة اللاّمتناهي إلى الوضع الذي يجعلها طائعة في ميادين الاستخدام.
فلو حقَّت الإرادة أصبحت اللغة نصّاً. فالنص بحسب هذا التحول، هو حصيلة زواج شرعي بين المتناهي السياسي واللاّمتناهي الأيديولوجي. وبمقتضى هذا الزواج تنشأ قابليات التوليد تبعاً لجدليات الواقع وتحيُّزاته.
عندئذٍ سوف يمكن تعريف النص عبر إنزاله إلى مواضع الاختبار. وكما يقال فإن غياب التعريف بالشيء، مع ممارسة هذا الشيء، واتخاذه دليلاً، لهو تعريف به أيضاً. فالممارسة هي تعريف بالشيء، وهي برهانه على وجوده واستمراره وانفتاحه. أما التعريف بالشيء بعد انقضاء ممارسته فهو برهان على انقضائه وانغلاقه، وهذا يعني أن اللاّمتناهي يستعصي على التعريف. إذ لا انقضاء فيه، ولا انغلاق، وأن المتناهي يقبل التعريف إذ لا استمرار فيه ولا انفتاح (…) وهذا اتجاه في التراث العربي و”الإسلامي”، يقف على النقيض من البنيوية التي تنظر إلى النص على أنه بنية مغلقة منتهية (…) فإن غيبة التعريف بالنص في هذا التراث تتفق مع منظورها التوليدي.
فالمقاربات الفقهية واللغوية له، لا تزيد في الميدان الأول، عن الإشارة إلى أن النص هو القرآن الكريم، أو مجموعة القواعد المستمدة من القرآن والسنة. وهذه الإشارة ذات أهمية بالغة، لأن كل كلام يُصدَرُ، من وجهة نظر أصولية، إنما يُصدِرُ توليداً من ممارسة المتكلم للنص عبر قواعده. ولذا يتساءل ابن رشد في كتابه “بداية المجتهد ونهاية المقتصد”. “كيف يقابل المتناهي من النصوص اللاّمتناهي من الأحداث في حياة الأناسي. فيعزز بهذا مفهوم التوليد في الممارسة النصّية. وأما الإشارة إلى النص في الميدان الثاني، أي في الميدان اللغوي، فهي وإن كانت تفسيراً معجمياً ولفظياً، إلا أنها تساهم في تأكيد هذا المفهوم، وتدخل معه في السياق نفسه. [فالفعل “نصَّ الشيء” يعني رَفَعَه وأظهره، وإذا كان حديثاً أسنده إلى قائله” وفي لسان العرب أيضاً “نصّ الناقة” أي استحثَّها بشدة].
والذين مضوا في هذا التحليل سيقودهم ذلك إلى مقاربة مفادها: أن النص دائم الإنتاج لأنه مستحثٌّ بشدة. ودائم التخلُّق لأنه دائماً هو في شأن ظهوراً وبياناً. ومستمر في الصيرورة لأنه متحرك. وقابل لكل زمان ومكان لأن فاعليته متولِّدة من ذاتيته النّصية. وهو إذا كان كذلك، فإن وضع تعريف له يعتبر تحديداً يلغي الصيرورة فيه، ويثبت إنتاجيته على هيئة نمطية لا يكون فيها للمتغيرات الأسلوبية والقرائية أثر. وكذلك يلغي قابليته التوليدية زماناً ومكاناً ويعطِّل في النهاية فاعليته النّصية.[1]
عندما يمضي الفاعل الأيديولوجي إلى بيان هدفه من خلال الكلمات فإنه لا ينفصل عن الوقائع التي يسعى ليغشاها بتلك الكلمات. وهو بهذا إنما يقوم بإجراء تمرينات على الربط بين المتناهي المتعيِّن بالوقائع المكسوَّة بالكلمات المناسبة لها، وبين اللاّمتناهي الزاخر بقابليات التوظيف. إن ثمة علاقية حَثِّية بين الوجهين. إذ كل من السياسي المتعيّن والأيديولوجي السابح في فلكِهِ اللامحدود يحثّ نظيره على الحراك فيكونان مصدراً لولادات لا نهاية لها.
فلو أفلح الفاعل الأيديولوجي في إجراءاته لدلّ هذا على حسن التوحيد بين مظهرين يبدوان على تغاير واستحالة فيما هما يستويان على نشأة واحدة.
سوف نقع على إضاءة فلسفية معاصرة لو نحن عدنا إلى الفرنسي بول ريكور في محاظراته حول ”الأيديولوجيا واليوتوبيا”. فلقد ظهر لنا إن إحدى النتائج الهامة لتأكيد ريكور على الواقعي بوصفه فعلاً، هو أن طبيعة الحقيقة نفسها لا يمكن أخذها كأمر مسلم به. فيقول ريكور إن البعدين الزمني والرمزي للوجود البشري يضعان طبيعة الحقيقة موضع التساؤل. لأن الحياة الإنسانية متوسَّطة رمزياً، فإن أي مفهوم للواقعي هو ذو طبيعة تأويلية.
إن أنموذج الحقيقة بوصفها مكتفية بذاتها غير كاف، لم يعد بإمكاننا الاستمرار بوصف تأويل ما، بأنه يمثل، أو يستجيب لحقيقة غير خاضعة للتوسط أو “حرفية”. بدلاً من ذلك، تحقق اللغة الشعرية اختراقها إلى ذلك المستوى ما قبل العلمي والسابق على الإسناد حيث توضع أفكار مثل الحقيقة الواقعة، والقصد، والواقع، الحقيقة نفسها، كما تحددها فلسفة المعرفة، موضع التساؤل…” ليس بإمكاننا في نهاية المطاف ـ كما يضيف ريكور ـ فصل الواقعي عن تأويلاتنا؛ فإن طبيعة الواقعي نفسها تبقى محافظة على خاصية استعارية. كما أن الاستعارة تنشط أيضاً في البعد الزمني، لأن “مرجع المنطوق الاستعاري يُنشِّط الوجود كحقيقة واقعة وكإمكانية” لكن على المستوى الاجتماعي تتولى اليوتوبيا هذه الإمكانية.[2]
والواضح أن استجابة ريكور لهذا التحدي لفكرة الواقع تتمثل في دعوته إلى “إعادة صياغة جذرية لمشكلة الحقيقة”. وسوف يُطوِّر ريكور هذا الموضوع في المجلد الثالث من كتابه “الزمن والسرد” لكنه يستبق معالجته تلك من خلال كلامه في الأعمال المبكرة عن مفهوم “استعاري” أو “مستقبلي” للحقيقة. يقول ريكور إن المهمة هي “أن نذهب بعيداً إلى حد تحويل فعل الكينونة نفسه إلى استعارة، وندرك “الوجود بصفته” قريناً لـ “النظر إليه بصفته”، وفي ذلك ما يُلخِّص عمل الاستعارة. إن ما نفهم أنه الواقعي يصلنا عبر وسيط رمزي منذ البداية، كما أن الواقعي يمر دائماً في حالة صيرورة. لذلك، يدّعي ريكور أن “الواقعي هو كل شيء اتخذ شكلاً مسبقاً بالفعل وغيّره أيضاً”. ولا يعود من الممكن الإبقاء على الحد الفاعل بين الابتكار والاكتشاف. “ليس مجدياً السؤال إن كان الشمولي الذي “يعلمنا” إياه الشعر، حسب أريسطو، موجوداً بالفعل قبل ابتكاره. أنه مبتكر بقدر ما هو مكتشف.
ربما كانت إمكانيات الإبداع والتغيير التي تفتحها نظرية ريكور الاستعارية عن الحقيقة أوج مشروعه الفلسفي. ومع ذلك، فكما هو الحال دائماً لدى ريكور، علينا لكي نفهم هذه الإمكانيات على نحو تام، إعادة إدخال الجدلية وإعادة تأكيد المصادر التي خرجت منها هذه الإمكانيات. علينا أن نستصلح الجدلية القائمة بين اليوتوبيا والأيديولوجيا. وهذه النقلة مستبقة في الاقتباس أعلاه حول العلاقة الحركية بين التمثيل المسبق وتغيير الشكل. فلئن فتحت اليوتوبيا الممكن، فإنها تفعل ذلك على أساس التحويل الاستعاري لما هو موجود. لقد استخدمنا في وقت سابق مفهوم الأيديولوجيا ليوجه مناقشتنا لحقيقة أننا دائماً نكون قد بدأنا بالفعل، وأننا دائماً نجد أنفسنا داخل حالة من التوسط الرمزي الخاص بالطبقة والأمة والدين والجنس لا مجال للانتقاص منها.[3]
هذه الجدلية بين ما تمثَّل مسبقاً وما تغير شكله تتخذ أشكالاً عديدة في كتابات ريكور. إنه يصف الإيمان الديني، على سبيل المثال، باعتباره متجذراً في التوتر بين الذاكرة والتوقع. ويمكن العثور على مثال آخر في طبيعة الحياة الأخلاقية:” لا تثبت الحرية نفسها إلا عبر إعادة تقويم على أساس مختلف لما تم تقويمه بالفعل. الحياة الأخلاقية صفقة أبدية بين مشروع الحرية وشرطها الأخلاقي الذي رسم حدوده عالم المؤسسات المعطى. يمكن أن نقول بشكل أكثر عمومية بأن الجدلية بين ما تمثَّل مسبقاً وما تغيَّر شكلُهُ توفر إحساساً موسّعاً، بمعنى التقليد. ليس التقليد هو “البث الجامد لمخزون مادي ميّت، بل هو البثّ الحي لابتكار يقبل دائماً إعادة التفعيل من خلال العودة إلى أكثر لحظات الفعالية الشعرية إبداعاً… وفي واقع الأمر يتشكل التقليد من التفاعل بين الابتكار والترسيب”.
وعلى ما يُلاحظ جورج تيلور في قراءته لريكور فإنه إذا كانت جدلية الأيديولوجيا واليوتوبيا تشتغل في أحد معانيها بصفتها الارتباط بين ما تمثل مسبقاً وما تغيَّر شكله، فإنها تنشط أيضاً على مستوى آخر. وهو المستوى الذي تصفه نظرية في التأويل. هنا يشير التأكيد على اليوتوبيا إلى احتمالات، ولكن لا بد من موازنة هذه الحركة الاستعارية من خلال استجابة الفكر التأملي. وبحسب ريكور فإن التأويل هو … نمط خطاب يشتغل في تقاطع عالمين، الاستعاري والتأملي. إنه خطاب مركّب إذن، وبوصفه كذلك فإنه لا يستطيع إلا أن يستشعر الجذب المضاد من حاجتين متنافستين. من جهة، يسعى التأويل إلى وضوح المفهوم، لكنه يأمل من جهة أخرى في الحفاظ على حركية المعنى الذي يمسك به المفهوم ويثبته.[4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – عياشي – مصدر سبقت الإشارة إليه. انظر – منذر عياشي – النص: ممارسته وتجلياته – مجلة الفكر العربي المعاصر – عدد (96-97) 1992.
[2] – ج. هـ. تيلور ـ المصدر نفسه ـ ص32.
[3] – ج. هـ. تيلور ـ المصدر نفسه ـ ص32.
[4] – المصدر نفسه ـ ص49.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
محمود حيدر
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)
-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة
-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
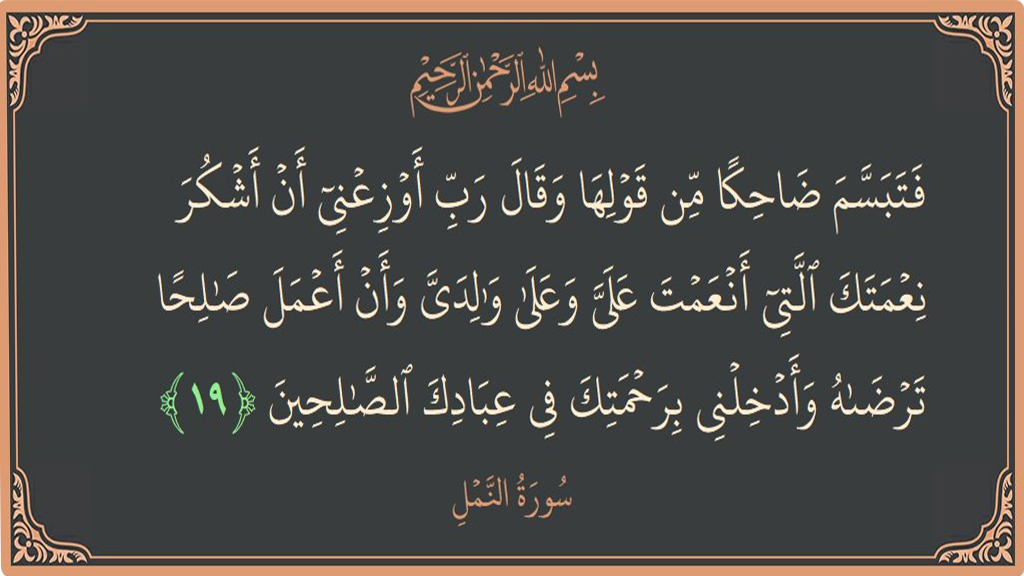
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)









