مقالات
رسالتنا والتسليم لله
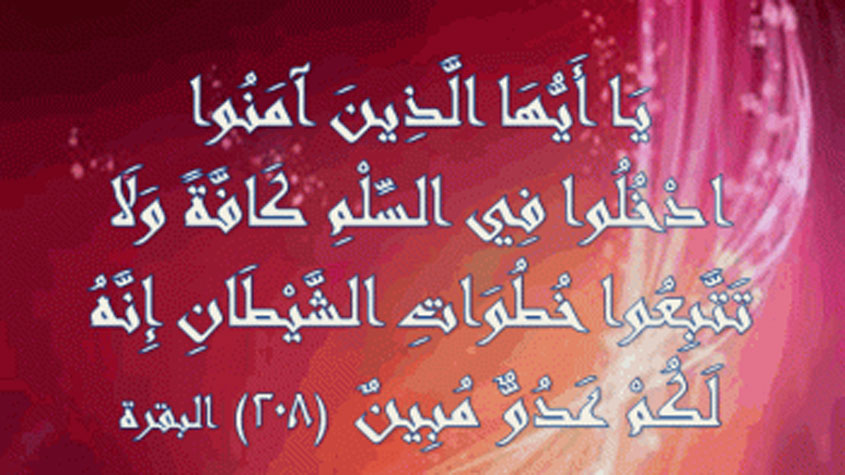
الشيخ محمد مهدي شمس الدين ..
بسم الله الرحمن الرحيم
(يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين). البقرة 208.
يطالعنا ونحن بصدد شرح ما تهدف إليه هذه الآية الكريمة – السؤال التالي :
ما هو المعنى الذي تشير إليه كلمة ( السلم ) في الآية الكريمة؟.
وعندما نحاول أن نلقي نظرة تحليلية على هذه الكلمة ينبغي أن نذكر كل الاحتمالات التي تكتنفها.
فقد تعني السلام الذي يقابل معنى الحرب، وقد تعني الإسلام كعقيدة وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقد تعني شيئاً ثالثاً هو الاستسلام التام لله والخضوع الكامل في كل شؤون الحياة .
ولا يمكن أن يسايرنا في بحثنا من هذه الاحتمالات الثلاثة غير الاحتمال الثالث فقط. فليس بإمكان الاحتمال الأول أن يثبت أمام النقد، عندما نعرف أن معنى كلمة السلم –بكسر السين- ليس من معناها اللغوي السلام، وقد تطلق على السلام مجازاً لما يعنيه السلام أيضاً الاستسلام والرضا والقبول. هذا مع أن السلام ليس إلا واقعة لها حكمها الشرعي المختلف باختلاف الظروف والأجواء التي يمر بها الإسلام في جهاده لإقامة كيانه. فقد تقتضي بعض الظروف وجوب السلام، كما يشير إليه قوله تعالى: (فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فيما جعل الله لكم عليهم سبيلا).
وقد تدعو بعض الظروف الأخرى إلى حرمة السلام، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون …) والسلام في هذا كبقية الوقائع الأخرى التي أعطى الإسلام رأيه فيها. وإذا كان بهذه الصفة فلا مجال لأن يصدر الأمر القاطع بالدخول في السلام، دون أن يقيد بحالة خاصة أو ظرف مناسب.
والاحتمال الثاني هو الآخر لا يثبت للنقد أيضاً. فإن ملاحظة الآية الكريمة بدقة تشهد: بأن الكلمة لو كانت تعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لم يوجه الخطاب للذين آمنوا على الخصوص، حيث لا معنى لدعوة المؤمنين بالإسلام إلى الدخول في الإسلام.
والآية بعد هذا كله تهدف إلى معنى سام، ونقطة ضرورية بالنسبة إلى مصير الإسلام، تتجلى حين نقف عند كلمة (فادخلوا). فإنها تعني أن السلم ليس إلا كياناً متميّزاً نطالب في الدخول فيه، وليس هو صفة نفسية شخصية يقوم بها الفرد المؤمن منفصلاً عن بقية المؤمنين.
فهي إذن تدعو إلى إقامة كيان محسوس يتميّز بالاستسلام والخضوع للخالق، وتسليم القيادة العملية له وإعطاء السلطات التي يقوم المجتمع على أساسها بيده، هذا الكيان الذي يعبّر تعبيراً حقيقياً واضحاً عن الكيان الإسلامي، الذي بعث النبي محمّد (ص) لإقامته، ودعوة البشرية للحياة في ظلاله وأكنافه .
فلا يريد القرآن الكريم من المسلم المؤمن بالله سبحانه وتعالى الاستسلام والخضوع الشخصي له فحسب، وإنما يريد منه بعد كل هذا أن يكون عاملاً من أجل إقامة الكيان الإسلامي، الذي يتميّز بطابع الاستسلام والخضوع للخالق وهو بعد هذا يطالب المسلمين جميعاً للانخراط ضمن هذا الكيان الواحد المستسلم. فليس هناك استسلام حقيقي، إذا كانت هناك كيانات متعددة.
والقاعدة الأساسية شيء ضروري وجوهري لكل مجتمع يريد لكيان التماسك والبقاء، ويهدف إلى الرفاه والسعادة والعزة. ذلك لأن القاعدة الأساسية هي المحرّك الصميمي يمد المجتمع بالحيوية والنشاط، وهي التي تحفظ للمجتمع وحدته وتماسكه، وهي تكون نقطة لكل الأعمال فيه، وهي –بعد كل هذا- العنصر الذي يحتل مركز الحارس للمجتمع عن الانحراف والتردي، والخروج عن الأهداف والخطوط التي يرسمها ويعمل لأجلها.
والإسلام يؤكد هذه الحقيقة تأكيداً عملياً، فيضع الإيمان بالله سبحانه وتعالى قاعدة أساسية لهذا الكيان الذي يدعو إلى الدخول فيه. إذ الاستسلام في جوانب المجتمع متفرّع عن الإيمان به والاعتقاد بربوبيته، ولذلك دعا المؤمنين خاصة إلى الدخول في السلم، مشيراً أن الإيمان هو الشرط الضروري لهذا الكيان الذي يدعو إقامته والدخول فيه، القاعدة الأساسية له.
والكيان الإسلامي الذي يقوم على قاعدة أساسية له، هي الإيمان بالله والاعتقاد الكامل بألوهيته، ويغمر جوانبه الاستسلام والخضوع له، وتسليم القيادة العملية الحضارية بيده .. إن هذا الكيان هو الكيان الوحيد الذي يمكن أن يؤدي الدور الإنساني المجيد، ويكفل للبشرية المتردية الحياة السعيدة، والرفاه الاجتماعي، والعزة والمنعة والكرامة . وهو وحده الذي يقدر أن ينتشلها من وهدة الرذيلة، ويخلّصها من براثن الشك المرير الذي تعانيه، جراء ما يكتنفها من ظلام الفراغ الروحي والعقيدي، وما يحوطها من قلق نفسي، هذه الأدواء التي جرت بعض المجتمعات المدنية الحديثة إلى التوغّل الفظيع في متاهات اللذة السافلة، والانحرافات الجنسية والسيكولوجية، وانتشرت بسبب ذلك الأمراض العصبية بشكل هائل، حتى كادت أن تكون هي الطابع المميّز لها، وانهارت الأسرة إلى الحضيض .
فلم يكفل لها العلم الذي كانت تعقد عليه الآمال الجسيمة، وترى فيه الرؤية الطبية، شيئاً من ذلك، بعد أن لمست أخطاءه بيدها، ووجدتها جلية واضحة في حضارتها التي تعاني أمراضها وأسقامها. فمهما توسّلت المدنية الحديثة إلى استنباط وسائل الراحة والاستقرار، ومهما تفنن العلم الحديث في اصطناع السعادة. فهو لا يمكنه أن يكفل للإنسانية استقرارها النفسي، أو أن يحل تعقّد حياتها الاجتماعية، أو يخلق لها الركيزة النفسية التي تلجأ إليها.
إذن فالإنسانية بحاجة إلى مثل أعلى تركن إليه، وتهدف إلى تحقيقه، ويكون إلى كل هذا هدفاً صالحاً صحيحاً في متناول يدها. إنها بحاجة إلى هذا المثل الأعلى، بعد أن فشلت في مثلها الأعلى الذي وضعته أمامها حضارة القرن العشرين بل وبعد أن شقيت يهذا المثل الأعلى، وعابت على يده المصائب والآلام، فقد جعلت الحضارة المادية الحديثة، مثلاً أعلى للإنسانية يتمثّل في اللذة الحسيّة، ووفرة الانتاج وكثرة الأرباح. إلا أن هذا المثل لم يحقق لها شيئاً من سعادتها المنشودة وحملها الجبار وأملها المضيء .
وليس أمامنا مثل أعلى يلائم الإنسانية، ويكفل لها السعادة والاستقرار، ويخلصها مما تعانيه من أدواء وأسقام، وينتشلها من براثن الشك والفراغ العقيدي، ويربط كيانها بجميع جوانبه وجهاته ربطاً صحيحاً متيناً … ليس أمامها غير الكيان المستسلم، هذا الكيان الذي دعى الإسلام لإقامته فالاستسلام لله سبحانه وتعالى، يجعل من الإنسان قوة خلاقة، ومادة صلبة، وكائناً فعالاً يتحكم في اللذة والإنتاج ويسير بهما نحو مستقبل أفضل وحياة سعيدة ( أو من كان ميتاً فاحييناه وحعلنا له نوراً يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس يخارج منها، كذلك زيّن للكافرين ما كانوا يعملون ) صدق الله العلي العظيم .
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ﴾
معنى قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 هانس كونج ومشروع الأخلاق العالميّة
هانس كونج ومشروع الأخلاق العالميّة
حيدر حب الله
-
 الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام
الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام
الشيخ علي آل محسن
-
 الدور الخفي لدرب التبانة في الميثولوجيا المصرية القديمة
الدور الخفي لدرب التبانة في الميثولوجيا المصرية القديمة
عدنان الحاجي
-
 جناية هيغل في خديعة العقل
جناية هيغل في خديعة العقل
محمود حيدر
-
 إحاطة الله العلمیّة بالموجودات
إحاطة الله العلمیّة بالموجودات
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 فلسفة النقد عند كانت وبرجسون
فلسفة النقد عند كانت وبرجسون
السيد منير الخباز القطيفي
آخر المواضيع
-

معنى قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ﴾
-

دمع عيني لم يزل في انسكاب
-

هانس كونج ومشروع الأخلاق العالميّة
-

الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام
-

"رسائل متأخّرة" المجموعة القصصيّة الأولى للكاتبة طاهرة آل سيف
-

الإمامُ الصّادقُ: وارثُ خَزائنِ العُلوم
-

الدور الخفي لدرب التبانة في الميثولوجيا المصرية القديمة
-

جناية هيغل في خديعة العقل
-

إحاطة الله العلمیّة بالموجودات
-

فلسفة النقد عند كانت وبرجسون














